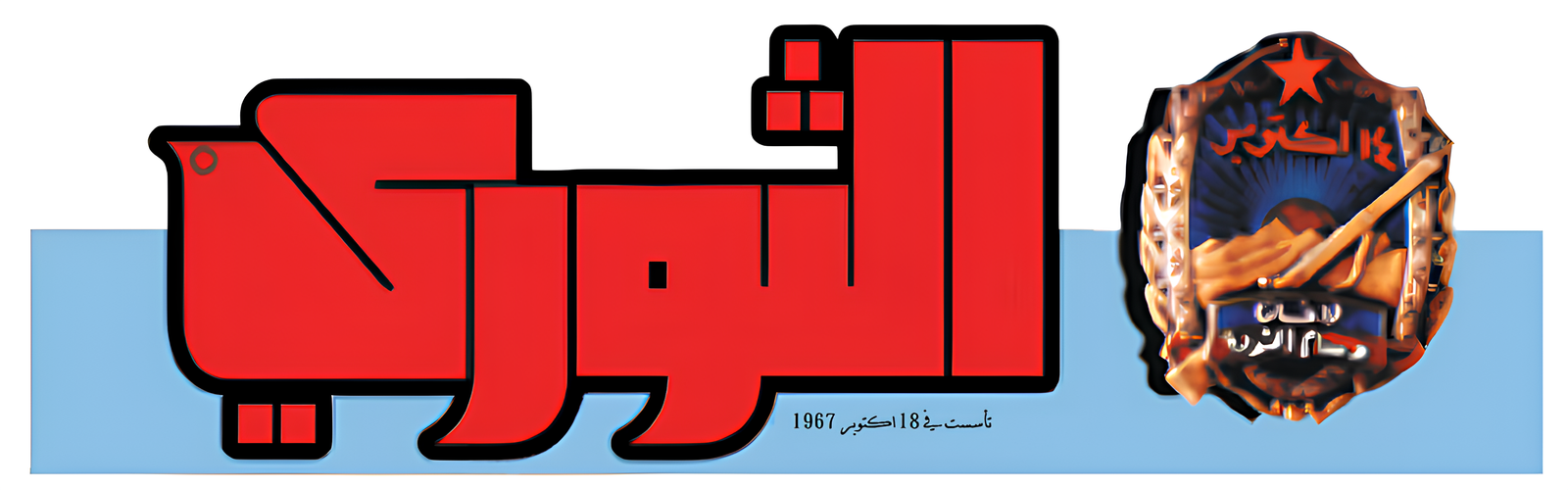صحيفة الثوري- فايننشال تايمز البريطانية:
. لورنس فريدمان
ليس من الصعب تخيّل الأسباب التي قد تؤدي إلى فشل “اتفاق السلام الذي طرحه ترامب”، فالمرحلة الأولى منه تتطلّب إطلاق سراح رهائن حماس وسجناء إسرائيل، وانسحابًا جزئيًا جدًا لقوات الدفاع الإسرائيلية، وزيادة حجم المساعدات الواصلة إلى غزة.
حماس – وكما هو متوقع – لم تتمكن من العثور على جميع رفات الموتى على الرغم من أنّ الرهائن الأحياء أُفرِج عنهم، أما قوافل المساعدات فتضطر إلى شقّ طريقها وسط أنقاضٍ مليئة بالذخائر غير المنفجرة، فيما تواصل حماس سيطرتها على مدينة غزة، وبدأت بتصفية الحسابات والتعامل مع الفصائل المعارضة، كما هو متوقّع في ظل غياب قوة أقوى، وإذا تمكنت الحركة من الاحتفاظ بسلاحها، فسيكون ذلك ذريعة لإسرائيل لإبقاء قواتها في مواقعها استعدادًا لاستئناف القتال.
سيتعين قريبًا اتخاذ خطوات كبيرة لتحريك العملية قُدمًا، وأهمّ ما يجب الإسراع فيه هو نشر قوة الاستقرار الدولية وفرض قدر من النظام والقانون في القطاع، فمن دون ذلك، ومن دون نزع سلاح حماس، سيبقى من الصعب توزيع المساعدات، ولن تتمكن السلطة الانتقالية الجديدة من البدء في أعمال التعافي وإعادة الإعمار.
سيكون للقيادة المركزية الأمريكية في الدوحة دور في إدخال هذه القوة، رغم أنّ أيّ قوات أمريكية لن تشارك فعليًا، وتملك مصر مصلحة كبيرة في تهدئة الوضع في غزة، وقد بدأت إعداد قوة شرطة فلسطينية صغيرة (إسرائيل ستكون قلقة من تشكيل قوة كبيرة)، كما تبدو إندونيسيا مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة في قوة الاستقرار، رغم أن جاكارتا قد تطلب صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، كما تم ذُكر أسم باكستان وأذربيجان أيضًا كمشاركتين محتملتين.
عادةً ما تستغرق عملية الاتفاق على حجم القوات وتنظيم هيكل القيادة واللوجستيات لهذه القوى أسابيع أو حتى أشهر، لكن لا يتوفر هذا الوقت إذا أُريد تجنّب الفوضى في هذه الحالة، فكلما طال الوقت، ازداد يأس سكان غزة وإحباطهم.
وكما هو الحال دائمًا مع ترامب، فإن خطابه المبالغ فيه يقابله غموض في التفاصيل، وهناك أيضًا شكوك كما يحصل في كثير من الأحيان معه، بأنه قد يمل سريعًا وينتقل إلى مشروعه الكبير التالي إذا بدأ المسار بالتعثر بالرغم من النتائج الأولية والدفعة التي نالها في مكانته، وسجلّ الخطط السابقة للسلام الدائم في الشرق الأوسط لا يبشّر بالكثير في هذا الإطار.
بالرغم من كل ما تقدم، يُعد هذا الاتفاق حدثًا مفصليًا، ليس لما قد يفضي إليه فحسب، بل أيضًا للطريقة التي أُبرم بها، فالمسار الذي أدّى إليه يكشف الكثير عن الكيفية التي غيّرت بها أحداث العامين الماضيين ملامح المنطقة، وعن كيف يمكن لأولويات ترامب أن تغيّرها أكثر، وقبل كل شيء عن الطريقة التي استطاعت بها إسرائيل أن تجمع بين الهزيمة العسكرية الفاعلة لأعدائها الأخطر وبين تراجعٍ في قوتها ونفوذها.
كان بوسع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يُعلن النصر قبل أشهر، عبر طرح خطة “اليوم التالي” في غزة التي تناسبه، لكنه لم يفعل ذلك لأن حكومته لم تتمكن من الاتفاق على كيفية إنهاء الحرب، وكان من الأسهل سياسيًا الإبقاء عليها مستمرة.
لقد كان قادرًا على توحيد الصف خلف المبادرات العسكرية الجريئة، لكن التحركات الدبلوماسية التي تنطوي على تنازلات للرأي العام الدولي وللطموحات الفلسطينية كانت تنذر بالانقسام، لذلك اتخذ ترامب القرار بدلًا عنه، ما جعل الأمر ينتهي باتفاقٍ نَسَبَ الرئيس الاميركي الفضل فيه لنفسه، وستكون لإسرائيل سيطرة محدودة عليه إن تجاوز المراحل الأولى المتعثّرة.
تمثّلت خطيئة نتنياهو في ثقته المفرطة بأنه يستطيع تجاهل اعتراضات من انتقدوا شدّة الحملة الإسرائيلية، لأنه كان واثقًا من الدعم الأمريكي، وقد جعله ذلك يعتمد اعتمادًا كبيرًا على حسن نية ترامب المعروف بتقلّباته، فقد بالغ نتنياهو في الاعتماد على الرئيس في نهاية المطاف، وجاءت اللحظة الحاسمة في التاسع من سبتمبر، حين أجاز نتنياهو تنفيذ ضربة استهدفت ما تبقّى من القيادة السياسية لحماس التي كانت تجتمع في الدوحة من دون ان تنجح في تحقيق أهدافها.
كان المجتمعون يناقشون خطة وقف إطلاق النار الأمريكية التي شاركت إسرائيل في إعدادها، فغضبت قطر من انتهاك سيادتها وهددت بالتخلي عن دورها كوسيط، واضطر ترامب إلى الاختيار بين إسرائيل وقطر، فاختار قطر.
ولفهم كيف حدث ذلك، ينبغي العودة إلى الظروف المختلفة جذريًا في عهد إدارة ترامب الأول، ففي عام 2017، كانت القضية الفلسطينية قد فقدت كثيرًا من زخمها، لأن القيادة الفلسطينية بقيت منقسمة بين حماس في غزة وفتح في الضفة الغربية المحتلة، وهو انقسام شجّعته إسرائيل، أما بالنسبة لمعظم الحكومات العربية، فكانت القضية الاستراتيجية الأهم هي التحدي الذي تمثّله إيران ووكلاؤها المتطرفون، ولا سيما حزب الله في لبنان.
كان الصراع الأكبر، والأشد دموية ومعاناة، هو الحرب الأهلية السورية، وقد حاولت إيران وحزب الله إبقاء نظام بشار الأسد صامدًا في سوريا، إلى أن تدخل سلاح الجو الروسي وقلب موازين الحرب ضد المتمرّدين، فنجا الأسد.
أما سلف ترامب، باراك أوباما، فقد أراد فك الارتباط بالشرق الأوسط والتركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ورفض التدخل في الحرب الأهلية السورية، رغم أنه اضطر إلى إعادة إرسال قوات إلى العراق عندما اندفع تنظيم الدولة (داعش) – وريث تنظيم القاعدة – من سوريا باتجاه بغداد، وقد إبرام أوباما اتفاقًا مع طهران عام 2015 لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية.
وقد واجه أوباما في هذا المسعى معارضةً ليس من إسرائيل فحسب، بل من السعودية ودول الخليج العربي الأخرى أيضًا، التي لم تقتنع بأن النظام الإيراني سيلتزم بالاتفاق – الذي كان محدود المدة – وخشيت أن تُمكِّن الأموال التي افرجت الولايات المتحدة عنها للحكومة الإيرانية مقابل ضبطها لتخصيب اليورانيوم، من تمويل العنف والتخريب الذي كانت تقوم به في الإقليم.
نظر أوباما إلى النظام السعودي السلطوي بنفور واضح، أمّا ترامب، فكان على العكس من ذلك، حيث جذبته ثروته ونفوذه ولم يُعر اهتمامًا لسجل الرياض في حقوق الإنسان، فجعل من العاصمة السعودية أول وجهة خارجية له بعد توليه الحكم عام 2017، ثم تبع ذلك بانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، مدعيًا أنه يستطيع عبر موجات من العقوبات التوصل إلى اتفاق أفضل، لكن النتيجة كانت أن إيران رفعت مستويات تخصيب اليورانيوم، فيما دفعت شدة العقوبات الاقتصادية الإضافية طهران إلى رعاية هجمات على ناقلات نفط ومنشآت نفطية، بما في ذلك داخل السعودية.
أجاز ترامب اغتيال قاسم سليماني في يناير 2020، وبعد أن قتلت ميليشيات عراقية متعاقدًا أمريكيًا.
كان سليماني ينسّق أنشطة وكلاء إيران المتطرفين، وشجع التهديد المشترك الذي تمثّله إيران بعض الدول العربية والإسلامية، على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، رغم أن تلك الاتفاقيات كانت في جوهرها معاملات مصلحية.
شكّلت تلك الاتفاقيات أبرز إنجاز دبلوماسي في فترة ترامب الأولى، وقد عُرفت باسم “اتفاقيات أبراهام”، وتولّى التفاوض بشأنها إلى حد كبير جاريد كوشنر صهر الرئيس الاميركي.
حاول الرئيس جو بايدن منذ عام 2021، توسيع هذه الاتفاقيات لتشمل السعودية، بينما سعى في الوقت نفسه إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، لكن التقدّم الذي حققه في هذين الإطارين كان محدودًا، وما أعاقه كان الانطباع بالضعف الذي خلّفه الانسحاب المفاجئ من أفغانستان في صيف 2021، ثم الانشغال بالحرب الروسية الأوكرانية.
كان الاتفاق السعودي–الإسرائيلي على وشك التبلور، تدعمه وعود أمريكية بصفقات سلاح، لكن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 أحبطه، ومنذ ذلك الحين، هيمنت المعارك والأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة على المشهد بأسره.
عبّر بايدن مرارًا عن ضيقه من نتنياهو، لكنه بدا عاجزًا عن كبح قسوة الحملة الإسرائيلية، وكان شركاء نتنياهو في ائتلافه اليميني يعطون الأولوية لهزيمة حماس على إعادة الرهائن.
اصبح الإصرار على “استئصال” حماس وصفةً لحربٍ لا تنتهي، لان حماس يمكن إضعافها لكن لا يمكن القضاء عليها تمامًا، فكل ما كان على حماس فعله هو البقاء رمزًا للمقاومة، على أمل أن يدفع الغضب الدولي من سلوك إسرائيل إلى فرض وقفٍ لإطلاق النار.
رأى النظام الديني في إيران نفسه قائدًا لقوى مناهضة للصهيونية، لكنه عجز عن فعل الكثير لمساعدة حماس، وقد شجّع حزب الله المدعوم من إيران على الانخراط في الصراع، غير أن الحزب القائم في لبنان سعى لتجنّب حرب شاملة.
لم يكن أمام حزب الله من خيار سوى قبول وقف إطلاق النار بعد أن تعرّض الحزب لضربات متتالية على مدى أسابيع، بعد ان فوجئ بتصعيد إسرائيل عملياتها بشكل دراماتيكي في سبتمبر 2024، عبر حملة تصفية قاسية بدأت بتفجير أجهزة النداء اللاسلكي، ثم مضت إسرائيل واغتالت زعيم حزب الله، حسن نصر الله.
تابعت إيران المشهد بذهول، ففي أبريل 2024، وبعد أن قتلت إسرائيل اثنين من جنرالاتها في القنصلية الإيرانية بدمشق، شنّت طهران ضربات غير فعّالة ضد إسرائيل، وفي الأول من أكتوبر، بعد مقتل نصر الله بأيام، وبينما كانت القيادة الإيرانية متألمة من اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية أثناء إقامته في طهران في يوليو السابق، أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل، مسببةً هذه المرة أضرارًا أكبر، وردّت إسرائيل بضربات محدودة استهدفت مواقع إنتاج الصواريخ والدفاعات الجوية، ما جعل إيران أكثر هشاشة في المستقبل، ثم زادت مصيبة إيران حين تقدّم المتمردون المدعومون من تركيا على قوات الأسد، فانهار نظامه في غضون أيام في ديسمبر، ولم تستطع إيران، ولا حتى روسيا، فعل الكثير حيال ذلك.
فجأة بدا ما سُمّي بـ “محور المقاومة” واهيًا، ولم يُبدِ الصمود سوى الحوثيون في اليمن. لقد كان ذلك تحوّلًا لافتًا في ميزان القوى الإقليمي — وبصورة كبيرة لصالح إسرائيل.
وبينما كان ترامب يستعدّ لتنصيبه، تمّ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بدعم من مبعوثه ستيف ويتكوف، وهكذا بدأ الرئيس ولايته الثانية فيما بدا أن الوضع يتجه نحو الهدوء، ومرة أخرى، اختار ترامب في رحلته الأولى إلى المنطقة أن يبدأ من منطقة راحته: ممالك الخليج، حيث لعائلته مصالح تجارية متواصلة، وحيث يُستقبل دائمًا بحفاوة.
زار ترمب قطر هذه المرة، وهي البلد التي لم يزرها في عام 2017، واحتفل باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، بل تلقى طائرة كهدية.
كانت دول الخليج الغنية بالنفط في صعود مع تراجع إيران، وقد رسّخت قطر لنفسها دورًا مميزًا كوسيط، وأظهرت براغماتية لافتة باستضافتها كلًا من حركة حماس وقاعدة عسكرية أمريكية.
كانت قطر في خلاف مع الإمارات والسعودية خلال معظم فترة ترامب الأولى، وقد انضمت الإمارات والبحرين إلى اتفاقيات أبراهام، بينما لم تنضم قطر ولا السعودية، وظلّت تلك الاتفاقيات قائمة خلال حرب غزة؛ فلم تقطع أي دولة عربية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، رغم تزايد التوتر في الأشهر الأخيرة.
أدرك نتنياهو في مارس الماضي، ان ائتلافه الحاكم لن يصمد، إذا استمرّ وقف إطلاق النار حتى انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية، مع بقاء حماس في غزة، فوجد ذريعة للتخلي عن العملية.
كانت الأوضاع في غزة سيئة أصلًا، لكنها مع الحصار الكامل أصبحت لا تُطاق، أما خطة توزيع المساعدات التي دعمتها إسرائيل والولايات المتحدة، والمصمّمة لسحب هذه المهمة من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة التي اتُّهمت بالتعاطف مع حماس، فقد كانت معيبة إلى درجة أنها، مع الحصار، تسببت في مجاعة داخل القطاع.
لم تجد حماس سببًا لتقديم تنازلات كبرى مقابل وقفٍ جديد لإطلاق النار، مع تحمّل إسرائيل كامل اللوم على ما يجري في غزة، ولم تُحرز محاولات ويتكوف لإحياء العملية أي تقدم، كما بدا أن ترامب فقد اهتمامه.
ومع ذلك، لم تتوقف غريزة ترامب في عقد الصفقات، فقد شجّع ويتكوف على محاولة التوصل إلى اتفاق مع إيران.
كان النظام الإيراني ضعيفًا واقتصاده في حالة يأس بعد أحداث العام السابق، وقد أبدت طهران استعدادًا للتفاوض ما لم يُطلب منها التخلي الكامل عن قدراتها في التخصيب، ورغم أن ويتكوف وجد العرض مغريًا، إلا أن ضغوطًا إسرائيلية ومن الكونغرس أدّت إلى صياغة اقتراح يفرض فعليًا على إيران التخلي عن التخصيب، وفي السابع عشر من يونيو، وقبل أن تتمكن طهران من رفض المقترح، قررت إسرائيل إنهاء أي احتمال للاتفاق عبر ضربات استهدفت القيادة العسكرية الإيرانية والدفاعات الجوية والمنشآت النووية.
ولسعادة نتنياهو، قرر ترامب المشاركة مستخدمًا القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات لضرب منشآت التخصيب المحمية، لكنه أوقف العملية فجأة، مؤكدًا أن المهمة أُنجزت، وهو ما لم يُرضِ نتنياهو الذي كان يفضّل مواصلة العمليات، وهكذا تكرّر النمط ذاته: كان ترامب يدعم إسرائيل، لكن فقط إلى حدٍّ معين ووفق شروطه الخاصة، إذ لم يكن يريد “حروبًا لا نهاية لها” من صنعه.
وفي الوقت ذاته، بدأت عزلة إسرائيل تتفاقم بسبب سلوكها في الحرب، الذي زادته تصريحات اليمين المتطرف عن طرد الفلسطينيين من غزة وضمّ الضفة الغربية، وتصاعدت المعارضة للسياسات الإسرائيلية، فقررت حكومات أوروبية، منها فرنسا وبريطانيا، الاعتراف بدولة فلسطين.
كانت الخطوة رمزية إلى حد كبير، لكن إدارة ترامب كانت تعارضها بشدة، وهو ما أراح نتنياهو، وإن كشف في الوقت نفسه عن مدى عزلة بلاده.
بدأ الدعم التقليدي لإسرائيل حتى داخل الولايات المتحدة، يتراجع خاصة بين الشباب، وكانت إسرائيل تشعر بأنها قادرة على التصرف دون محاسبة، فقط لأن ترامب كان دائم الانحياز إليها، ولهذا تبيّن أن الضربة الإسرائيلية على الدوحة كانت خطأً فادحًا.
فقد كانت الآمال أن يُقضى على ما تبقّى من القيادة السياسية لحماس بضربة واحدة، وهو ما كان يعني أيضًا إجهاض اتفاق وقف إطلاق النار الذي عمل عليه ويتكوف وكوشنر، لكن فشل العملية أدى إلى نجاة القادة، وإلى إحياء عملية السلام.
أغضبت الضربة قطر بشدة، وغضب ترامب تبعًا لذلك، فمعاناة الفلسطينيين شيء، وإحراج أصدقائه شيء آخر.
لقد سعى ترامب بكل جهد ليُظهر أنه لم يكن طرفًا في الخطة الإسرائيلية، وتعهد بألا يسمح بتكرارها، وأصبح يريد الآن ليس وقف إطلاق النار فقط، بل خطة “اليوم التالي” أكثر طموحًا لحلّ هذه القضية نهائيًا، وقد أدرك ضرورة إشراك الدول العربية في العملية، وهو ما عنى حتمًا منح اهتمام أكبر للقضية الفلسطينية.
كان لا بد من تقديم وعود بألا يُجبر الفلسطينيون على النزوح، وألا يُعاد احتلال غزة، وألا تُضمّ الضفة الغربية، مع الإبقاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية.
تمكّن نتنياهو قبل نشر الخطة، من تعديل بعض العبارات المتعلقة بنزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل (وهو ما قد يسمح له بالإبقاء على قواته في مواقعها)، لكنه لم يتمكن من تغيير جوهر الخطة، وكل ما ناله بخصوص الدولة الفلسطينية هو إقرار ترامب بوجود خلاف بينهما حولها.
لم يكتف ترامب بإلزام نتنياهو بتوقيع الخطة، بل أجبره أيضًا على الاتصال برئيس الوزراء القطري لتقديم اعتذار محرج، وبما أنه بدا واضحًا أنه خضع للضغوط، لم يتمكن نتنياهو من تصوير إطلاق سراح الرهائن كإنجاز شخصي له. لقد كان ترامب من حصد التصفيق، بينما نال نتنياهو الاستهجان.
ونحن نعلم مدى هشاشة هذا المسار واحتمال انهياره، لكن يمكننا أن نسمح لأنفسنا بلحظة تفاؤل نادرة، بالنظر إلى إمكانية تطورٍ أكثر إيجابية، فالخطوات الأولى هي الأصعب، وقد تعهّدت الحكومات العربية وتركيا بضمان امتثال حماس ما دام ترامب يبقي إسرائيل تحت السيطرة، وربما يكتشف الرئيس أن التحدي الأكبر هنا لا يكمن في ما تريد إسرائيل فعله في غزة، بل في الضغوط المستمرة التي تمارسها في الضفة الغربية.
إذا جرى إدخال قوة الاستقرار بنجاح، وإذا جرى تفكيك القدرات العسكرية البارزة لحركة حماس، وإذا تمكنت السلطة الانتقالية من جعل الحياة في غزة أقل بؤسًا، وإذا أُنفقت الموارد على رفاه السكان بدلًا من الأنفاق والصواريخ، وإذا نفذت السلطة الفلسطينية الإصلاحات التي وُعِدت بها — وهذه جميعها اشتراطات هائلة — فمع مرور الوقت ستبدأ ملامح دولة فلسطينية جنينية في الظهور، عندها سيكون بوسع إسرائيل أن تفعل القليل حيال ذلك.
قد تقبل اسرائيل – مع وجود ائتلاف أقل تطرفًا في الحكم – بمنطق احترام تطلعات الفلسطينيين في الضفة الغربية (وهو أيضًا احتمال مشروط) مقابل وعد بتوسيع اتفاقات أبراهام لتشمل السعودية.
أما إيران فستراقب من الهامش، منشغلة أكثر بمشكلاتها الداخلية ومنها تراجع نفوذها الإقليمي.
هناك الكثير من العقبات في الطريق، لكن هذه مسائل تقع الآن على عاتق صانعي القوى الإقليميين الجدد، وهي دول الخليج التي تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وسنرى قريبًا إن كانوا على قدر هذه المهمة.
+ لورنس فريدمان هو أستاذ فخري في دراسات الحرب بكلية كينغز في لندن.. أحدث كتبه هو “القيادة: سياسات العمليات العسكرية من كوريا إلى أوكرانيا” (منشورات جامعة أكسفورد). وهو يشارك أيضًا في تأليف النشرة الإخبارية على Substack بعنوان Comment is Freed.