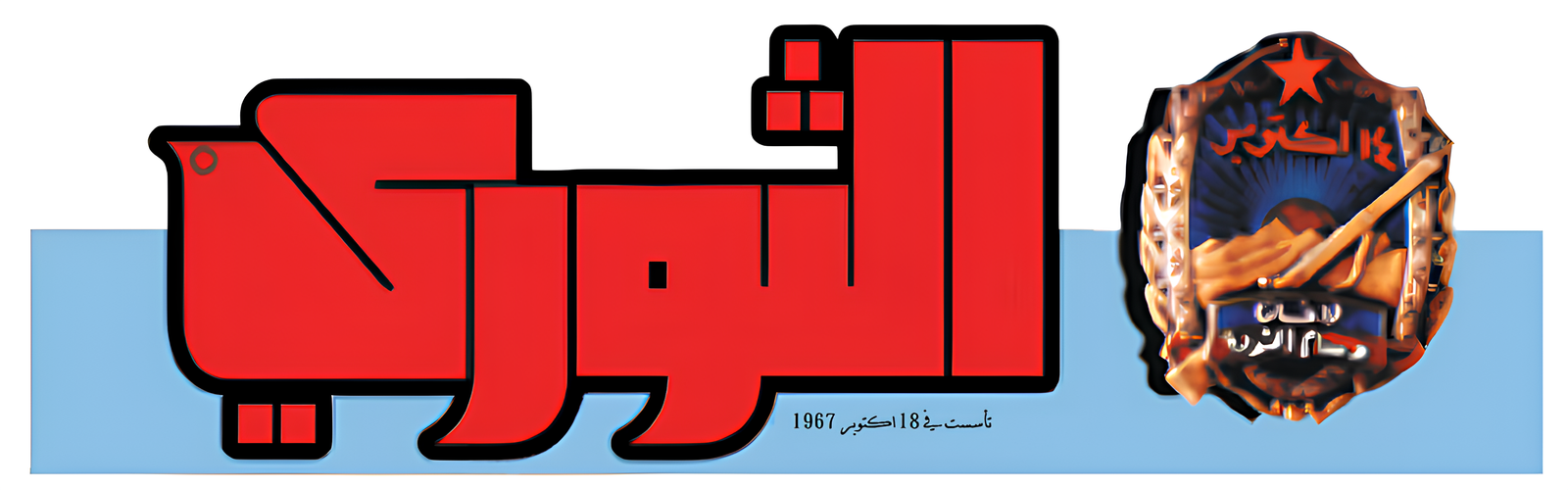“صحيفة الثوري” – كتابات:
قادري أحمد حيدر
الإهداء:
إلى رؤساء دولة الاستقلال: الفدائيين في قلب الكفاح السياسي والوطني للتحرير، بالسلاح، وبالكلمة.. رموز الفداء والتضحية، والدولة الوطنية.
الرؤساء: قحطان محمد الشعبي، سالم ربيع علي، عبدالفتاح إسماعيل، علي ناصر محمد، علي سالم البيض.
دخلوا إلى الرئاسة عبر الكفاح السياسي، والنضال المسلح، وخرجوا منها فقراء كما دخلوها، إلا من طهارة الروح ونظافة اليد.
إليهم جميعاً مع خالص المحبة والتقدير.
ثانياً: النقد المزدوج والنقد الأحادي:
تعبير ومفهوم النقد المزدوج، هو عنوان كتاب، للمفكر المغربي، عبدالكبير الخطيبي، هذا للتوضيح.
يقال إن النقد سواء كان على الصعيد الأدبي: شعر، قصة، رواية، أو مسرح… إلخ، أو النقد على مستوى الفكر (النثر)، النقد المعرفي والفكري أو النقد الفلسفي، هو كتابة إبداعية ثانية للنص.. كتابة منتجة لنص إضافي.
النقد هو من يساهم في إنتاج معرفة وفكرة مضافة، بل وثقافة بديلة متطورة ومتقدمة في التاريخ، ومن هنا هيبة وجلال ومكانة النقد في عقل من يحترم المعرفة والفكرة والكلمة.
لقد أصبحت اليوم ممارسة العملية النقدية في الكتابة في المجال النظري والسياسي أو التطبيقي (نقد التجارب) مطية سهلة للكثيرين، وكأن السياسة والممارسة السياسية والفكر السياسي، والتجارب السياسية حقل مفتوح دون ضوابط، وكأنها الجدار القصير الذي يمتطيه كل من عنَّ له ذلك، وكل من أراد إلى ذلك سبيلاً.
وصار الأمر أكثر سهولة ويسراً مع الفتوحات المعرفية التواصلية والاتصالية التي جرَّأت البعض – مع الأسف – على قول كل ما تجيش به نفوسهم الأمارة بالسوء، قبل عقولهم، حيث نشهد في مثل هذه الفضاءات المفتوحة تراجع المعرفة والفكرة والكلمة والمعنى، والبحث العلمي، لصالح “ثقافة المعلومة”، والخبر كيفما اتفق، حيث كمّ المعلومات الملاييني الذي يتدفق وتطفح به الوسائل التواصلية والاتصالية المتراكمة فوق بعضها بعضاً، حيث تطغى “المعلومة” على حضور “المعرفة” والفكرة دون خلفية وأساس معرفي وفكري يضبط إيقاعها – المعلومة – ويحدد سياق حركتها ومعناها ضمن رؤية وبنية معرفية/فكرية/ثقافية شاملة.
ففي كل دقيقة يتم إنتاج المئات والآلاف من المعلومات إن لم أقل الملايين، التي تتراكم فوق بعضها البعض فتثقل ذاكرة جامع المعلومات بحشد هائل من الأخبار، ومن تفاصيل تفاصيل الأخبار، ومن المعلومات المتزاحمة والمتضاربة والمتناقضة “كمن يحمل أسفاراً”، ومن هنا خطورة وحساسية الاقتراب من الكتابة السياسية في ظل شيوع وممارسة مثل هذه الثقافة المعلوماتية التي لا علاقة لها بالإنتاج المعرفي والفكري، إن لم أقل إنها معادية للمعرفة في الأصل، أو بتعبير أخف على علاقة غير ودية بالمعرفة والفلسفة.
ومن هنا خطورة وحساسية الكتابة السياسية المفتوحة بدون ضوابط، وبدون امتلاك ناصية قيم الكتابة، في هكذا أوضاع، “فوضى الكتابة” وهي التي تطفح بها ونطالعها على وسائل التواصل الاجتماعي، في صورة ما يمكنني تسميته بالنقد الأحادي الجانب، النقد القاتل ، أو النقد المفترس ، الذي يتحرك في اتجاه واحد، مثل “العرج”، الذي يجري باتجاه واحد، لا يدري ما يدور في شماله ويمينه وخلفه، وكأنه يهرب للأمام .. في اتجاه واحد وأحادي حتى نفسه لا يراها بشكل صحيح، لأنه مستغرق حتى الثمالة في ذلك النقد الأحادي للآخر، لا يرى فقط سوى أيديولوجيته السياسية الذاتية المسبقة “السلفية” العالقة في ذهنه، مثل الذبابة، محاولاً ليَّ عنق المعرفة والفكرة والواقع والحقيقة، والتاريخ لصالح تلك “الدوجما” الاعتقادية الزائفة التي تصل في تصوره حد العقيدة الدينية الإطلاقية في إسقاطها على الواقع وعلى الفكر، وعلى التجارب السياسية كيفما اتفق.
وهو ما رأيته وطالعته في المقالة التي كتبها الأستاذ أحمد جحاف في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي غيرها من الكتابات في ذات الاتجاه.
كم نحن بحاجة اليوم – تحديداً – إلى ممارسة “النقد المزدوج”.. النقد الذي يبتغي ويستهدف إنتاج معنى.. إنتاج معرفة وفكرة.. النقد الذي يتحرك في جميع الاتجاهات: نقد الذات، ونقد الواقع، ونقد الآخر، ونقد التاريخ.
كنا في أحزابنا القومية، وحتى بعد تحولنا إلى الاشتراكية، والماركسية، التي لا تعجب الأستاذ أحمد جحاف، وهذا حقه المطلق، علماً أن الاشتراكية والماركسية التي أعتقدها وأؤمن بها كرؤية وأيديولوجيا لفهم الواقع وتفسيره وتحليله باتجاه تغييره، ليست قضية إيمانية عقيدية، وليست ديناً مقدساً، هي فكرة ورؤية ومنهج في القراءة والتحليل، وقد سقط اليوم الهجوم الأيديولوجي والإعلامي الغربي الاستعماري، والرجعي، والسياسي الديني، الذي كان يستهدف الاشتراكية والماركسية، ويكفّرها باعتبارها ديناً وإلحاداً تقول بأن “الدين أفيون الشعوب”، وهو افتراء سياسي رخيص، أو كما كان البعض يفهم ويقرأ “العلمانية”، بأنها كراهية للدين وتنشر الإلحاد والكفر، وهي اليوم عقيدة سياسية في السعودية بلد الرجعية الأول في المنطقة العربية، رغم تراجعهم عن “الوهابية السياسية”.
إن أعظم المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، وأجملهم وأنبلهم، هم في الكثير من الأحيان قادمون من رحابة الفكرة الاشتراكية في التاريخ الإنساني العالمي، والإسلام المحمدي العظيم في روحه وعمقه جاء من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية الإنسانية والمساواة، ليس بين المسلمين فحسب بل وللبشرية كافة، وهو ما تقول به الاشتراكية العلمية، ونماذج الاشتراكيين في تاريخ الأديان التوحيدية – وفي غيرها من الأديان غير التوحيدية – وخاصة في تاريخنا الإسلامي، هم من أضافوا معنى وروحاً عميقة للإسلام منتشرة اليوم في كل العالم، بعيداً عن الفهم الأيديولوجي المذهبي الطائفي للإسلام، سواء كان سنياً أو سلفياً أو شيعياً، وهي التفسيرات الحاملة لمفاهيم ومعانٍ شوّهت صورة الإسلام في آفاقه الإنسانية الرحبة.
وأنا مع إسلام محمدي قرآني بدون مذاهب، مع أن المذاهب ليست بالضرورة نقمة إذا أُخذت برحابتها وفي حقها جميعاً في الوجود، فهي دليل على التعدد والتنوع، والأهم الحق في الاختلاف، وهو ما نفتقده في حياتنا السياسية العربية العامة.
مرة ثانية أقول: كنا في أحزابنا القومية واليسارية الاشتراكية، نضع أو نطرح في جدول أعمالنا الحزبية بنداً أو باباً نضعه في مؤخرة جدول الأعمال نطلق عليه بند “النقد والنقد الذاتي”، على أنها بقيت طيلة تلك العقود الستة عبارة عن بند يتحرك ببطء وفي اتجاه واحد، أو كما يقول النحويون، عبارة عن بند “ممنوع من الصرف”، في واقع الممارسة على منوال ما كنا نقول بــ”المركزية الديمقراطية” ونحن طيلة تلك العقود إنما كنا نمارس “المركزية”، في عمقها الأحادي/الشمولي، في الفكر وفي السياسة وفي إدارة الحزب والدولة، بعد أن صادرت المركزية الممارسة الديمقراطية، حيث المركزية في الممارسة السياسية هي الوجه الآخر للاستبداد بالرأي.
باسم مبدأ “النقد والنقد الذاتي” مارسنا فقط “نقد الآخر”، ذمّه وتجريحه، ولم نقترب من نقد الذات المقدسة في أعماقنا الذاتية والأيديولوجية، وانحصر كل نقدنا للذات في حدود بسيطة شكلية هامشية لا علاقة لها بروح فكرة ومعنى النقد، مثل الاعتذار عن التأخر عن الاجتماع الحزبي، وعن عدم قراءة الكتاب الفكري، وعن تفاصيل ذاتية يومية لا صلة لها بمعنى النقد في عمقه الاستراتيجي كمعرفة ورؤية وفكرة وثقافة.
لأننا لم نكن حينها مؤهلين – تاريخياً – معرفياً وفكرياً وثقافياً، والأهم سيكولوجياً لذلك، لأننا في الأصل لم نكن أحراراً وديمقراطيين، إلا بمقدار ما تسمح به السياسة السائدة؛ وهذا ينطبق على الجميع بدون استثناء، وتلك واحدة من مشكلاتنا في المنطقة العربية، في علاقتنا بذواتنا، وفي علاقتنا بالأحزاب، بل وفي علاقتنا بالمجتمع، الذي في أعماقه هو مجتمع أبوي “بطريركي”، من هنا جنايتنا على الفكر وعلى الواقع، وبالنتيجة دخولنا في دورات متتالية من العنف والصراعات والحروب التي لم نستوعبها نقدياً إلى حد بعيد، إلا بعد تكلفة إنسانية باهظة، وخسارة في الاقتصاد، وفي بناء الدول، وفي هذا السياق يحضرني مثل سوري/شامي يقول: “الواحد يتعلم من جيبه”.
والأهم هنا هي الخسارة المعنوية والنفسية والروحية، التي لا تعوَّض في فقداننا الكثير من الرفاق والأصدقاء في دورات العنف تلك، الأصدقاء والرفاق الذين نتحسر اليوم على فقدانهم ونتذكرهم بأسى ومرارة تتعب الروح.
ومع ذلك يمكنني القول إن الحزب الاشتراكي هو الحزب الوحيد حتى اليوم الذي قدّم قراءة نقدية لذاته، ولو متواضعة.
والمطلوب – كما سبقت الإشارة – مواصلة تعميق تلك القراءة النقدية للذات، لنخرج من نفق ما كان وما كنا فيه، وما نزال جميعاً بدرجات متفاوتة نتحرك في داخله، كأزمة ومشكلة، وليس ما يجري اليوم في البلاد سوى عنوان بارز لما نذهب إليه من مستقبل لا نتدخل جدياً وبالفعل في صناعته، لأسباب عديدة، في معظمها أسباب ذاتية، خاصة بنا كمكونات حزبية/ سياسية.
وهناك اليوم من يكرر تجريب المجرَّب باسم النقد – جحاف وغيره – ولم يستفد من تجارب من سبقوه، ويقف على أطلال خرائبهم التي كان منتشياً وناقداً، متصوراً أنه يقدم فتحاً عظيماً، وهو لا يفعل – مع الأسف – سوى تكرار ما كان، من موقع متخلف، يعتبره ويراه نقداً، وهو ليس أكثر من دوران عقيم في إعادة إنتاج ما كان بصورة أسوأ وأعنف، لأن الزمن المعاصر لا يحتمل هكذا قراءات.
انحراف النقد عن مساره ومجاله يعني دخولنا في دائرة الظلم، وليس هناك أقسى وأبشع من الظلم في الجناية على الفكر وعلى الواقع، وعلى الآخر المختلف معنا. وهنا يحضرني تعبير جميل للأستاذ الصديق زيد بن علي الوزير، يقول فيه:
“فالظلم – وقد عانيت منه الكثير – علّمني ألا أظلم أحداً، ولو كان خصماً، ولذلك آليت على نفسي أن أكون صادقاً مع الله، ومع التاريخ، ومع نفسي”. (١)
فما أحوجنا للصدق في الكتابة.
فالكتابة الظالمة تحمل في داخلها أسوأ أنواع الكلام، بل ما هو أكثر وحشية من القتل.
كنت لا أتمنى أن أجد نفسي مع ما كتبه الأستاذ جحاف في مقالته المذكورة حول ثورة 14 أكتوبر 1963م، وهي المقالة الممتلئة بالظلم، وبكمٍّ متناقض من الأقوال والمعلومات الصحيحة والخاطئة بعد فصلها عن سياقها الموضوعي والتاريخي، فبدت ما يكتبه وكأنها معلومات معلقة في فراغ القول المجرّد، فقط ذم وقدح وصل حد تسفيه رؤى معرفية ونظرية وأفكار إنسانية.
كنت أود لو أن نقده توقف عند نقد التجارب، بل هو شمل بنقده الظالم المعرفة والفكرة الاشتراكية الإنسانية بكلام لا علاقة له بالمعرفة ولا بالفكر ولا بالنقد.
قبل ربع قرن كتبت في صحيفة الثوري مقالة من حلقتين فحواها: سقطت التجربة الاشتراكية إلى غير رجعة، والمطلوب البحث وتقويم نقدي لأسباب ذلك السقوط، لأن الفكرة الاشتراكية كحلم وكفكرة ورؤية إنسانية وكمنهج في التفكير خالدة، هي في حالة صيرورة معرفية تاريخية إنسانية، وهي بهذا المعنى لا تسقط ولا تنتهي.
التجربة العملية هي التمثّل السياسي الاجتماعي والاقتصادي الخاطئ للفكرة في الممارسة وليس معنى الفكرة، أي أن ما سقط ويسقط هو التجربة، أما الفكرة – الحلم بالاشتراكية كحرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية ومساواة وتنمية إنسانية – فهي حاضرة في جميع النظريات والأفكار والتيارات بدرجات متفاوتة، بما فيها الفكرة الرأسمالية التي “جددت نفسها” بالاعتماد على بعض الإضافات المعرفية والسياسية والاقتصادية للفكرة وللتجربة الاشتراكية. وهو ما لم تميّزه الكتابة الأيديولوجية/السياسية المعلوماتية العمياء للأستاذ أحمد جحاف، فوقع في خطأ تغليب المعلومة على المعرفة المنتجة، وهي مشكلة نجدها ونطالعها في العديد من الكتابات السياسية السيارة والعجولة.
والمطلوب منا جميعاً الانتقال من الاختلاف البدائي والمتوحش إلى الحق في الاختلاف على قاعدة التنوع والتعدد، والقبول بالآخر، أي التعددية الفكرية والسياسية والحزبية السلمية، تجاوزاً للأحادية اللاهوتية الثيوقراطية، وللتعددية في صورها الاستبدادية الشمولية التي سادت المنطقة العربية كلها وما تزال حتى اللحظة.
هناك عبارة تُنسب إلى ديستوفيسكي، يقال إنها وردت في روايته الليالي البيضاء، تقول:
“ما مضى قد مضى، وما قيل قد قيل ولا يُستعاد”. (٢)
وهو ما يعني أن من المهم استثمار أفضل ما في الماضي والراهن معاً من أجل المستقبل، وأن لا نلتفت طويلاً وكثيراً لما كان (الماضي) إلا من أجل أن يقودنا إلى الآتي والأجمل.
باختصار، الكتابة فعل وجودي، عقلي نقدي إبداعي، المهم فيها تخليق علاقة إنسانية بالآخر المغاير، وليس نسف بنية ذاته ومحو اسمه وتاريخه، بل محاججته بفكرة مغايرة مقابلة وموازية.. بكتابة تاريخية تقول ما يؤكد معنى وجودها ولا يلغي حق الآخر في الوجود، وهو مع الأسف ما لم أجده في كتابة/مقالة الأستاذ أحمد جحاف، وفي غيرها من الكتابات المشابهة.
وإلى الحلقة الثالثة.
الهوامش:
1- زيد بن علي الوزير: (رحلة الألف والمئة والستين عاماً، السفر الأول، مع أمير المؤمنين، الهادي يحيى بن الحسين، وعصره، ونظامه الجديد)، دار البرهان للطباعة والدعاية والإعلان، مركز التراث والبحوث اليمني، صنعاء، ط(1)، 2023م، ص15.
2- د. حسن مدن: صحيفة الخليج الإماراتية، 17 أكتوبر 2025م.