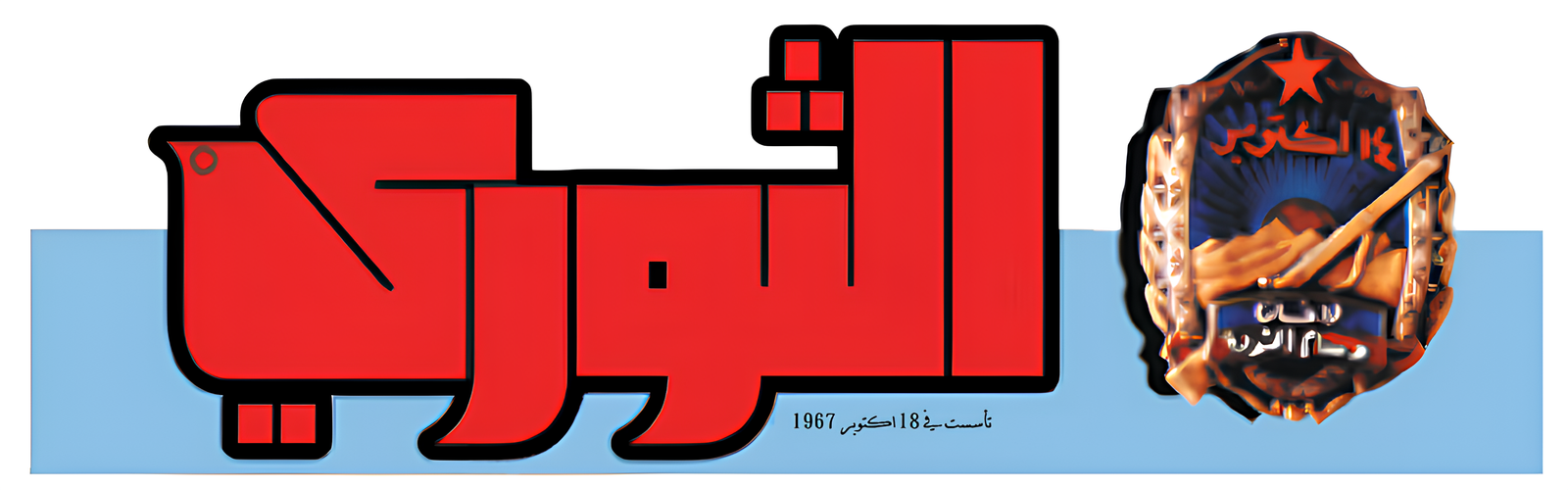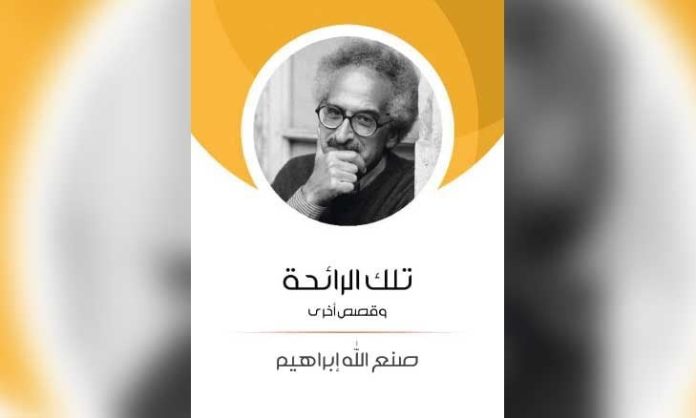محمد عبدالرحيم - القدس العربي
صدرت أولى روايات الكاتب صنع الله إبراهيم (1937 ــ 2025) «تلك الرائحة» عام 1966، العام نفسه الذي صدرت فيه رواية «ثرثرة فوق النيل» لنجيب محفوظ، ليصبح الفارق هنا بين شخصيات اختارت تغييب نفسها عن الواقع حتى يمكنها التعايش معه، أو ربما محاولة تجاوزه، كما عند محفوظ، وشخصية يحاول الواقع جاهداً تغييبها، لكنها تتحايل ظاهرياً بموافقته أو بمعنى أدق مجاراته لكشف مفاسده، كما فعل صنع الله إبراهيم.
وستظل «تلك الرائحة» عمل إبراهيم الأول هي الأكثر كشفاً عن موقف الرجل، في ما بعد، عن نفسه وعن العالم الذي يتحدث عنه، بل تعد أفضل ما كَتَب، حتى لو شابها بعض عثرات العمل الأول ـ من وجة نظر النقاد ـ إلا أن هذه العثرات تحمل من جماليات العمل الفني ما لم يتوافر في أعماله الأخرى، حيث سيطر عليها البناء الفكري أكثر من عفوية التجربة الأولى، أو التخطيط الطفولي للحديث مع العالم ومواجهته، وهو ما يُطلق عليه.. (الرواية الأولى).
وتدين هذه القراءة بالأساس إلى كتاب محمود أمين العالم «ثلاثية الرفض والهزيمة/دراسة نقدية لثلاث روايات لصنع الله إبراهيم.. تلك الرائحة، نجمة أغسطس، اللجنة».. دار المستقبل العربي، القاهرة 1985، ثم كتاب رمضان بسطاويسي «علم الجمال عند لوكاتش» الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة 1991.
ملحمة الطبقة الوسطى
هو التعبير الذي أطلقه جورج لوكاتش عن (الرواية)، وقد أصبح البطل الروائي انعكاساً للواقع الاجتماعي في جدليته وأنساقه، فثمّة علاقة جدلية بين طبيعة البناء الاجتماعي، وصورة البطل/الفرد في الرواية الحديثة. هذا البطل (المُشكِل) وفق لوكاتش لا يكاد يحمل من البطولة إلا اسمها، ولم يعد يتمتع بفضائل يتفرد بها دون غيره من البشر. وما بين (الكليّة) و(النمطيّة) تستطيع الشخصية أن تحمل سمات البطولة، فالأولى تتمثل في التكثيف وحمل مظاهر اللحظة الراهنة التي يتم التعبير عنها روائياً، ولو في شكل (البطل السلبي) كثمرة اجتماعية. والثانية تتمثل في الوعي بالمصير وإدراك الذات، هذا الوعي بالمصير يجعل الشخصية ترتفع من الفردي إلى الجمعي، وبالتالي أكثر تعبيراً عن اللحظة التي تجسدها الرواية.من ناحية أخرى يرى لوكاتش، أن تطور الشكل الروائي وثيق الصلة بتطور أشكال الإنتاج في المجتمع، وما العمل الفني إلا نتيجة الصراع الاجتماعي. لذا.. لم تنفصل رؤية لوكاتش (الاجتماعية) عن رؤيته (الجمالية)، حيث إن الثانية تعد نتيجة حتمية للأولى، وأثر لها.
الراوي/البطل
تتجسد شخصية البطل في المسافة المتوترة بينه وبين العالم، وهي بذلك إما المسافة بينه وبين نفسه، أو بينه وبين الآخرين، أو الاثنين معاً. فـ(الراوي) بلا اسم، وملامحه ناقصة ومتآكلة وعاجزة عن الاكتمال، تماماً كحالته ـ حالته كنمط ينتمي إلى فترة الستينيات ونتاجاً لها ـ وما يستبين خلال السرد لا يكفي إلا لتكوين صورة شبحيّة له، فهو يساري، صحافي، يريد أن يصبح مؤلفاً قصصياً، ولم يستطع. كما أنه يعاني الوحدة، رغم علاقاته ـ الهشّة ـ المتعددة مع الآخرين.. «إلى أين ستذهب أو أين تقيم؟ قلت: لا أعرف، ليس لي أحد». فهو من البداية بعيد عن الآخرين، ولا يتواصل معهم على الإطلاق، وفي أضيق الأحوال اضطراراً. كذلك لا يتواصل مع ما يريده (الكتابة)/ذاته.. «وأمسكت بالقلم، لكنني لم أستطع الكتابة». فالبطل النمط هنا، يعد بطلاً سلبياً، رغم كونه أحد مفردات العالم ـ هكذا تمت صياغة البطل ـ والكاشف عن هذه المفردات/المتناقضات في الوقت نفسه، دون أن يستطيع الفرار من هذا العالم، بل مواجهته بهذه السلبية، التي فرضتها عليه ظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهو أحد تجلياتها، وبفضل وعيه يستطيع تحليل ونقد قيم هذا العالم.
لذلك.. فهو (البطل) يتحرك وفق الأحداث، دون استطاعته تحريكها أو السيطرة والتحكم بها، فهو مثل حالته لا يفعل شيئاً على الإطلاق، حتى (الجنس) فهو جنس ذاتي غير مُكتمل، ومحاولاته للتواصل لا تتم إلا في عالم آخر، مفرداته.. الحلم أو التذكّر أو التخيّل، كمثال غائب غير موجود.
الزمن والمكان
ووفق حالة التناقض المتمثله في البطل ووجوده، يأتي (الزمن)، الذي لا تغيب عنه أيضاً سمة التناقض.. فنبدأ بـ(الزمن الواقعي) الكاشف عن أن الأحداث تقع في منتصف ستينيات القرن الفائت، كعودة الجنود من اليمن، والتباهي بخِطبة شخصية من الشخصيات إلى مدير في القطاع العام. ثم يأتي (الزمن الاجتماعي) وهو الزمن الفعلي الذي تحياه الشخصيات وتتفاعل من خلاله، وهو بتناقضه مع الزمن الواقعي، يجعلهم يستشعرون فصاماً يعيشونه، ويحاولون الفرار منه.. «قال إنه بعكس الموظفين الآخرين لا يرتشي، وقالت زوجته: خيبة». وفي الأخير يأتي (الزمن الجمالي) أو (زمن الراوي) النفسي، الذي بدوره يتناقض مع الزمنين السابقين، فيجسد الوحدة والعزلة التي تحيطه، تتملكه ويُنشدها كشكل من أشكال الحماية، حيث عالم طفولته، حينما كان لديه أب يعتمد عليه، ويحتمي به، ويتذكّر رحلاته معه إلى زيارة أقاربه، وركوبهما الترام، الذي اختفى بدوره في الواقع. ولا يختلف المكان بدوره عن الزمن، فالخروج من السجن ليس تحرراً، فلا بد من وجوده بالمنزل قبل المغرب ـ وفق فترة المراقبة اللاحقة عن الإفراج عنه ـ فمن المنزل وإلى المنزل مُكرهاً، هكذا في دائرة مغلقة لا فكاك منها. وأيضاً لا يجد إلا الذكريات، أو حتى ما كان يعتقده في ما مضى، يحتمي بها من سجن القاهرة الكبير.. «وركبتُ إلى منزل ابنة عمتي، وقلت إني سأعرف المنزل من نوافذه الزرقاء.. لكني عندما اقتربت منه اكتشفتُ أنها ليست كما كنتُ أتخيّل، كان الزجاج عادياً بغير لون، إنما السماء هي التي كانت تعطيه زرقته أحياناً».
المفارقة
ولتجسيد حالة التناقض التي يعيشها البطل، ويستكشفها في مجتمعه بعد خروجه من السجن، يتبنى صنع الله إبراهيم صيغة (المفارقة) كبنية أساسية في الرواية ـ ومعظم رواياته اللاحقة ـ وهي الصيغة أو السمة الأكثر قدرة على كشف التناقض، الذي تعيشه مصر حتى الآن، دون الاقتصار على بطل الرواية وزمنه. فقراءة الرواية الآن رغم أنها تمثل المجتمع المصري في منتصف ستينيات القرن العشرين، إلا أنها تعبّر عن اللحظة الراهنة، وفي شكل أكثر عنفا وقسوة. ونعود إلى المجتمع الستيني الذي يتبنى سياسات الاشتراكية، والذي ينادى خطابه المزمن بالحرية والمساواة والعدل، لكنه في الوقت نفسه يمارس سلطاته في السجن والتعذيب والمراقبة. هذا التناقض هو ما جسد المسافة الشاسعة بين القول السياسي والفعل، ليتضح أن (السُلطة) هي مصدر (تلك الرائحة) التي تحاصر البطل، العاجز تجاهها ولا يستطيع الفكاك منها.. «ففي الوقت الذي تعرض فيه كل السينمات أفلاماً كوميدية، تبث الإذاعة مسلسلاً بعنوان (الشبح الأسود)، حيث يسأل صبي في صوت باك.. كيف يستطيع الحياة بعد أن علم أن أباه هو القاتل»!