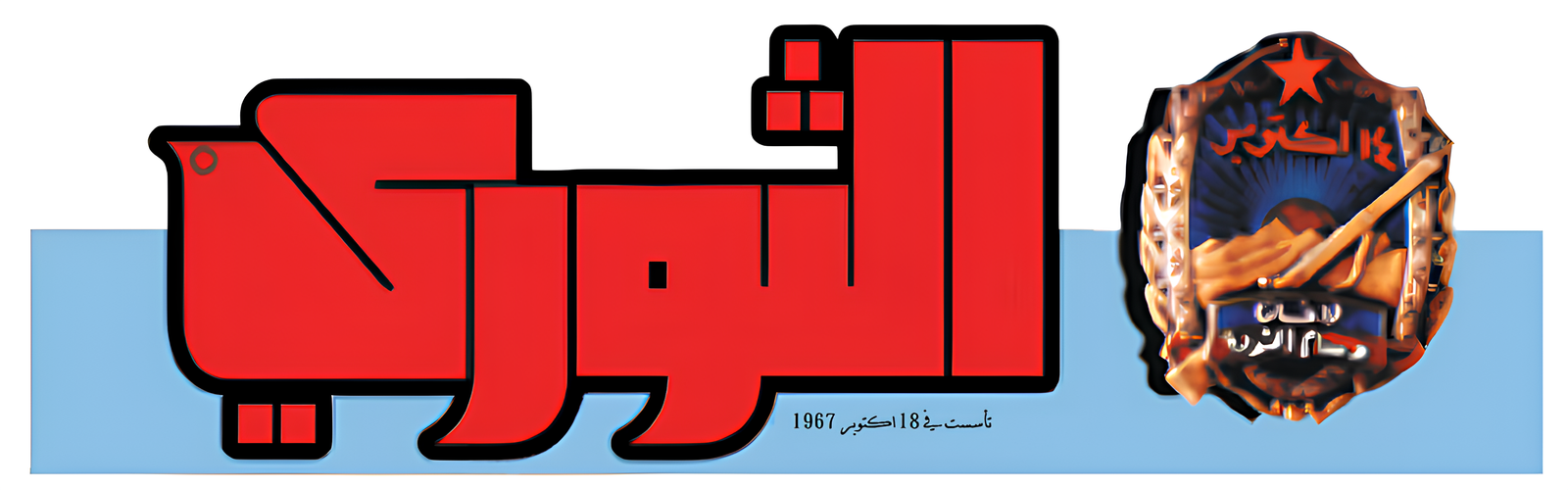“صحيفة الثوري” – ثقافة وفكر:
قصة قصيرة
الإهداء: إلى أبناء عمومتي حبيب وعدنان مشتاقين لكم من كل أعماق قلوبنا … أسرتكم : آل أبواصبع
د. بشير ابواصبع
لم تكن سُمية تعرف أن الأحلام يمكن أن تهاجِم، أنَّها لا تأتي مثل الضيوف، بل كالغزاة. لم تكن تعلم أن الزواج قد يفتح باباً إلى شيء أقدم من الحب، وأخطر من الوحدة، باباً يؤدي إلى وادٍ سحيق من ذاكرة لا تخصّك.
هو حبيب، عاد من دراسة الطب في الخارج. قبل سفره، كان قد شارك في معارك “الطلعة الحمراء” في مأرب، حيث كانت أشد المعارك وأكثرها قسوة، وكانوا يسمون تلك الجبهة “مفرمة اللحم”. أصيب حينها إصابة بليغة، وتم علاجه على إثرها، وقررت أسرته إرساله إلى خارج البلاد لدراسة الطب. قالوا: “أصبح طبيباً”. لكن أحداً لم يسأله: ماذا خسر هناك في تلك الحرب المجنونة، في الخنادق الساخنة كأنما حُفرت في قاع جهنم، في خنادق أبعد ما تكون عن سرير العمليات النظيف! لم يسأله أحد عما فقد من روحه حين أصبحت يده، التي كان من المفترض أن تشفى، لا تعرف سوى مسك الزناد!…
هي أحبته. وأحبّ فيها هدوءها الذي يشبه صمته، والسكينة التي لم يعد يجدها في ذاته.
زوجة جميلة. عشاء تحت ضوء القمر. وجملة لم تكتمل. لكن في الليل، شيء ما كان يكمل الجملة نيابة عنه.
بدأ كل شيء بصوت خفيف؛ همهمة…
ثم: “انسحب… الرشاش معلّق…”!
ظنته يتحدث في حلم، كأي كابوس عابر. لكن الصوت، في كل ليلة، يصبح أكثر وضوحاً، تتخلله أصوات أخرى: أنفاس لاهثة، صرخات مكتومة، خشخشة معدن… حتى قالت لنفسها وهي ترتجف في الظلام: “هذا ليس صوت حبيب. هذا صوت الموت ذاته يتنفس من حنجرته!”.
في الصباح، يعود “حبيب” إلى طبيعته؛ يبتسم، يمشي ببطء، يشرب قهوته… كأن لا شيء حدث. لكن ثمّة شيء لم يكن يعود أبداً: عيناه، وفي أعماقهما كان الدمار لا يزال يشتعل، شظايا معركة لا تنتهي، وكأن كل رمش هو متراس أو ساتر يكمن خلفه رصاص لم يُطلق بعد.
هي تشعر به ينظر من خلالها إلى شيء لا تراه، إلى أشباح تتراقص في ضباب ذاكرة غريبة.
بدأت تكتب ملاحظات في دفتر صغير. ليست مذكرات، بل تقارير مراقبة، كما تفعل الجاسوسة العاطفية التي يتوجب عليها فكّ شيفرة رجلها:
الساعة 2:13 صباحاً، قال: “عدنان، متّ!”؛
الساعة 4:07 صباحاً، صرخ: “غطوني!… أنا سلاح لا ينكسر! أنا الساتر الأخير!”…
في إحدى الليالي، قامت سمية بحركة غير متوقعة: وضعت جهاز تسجيل قديماً تحت السرير، ثم جلست تنتظر، وقلبها يخفق كطبل حرب بعيد. الليل عندهم، في الجبل، بارد قارس. لكنها سمعت صوتاً حاراً، حارقاً، يخرج من “حبيب” كجحيم متفجر:
“أُدخل من الجهة الشرقية!… الساتر خلف الجثث!… لا ترحموهم!”. فزعها لم يكن من الكلمات وحدها، بل ومن شيء آخر مزق كيانها. الصوت الذي سمعته ليس صوت “حبيب”! إنه محشور في زمن آخر، يتردد من فوهة بندقية لا ترحم.
في اليوم التالي، واجهته، وعيناها تتوسلان إجابة.
“هل قاتلت؟! هل كنت في حرب؟! هل قتلت أحداً يا حبيب؟!”.
“حبيب”، بهدوء كأن الجملة لا تعنيه، وكأنها تسأله عن حالة الطقس: “لا، لم أحمل سلاحاً في حياتي. يدي لم تمسك سوى القلم، ثم المشرط”.
سُمية تهمس، وعيناها تلمعان بالدموع المخنوقة: “لكن السلاح… يحملك أنت، يحمل كل ذرة في جسدك يا حبيب!”.
مرت أيام، وبدأت أصابعه ترتجف بعصبية لا إرادية. يضرب بإبهامه على الطاولة كأنه يضغط زناداً وهمياً، يطلق رصاصات صامتة في الهواء، يتلمس كتفه الأيمن وكأنه يبحث عن قطعة سلاح لا يزال يعانقها.
ذات ليلةٍ، قال لها وعيناه غائمتان كأنما تبحثان عن ضوء بعيد: “حين أغمض عيني، أرى بندقية تمتد على طول عمودي الفقري. كأنني أنا… السلاح! كل خلية في جسدي تتذكر وهج البارود ورائحة الدم!”.
تحوّل بيتهما إلى خندق يرتجف على حافة الهاوية. غرفتهما صارت نقطة استطلاع يراقب منها عدواً لا يراه أحد غيره. وهي… لم تعد زوجة، بل ممرضة في حرب، تشد أزرار سترته كأنها تربط ضماداً. شاهدة على تفتت إنسان. كانت سجّانة لحاضرٍ أُسر في ماضٍ دموي. كان الخوف يتسلل إليها أحياناً، الخوف من رجل لا تعرفه، رجل تسكنه ذاكرة غريبة، لكن كان يربطها به الحب، يرفض أن يتلاشى حتى أمام هذا الرصد المأساوي.
وذات مساء، جلس إلى جوارها، وقال بهدوء مخيف، كهدوء ما قبل العاصفة: “أنا لست حبيب تماماً. هناك شخص، في مكان ما، مات ولم يُدفن، سقط في وادٍ سحيق، في حفرة لم ترها عين. وأنا… التقطت روحه بالخطأ. لقد دخلت تلك الحرب بحثاً عن المعرفة، لكني خرجت منها محملاً بآلاف الأرواح التي لا تعرف طريقها إلى السكون”.
ارتجفت؛ لكنها لم تتحرك، لم تستطع. فكرت في أن ما يسكنه هو شبح جندي، أو لعلّه شبح فكرة، فكرة الحرب التي لا تموت. وربما… شبح وطن جريح، لم يندمل جرحه قط، وما زال ينزف من أرواح أبنائه… مثله لم تعد تعرف من هو “حبيب” الحقيقي: الطبيب الذي أحبته، أم السلاح الذي يحمله، أم ذاكرة وطن مثقل بالرصاص والأشلاء!
استفاق “حبيب” فجراً، وفتح عينيه ببطء شديد، كأنهما تطلان على فجر ساحة معركة، لا على شروق الشمس.
قال بصوت مبحوح، موجّهاً كلامه إلى فراغ لا تراه سُمية: “أين البندقية؟! لا أشعر بكتفي… من أطلق عليّ النار؟! لقد نفد رصاصي… هل انتهت الحرب أخيراً؟!”. نظرت إليه. لم يكن يتحدث إليها، بل إلى أحدٍ غير مرئيّ، إلى أشباح رفاقه الذين سقطوا. سحب الغطاء. وقف كأن جسده ينتظر طلقة الرحمة، طلقة تنهي عذابه الأبدي.
ركع، وقال شيئاً لم تفهمه، لكنه تردد في أذنيها كصدى صرخة قديمة: “أنا السلاح… من دون من يشغّله. أنا آخر ما تبقى من حرب لا يريد أحد أن يتذكرها”.
وسقط، كأن ذاكرة الجندي التي سكنته قررت الرحيل أخيراً، لتأخذ معها آخر ما تبقى من “حبيب”؛ لكنها تركت في عينيه بصمة نار، بصمة حرب أبديّة.
سُمية لم تبكِ. فقط نهضت، بقوة لم تعرف أنها تملكها، وذهبت إلى دفترها الصغير، الذي أصبح سجلاً لجنون أحبّته، وكتبت بحروف ثابتة، لكن بقلب محطم: “انتهت الحرب؛ لكنه لم يرجع. لم يعد حبيب قط”. ثم رسمت في أعلى الصفحة سلاحاً بلا زناد، سلاحاً ممدّداً، بلا روح، بلا هدف، وسمّته: “حبيب”!