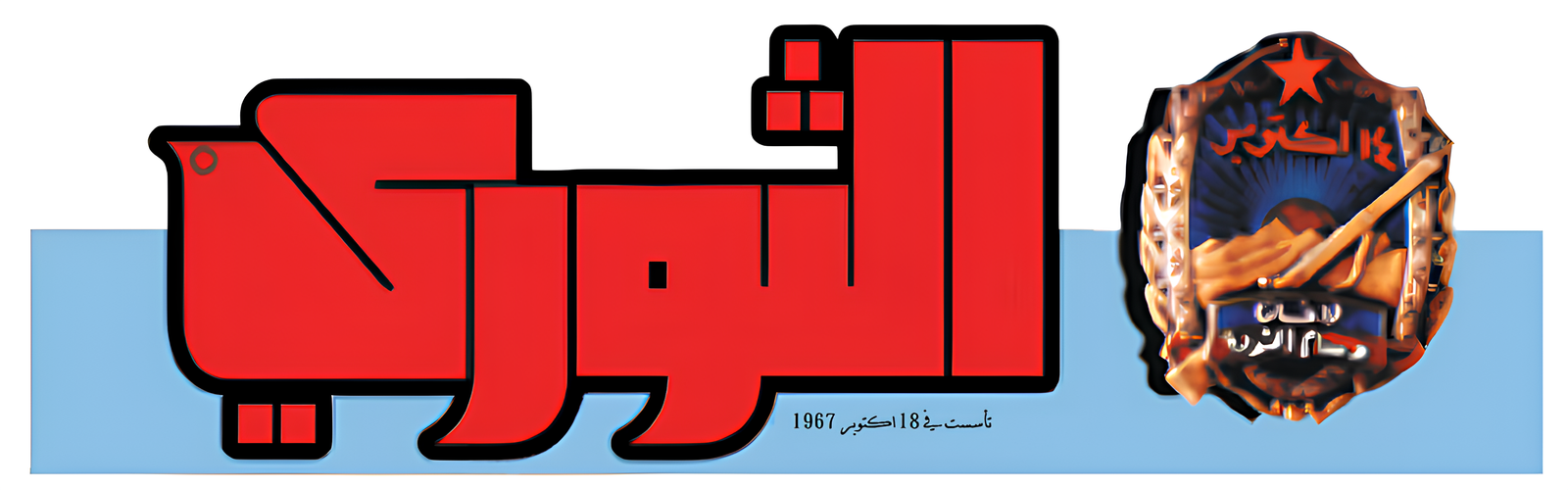“صحيفة الثوري” – كتابات:
ريان الشيباني
لديّ كتب ورقية أعتبرها مختارة، لتُقرأ مرتين وربما أكثر. لكن ما دوافعي لذلك؟!
أوّل كتاب احتفظت به- ولازلت- للقراءة الثانية، كان رواية (الجنرال في متاهته) لغبراييل غارسيا ماركيز، وترجمة صالح علماني. أما قصة وصوله إليّ، فتتمثل في التالي: في العام 2007، غادر صديق لي، مدينة تعز، للإقامة في العاصمة صنعاء. ولكي يتخلص من مكتبته، أهدى عناوينها لأصدقائه المقربين، فكان نصيبي بعض الإصدارات، منها رواية الجنرال في متاهته. شدّني في هذا العمل، تفصيل غريب، وهو انتزاع شخص ما للصفحات الأخيرة منه، على النحو الذي يجعل أحداثه غير مكتملة. سألت صديقي عمّن فعل ذلك، فرد بإجابة لا تقل غرابة: لقد أكلته غنمة أمي المُدللة!
لأكثر من ثلاث مرات، قرأتُ الرواية، لكن في كل مرة أترك الكتاب، أشعر أنني لا أصل إلى منطقة الإشباع المرجوة، وهي مصير بطل الرواية، الجنرال سيمون بوليفار، إذ دائمًا ما يتوقف السرد- على نحو خاص- بسبب الصفحات الناقصة؛ أي في إحدى حفلات الضجر، التي تقام على شرف مغادرة الجنرال للسلطة، وعزمه السفر إلى أوروبا لاتخاذها منفىً اختياريًا. لكن ليس هذا سببًا مقنعًا- على الأقل لي- للعودة إلى الكتاب.
بنى ماركيز روايته هذه، على حدث تحرير أمريكا اللاتينية من الاستعمارالأوروبي، من خلال تناوله لشخصية البطل المُخلّص، لكن وبينما كان القُراء ينتظرون من كاتبهم المُفضل، بناء الشخصية من جانبها البطولي أو على الأقل جانبها الدّرامي الحافل، أخلص ماركيز لأسلوبه وللغته التي لا تستثني في شاعريتها وتهمكها أحد. لقد رأيناه، وهو يفلت من عقال السحر في شخصية البطل، للقبض على لحظة تبدو متكررة على نحو أبدي في ممارسات الولع بالمجد: فرية التخلي الطوعي عن السلطة. ولهذا، لا تعكس صفحات هذا العمل، جهود عشرين سنة لتحرير ست دول لاتينية، بل؛ شخصية هزيلة بجسد متضاءل، غارق في حزنه ومآله الأخير، تكويه الحمى، وتفلت منه الفسوات المُنتنة.
شغفي الأول تجاه هذا العمل، يبدأ من الأسلوب العتيق لاستخدام اللغة، وهي سمة- عادة- ما تميّز كل أعمال مركيز المنقولة للعربية، بواسطة صالح علماني. الانتباه لهذا الجو العام في النص، وسبر أغوار اللغة فيه، يمكن أن تفلت من مترجم ليس على دراية بالخصوصية التي يمثلها ماركيز، بالنسبة للغته الإسبانية. فبقدر، ما تبدو الحكاية بطيئة، ولا تحقق الاستثارة المرجوة من الأحداث، يأتي الدور على اللغة، لجلب السحر المنقطع النظير، والذي من خلاله، ننحاز لكل ما له صله بأمريكا اللاتينية. هل يبدو هذا كافيًا، للشروع في القراءة الرابعة للعمل؟
في الصيف الماضي، حاولت إنزال نسخة إلكترونية، لتدارك ما فاتني من الأحداث، بسبب (الغنمة المُثقفة)، لكن لم أصل إلى نتيجة. وبدلًا من ذلك، وعيتُ أكثر على حقيقة أن هذا العمل، يمتلك قوته في لغته لا في أحداثه، ولذلك تتكثف الروعة في الثلثين الأُوَل، ليبدو وكأن نزع الأوراق في النسخة الورقية، نابع من إرادة كونية لا واعية. وحتى لحظتي هذه، لا أدري المصير الذي واجهه الجنرال، إن لم يكن الأمر قد صار إلى خارج اهتمامي بالمطلق.
الكتاب الثاني رواية النمر الأبيض للروائي الأسترالي- الهندي أرافيند أديغا. اقتنيت هذا الكتاب في أوقات من العام 2010، من آخر معرض كتاب دولي أقيم في مدينة تعز، وصادر عن دار ثقافة ومؤسسة محمد بن راشد، ربما كان توصيفه باعتباره حائز على جائزة البوكر مان، من دوافع اختياري له. لكن وبعد الانتهاء من قراءة الرواية، استعارها صديقي لي، ويبدو أنه أعجب به، فصادره عليّ.
بقيت لسنوات أخرى، ألهث للحصول على نسخة أخرى من الرواية، ولم أصل إليها، حتى عرفتُ أن سلسلة إبداعات عالمية، التي يُشرف عليها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، أصدرتْ نسخًا جديدةً، ما مكنني الحصول على نسختي. قوة هذا النص، تكمن في النقيض المدهش الذي تجلبه الجملة الأولى، والتي يقدم بها البطل نفسه “مفكر ورجل أعمال”، أو “فيلسوف ورجل أعمال”. أما عندما تنتهي من الرواية، تتميّز غيظًا من أنك لست كاتبه. كيف للناس أن يعبّروا عن مآسيهم بمثل تلك البساطة العميقة، والسخرية، مع الاحتفاظ ببيئة الهامش، وجعل اللغة وسيطًا للتعالي عليها.
زوربا. أتيح لي شراء نسخة من رواية زوربا من بسطة في منطقة وسط البلد بعمّان في آواخر العام 2011، ولم تتح لي فرصة قراءتها إلا في خريف العام 2015. وكأي قارئ للمرة الأولى، يمسك زوربا بتلافيف قلبك. ذلك الذي يعيش حياته كما لو أنه منذور للفن. كانت النسخة التي لدي، من ترجمة المفكر العربي جورج طرابيشي، وفي السنوات الأخيرة، دلّني صديق على نسخة أخرى بترجمة أسامة إسبر.
في العام 2023، اقتنيت النسخة الثانية، من كشك لبيع الكتب في عمّان أيضًا، على أنني أردت الذهاب إلى جملة أخرى، أكثر تكثيفًا، وإن كانت أقل صوفية. وبالمناسبة، ليس هذا دافعي الأول، في قراءة عمل مترجم لاستكشاف ترجمته الثانية. قرأت في وقت سابق ترجمة أسامة منزلجي لرواية الخزي، لجي إم كويتزي، ثم بعد ذلك بسنوات وقعت في يدي نسخة أخرى من العمل وتحت اسم العار بترجمة عبدالمقصود عبدالكريم. وبالمقارنة الأولى بين الترجمتين وقعت في سحر الاختزال لدى الأخير عبدالمقصود، على أن الجملة القصيرة، على حرفيتها، تبدو أكثر مناسبة لي. لكن، المطب، في هذه الترجمة شبه الحرفية، أوقعني، في استغلاق النص المترجم، في ثلثه الأخير. بدا لي، وكأن المترجم، انهارت قواه في هذا الجزء من العمل، فعمد إلى رص الجُمل، دون التملي في دلالتها، أو مقدرتها على حمل المعنى. هذا الأمر، يمكن تشبيهه على نحو تقني، بأداء المنتخب اليمني لكرة القدم، في شوطه الثاني.
أخشى، أن تطول هذه المقالة، إذ كل فقرة أكتبها، يتناسل منها كتاب آخر، قد يحول هذه اللعبة إلى ضرب من الملل، لكن سأعرج سريعًا، على كتب مثل أسير عاشق لجان جنيه، والضوء الأزرق لحسين البرغوثي، ورواية العدو، باعتبارهم من الكتب التي تولد دوافعًا مقبولة لقراءتها مرة أخرى، وحتى وأنا أكتب هذه الفقرات، كنت قد انتهيت في الليلة الماضية من يوميات امرأة في برلين، وهو كتاب خلفني ورائه مصعوقًا، ومغمورًا بالروعة حتى العنق. وسآتي إليه في فقراتي القادمة من الرّف.
نقلاً عن رفّ الخميس