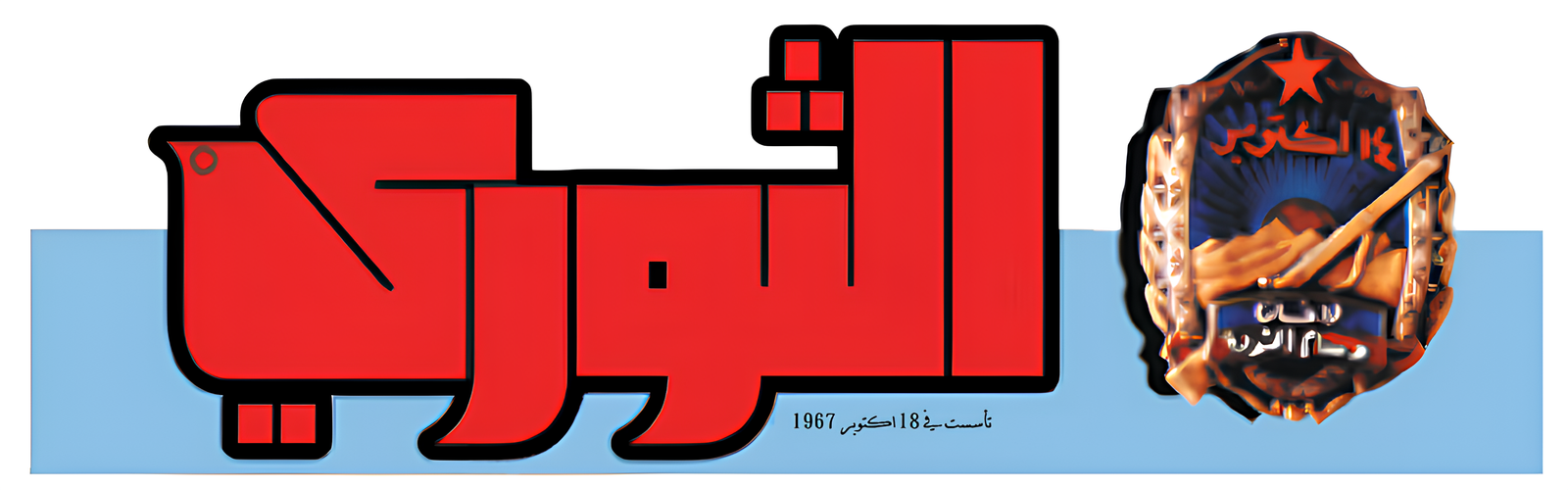“صحيفة الثوري” – ثقافة وفكر:
تقديم:
في الذكرى الثامنة لرحيل الشاعر والمناضل الجمهوري الكبير أحمد قاسم دماج، تستعيد “صحيفة الثوري” بعض من ذاكرتها للعام ٢٠٠٥م، قبل عشرون عاماً، من الآن لنقرأ في تفاصيلها بعضاً من الإرث الثقافي والنضالي عبر نشر مقالة المفكر اليساري البارز الدكتور أبوبكر السقاف، الذي خط بمداد الفكر شهادة عن رفيق الدرب والقلم.
لقد وقف دماج والسقاف على مدى نصف قرن في مواجهة سلط الظلم والاستبداد، متسلحين بالكلمة الصادقة والموقف الحر. كانا صوتاً للمهمشين، ورفاقاً للفقراء. جسّدا في كل حرف وموقف معنى المثقف العضوي الذي لا يهادن، ولا ينحني أمام ذهب المعز أو سيفه.
اليوم، نعيد قراءة شهادات السقاف عن دماج، لا لنرثي الماضي، بل لنستلهم دروسه في الحاضر والمستقبل، وفاءً لمسيرة نضالية يسارية قدمت الثقافة والفكر كجسر نحو الحرية والعدالة.
دماج.. تركيب الأحداث وخلق الأزمنة المستقلة
دخلت لغة جديدة عالم العرب، مقتحمة بيئة النثر والشعر، وذلك مع ظهور الرومانسية والتعبيرية مدرستين محملتين يزاد فكري تمتد جذوره في الفلسفة الغربية ولاسيما الفلسفة الجمالية، المثقلة باحساس جدير بالعالم والاستاطيقا التي نعربها بكلمتي علم الجمال، تعني في اشتقاقها اللغوي الإحساس؛ ادراك ألوان وأصوات وأصداء العالم من حولنا وفينا.
د. أبوبكر السقاف
وأقرب المعارك الفكرية التي دارت في عصرنا احتدمت في مجال الشعر الجديد منذ بداية الخمسينات في القرن الماضي بين المدرسة القديمة التي اعتبرت كل خروج عن القصيدة العربية الكلاسيكية عدواناً لا على الشعر بل على ثقافة الأمة، وتدميراً للغة والمدرسة الجديدة التي تمسكت بالتفعيلة وطوعتها لصوع قصيدة مبتكرة تناسب الإحساس الجديد بالعالم. وكان الشعر الجديد في حقيقته مدخلاً إلى عالم جديد، وكثيرا ما كان مقدمة لتبني الجديد في الفكر والسياسة، دون أن يعني ذلك أن كل مجدد في الشعر طبيعي او تقدمي في المجالات الأخرى، بل هناك شواهد في الثقافة الغربية ان مجددين كبارا كانوا من عناة الرجعيين والامبراطوريين والفاشيين، كما مي الحال مع كيلنج واليوت وعزرا باوند وسيلين وكذلك الحال في الأقطار العربية ومنها اليمن، فهناك من لم يغادر إيمانه بالحرية وحرية اللعب بتفعيلات بحر من البحور، ملتزماً في الحياة العامة بموقف ابعد ما يكون عن الدفاع عن الحرية، بل يتجاوز هذا الى رفضها ومعاداة انصارها.
إن أحمد قاسم دماج واحد من الذين كما يقول الخيام ‘تتسربل نشوته” الشعرية أفق حياته، حيث تتكامل فيه نظراتة الى السياسة والوطن والأخوة والصداقة، فهو ليس مجدداً هنا، ومحافظاً هناك، أنه منسجم مع موقفه في كل هذه الصعد. ولذا كانت قصائده في الرثاء داخل إطار الصدق مثل رثاء عمه مطيع دماج الذي رباه، ولاشك أن أول من بصره بالبلاغة العربية الكلاسيكية بابجديات الوطنية السياسية، وجعله يعكف على ديوان المتنبي، الذي يجسد سيرة ثقافية درامية، كانت علماً على قضية خالدة: طلب المستحيل، الذي قال فيه جوته العظيم في سفر «فاوست» الجليل “حبيب إلى نفسي من يطلب المستحيل”. والمستحيل هنا أفق يبتعد عنا كلما اقتربنا منه، ولكن السعي إليه هو السر الذي يجعل لحياتنا معنی.
أريد من زمني ذا أن يبلغني
ما ليس يبلغه من نفسه الزمن
هذا الإحساس الفردي ذو الدلالة الجمعية في تاريخنا، اذا ما تذكرنا عصر المتنبي، تحول اعجاب اشعرنا من المتنبي إلى السياب انتقال من ذروة الى أخرى. وهذا أقصر الطرق كما لاحظ صاحب «هكذا تكلم زرادشت» ولكن بلا شك أكثرها تطلباً للشجاعة والمغامرة. هل من المصادفة ان السياب هو الشاعر الذي علق عليه الجواهري أمله في تحقيق مزيد من تجديد بنية الشعر العربي الحديث. فقد أكد هذا الرأي في حديث أجراه معه أدونيس ونشر في مجلة مواقف.
لماذا اختار هذا الشاعر الكبير حقاً، والكلاسيكي الجديد، السياب؟ ربما لان تجديد السياب يبدو سلساً وقوياً متينا، وكأنه في بعض وجوهه استمرار لجوانب عديدة من روح الشعر العربي القديم، وكان هناك اتصالاً وانفصالاً، لا قطيعة حادة كالتي يشكو منها بعضنا كلما تحدث
عن قصيدة النثر أو النثر شعراً. لعل هذا سبب انتقال أحمد إلى السياب دون أن يسمع كلام الجواهري، الذي نشر في تسعينات القرن الماضي. كما أن قوة الخيال. وكثافة التخييل، والتواشج مع الأساطير كثيراً ما تكسب شعره ألقاً خاصاً، يجعله ممثل عوالم كثيرة.
فالأساطير المحلية والعامة عنصر تجديد فلسفي وشعري خطير ومخصب وارتباط بالشعر الإنساني في مختلف العصور.
وهناك بعد آخر لا يفهم إلا في سياق ذلك الزمان، أقصد الإحتفال الشديد بـ “الأسلحة والأطفال” والطواف في عتمة “المومس العمياء”، وكلها موضوعات كانت في الخمسينيات والستينيات ملتصقة بمشاعر واحساسات وخيال جمهور، جعل العالم كله بقضاياه وآلامه أفقا للتفكير والتعاطف. كانت الهوية العربية في وئام مع القضايا الكونية، دون أي ضياع أو انحراف عن قضية الحرية والعدالة والتضامن والتحرير والتحرر كل هذا قرب السياب الى احمد، لأن الشعرية الجديدة كانت حاجة خاصة ومطلباً عاماً وأفقاً مشتركاً، فكانت طفرة الانتقال.
إذا تجاوزنا تعريفات وتوصيفات العلامة الحضرمي ابن خلدون للمتعلم وصاحب القلم، وكررنا هذا الموقف مع الإمام الغزالي وآرائه في “رسالة إلى الولد” ووصلنا إلى القرن العشرين، نجد صوراً وتعريفات للمثقف كثيرة يمكن دون ايجاز مخل ان نصل بها الى ثلاث: رأي جوليان بندا، الذي يقترب بدور المثقف من دور النبي، فهو يبدأ من أن البحث عن الحقيقة، والجهر بها، الواجب الأول، ومن هنا كان ذمه الشديد في الثلاثينات الموقف عدد كبير من مثقفي أوروبا في تلك السنوات العاصفة التي أسفرت عن حرب قتل فيها زهاء أربعين مليون إنسان. ورأى بورديو، الذي يقول بأن على المثقف أن يقوم بتوظيف تخصصه العلمي وخبراته، لتحقيق إنجاز مؤثر في الفعل السياسي بصورة مستقلة عن ما تمليه سياسة هذا الحقل. ولذا جاءت استنتاجاته في مجال تخصصه عن ايديولوجية الحقل الفرنسي الامبريالي، عندما قام بدراساته السوسيولوجية عن الجزائر، فهو لم يتبع السياسي (الحاكم) بل هذا الأخير هو الذي سار في هدي خطواته العلمية. ورأى إدوارد سعيد في دور المثقف، جزء من نظريته في الثقافة، فكل تجربة ثقافية هي العمق الجوهري جينة. (الثقافة والامبريالية 1993)، فالهجنة خصوبة وثراء، والعزلة التي تغرينا بها الهويات لون من الإثم، لأنها تغلق علينا الأبواب كافة، داخل سجن القومية أو الفئة أو الدين، ولا ينتج عن هذا الرأي موقف عدمي أو جبان من قضية الحق والعدالة. وهو ما عبر عنه إدوارد بممارساته الفكرية والعملية أبدع وأروع تعبير، فجاءت مواقفه متوهجة وجميلة ونبيلة جعلته أفقاً مدهشاً ونسيج وحده، وأجلّه وقدره حتى الأعداء، ومناصر وقضايا العرب في فلسطين وغيرها. فاستطاع ان يقول برنة كبرياء وشجاعة تحتضن مدى انسانياً شديد الرحابة: إن ما يحدد مكان المثقف هو التزامه بالقضايا الكونية.
إن المشترك الذي يجمع الآراء الثلاثة هو استقلال المثقف، وعثوره في داخل ذاته على مركز ثقله، فالذي يقع مركزه خارجه بعيد عن هذا المدى.
الشعر أكبر من السياسات والرايات والأحزاب وبيارق الزهو العابر.
يميز أحمد قاسم دماج موقفه المستقل من السلطة/ السلطات والسلطان، لم يزحزح مجال شعره من مدح أهله وأصدقائه حمران والوصابي، أو الشهيد الزبيري او الذين سقطوا في حورة ليمدح صاحب الزمان القبيلي، كما فعل كثيرون نثراً وشعراً، فجعله أحد شعراء 26 سبتمبر (الصحيفة) “من سماحات نبي الهدي” (26 سبتمبر 2005/4/14) ووصفه شاعر سبتمبري آخر نثراً فهو “أكبر واكثر من كل الأوسمة والجوائز المحلية والعربية والدولية” (26 سبتمبر (2004/11/25) اختير النثر الصعوبة حفظه في بلد يعيش زمن الشعر حمينياً وفصيحاً. أما النثر فلا يتذكره أحد، ويفي بالغرض.
كازانتزاكي هذا اليوناني الكبير الذي حرم ظلماً من جائزة نوبل، ربما بسبب يساريته، أو بسبب تأويله الحر الجميل لحياة المسيح، وهو المسيحي الشرقي.. تحدث في مذكراته عن الإنسان المتحقق قائلاً:
“ان ترفض أبداً التنكر لشبابك حتى أقصى مراحل شيخوختك وان تصارع طوال حياتك التحويل أزهار نضجك إلى شجرة محملة بالثمار هذا ما اعتقد انه الطريق الوحيد للإنسان المتحقق…”
وصاحبنا بعيد عن أقصى شيخوخته ولكنه مثل كثيرين في هذا البلد يهتدي بنجم هذه الكلمات الثاقبة حتى أقصی شیخوخته.
إنه شاعر مقل، وهذا ليس عيباً “بغاث الطير أكثرها فراخا….”
…. مابين حد السيف والياقوت،
ينحصر المدى ومسدس غسق و اطراق
وشيء من تفاهات…
وأحقاد تتوج رأس ثعبان
يطاردنا
فيأتي البحر.
بهجر موجه
فيكون حامينا الأخير
ويظل مزن الورد
والرمان منهمراً
وهذا البحر يشهد أن (حورة) لم تكن
تروی
ولكن الكهوف غيلانها عطشى
وما انهمرت مواجعنا
ولكنا انهمرنا في الرحيل
لنسمر الرمان في أغصانه
ونقول طوبی إن قابلة تعد
لترفع البحر الوليد (من بين يدي حورة)
مفردات القصيدة.. الإفلاك، والمدى، الرمان، والبحر، والابتداء.. توحي بتحليق فوق الحدث وبعيداً عنه ولكن لتقترب منه في مستوى يعيد تركيب الحدث/ الأحداث فيخلق زمناً / أزمنة مستقلة عن الحدث الذي يتكثف داخل شبكة تخييل تسبر الذاكرة، وتتطلع الى المدى قادماً. أخرج أحمد بهذه القصيدة الرثاء ربما لأول مرة في الشعر اليمني الحديث من دائرته المعروفة، وكان خروجاً حاسما، لأنه تم داخل تصور جديد للشعر.
هذه كلمات كتبت على عجل وليست هذه السطور بحثاً أو دراسة في شعر أحمد، ولا استقصاء لسيرته السياسية.. وداخل اتحاد الأدباء اليمنيين.. ولكن حسبها أنها تشارك في الملف/ التحية، الذي جاء متاخراً، ولكن هذا خير من ألا يأتي أبداً.
عندما اقترح عليّ الشاعر الشاب (على دهيس) المشاركة في ملف عن أحمد قاسم دماج، ترددت لأني أرى أن الكتابة عن من تعرفه أمر صعب، لا بسبب القرب المفرط، كما يقال عادة ولكن لأسباب تتعلق بالبعد الإنساني العاطفي… ولكن حماس الشاعر الشاب لاصدار الملف وفيه كثير من حب الشعر والوفاء له ساعدني على تجاوز هذا الحاجز، لاسيما وأنه يجيء متاخراً ويعود هذا إلى أسباب كبيرة منها ان صاحبنا ليس من الذين يجيدون الدعاية لأنفسهم، بل هو أبعد ما يكون عن هذا المنزلق، لأن كبرياءه، يحميه من الوقوع فيه.
2005/5/10
صحيفة الثوري العدد (1866) الخميس 2 ربيع ثانٍ 1426 هـ، الموافق 12-05-2005