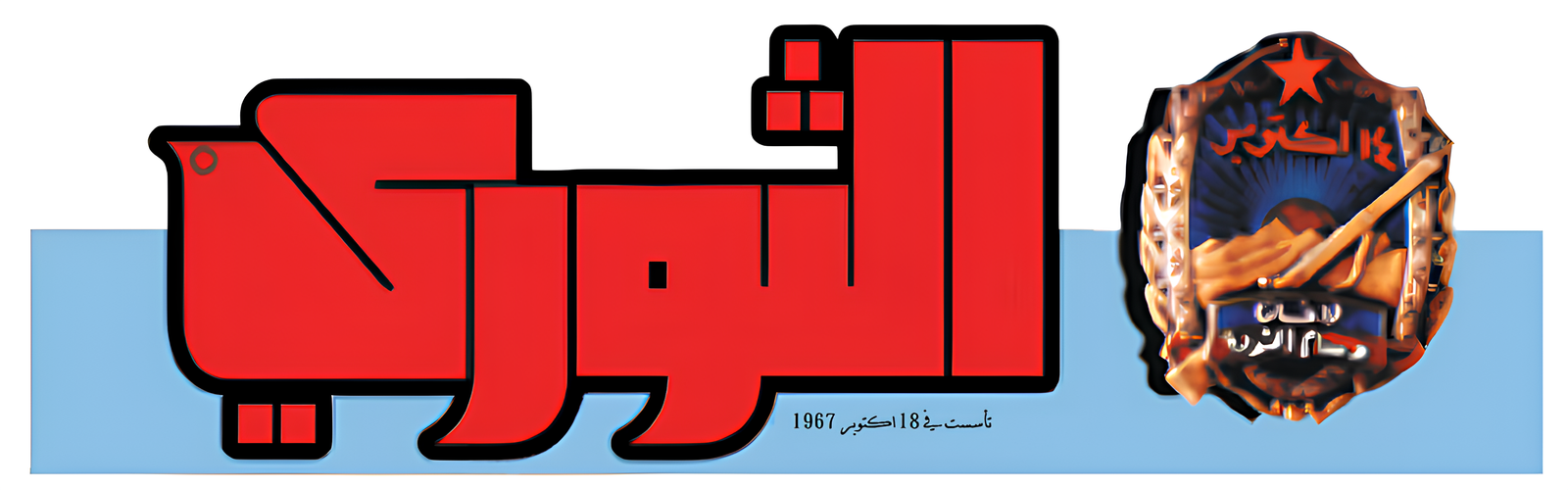“صحيفة الثوري” – كتابات:
جليل أحمد
توأم الدين هي الفلسفة، وجوهر التفلسف هو السؤال.
منذ الأزل، خاض الإنسان غمار الوجود ليسأل عن نفسه، عن الكون، وعن الأشياء من حوله، سعيًا نحو مكاشفة أعمق للحقائق. كانت الفلسفة دائمًا سبيلًا للتساؤل والتفكير، بينما جاء الدين ليقدم إجابات لهذه التساؤلات ويضع منهجًا للحياة، يفتح أعين الناس على القيم والمعاني الكبرى. بهذا يمكن اعتبار الفلسفة مقدمةً للدين أو حتى شريكًا له في رحلة البحث عن المعنى.
قبل ظهور الأديان، كانت الفلسفة البوصلة التي استعان بها البشر لفهم الخير والشر، الحياة والموت، الدولة والإله. على سبيل المثال، ركزت الفلسفة السقراطية على كشف قيم الصواب والخير وناقشت معانيها، إلى جانب مفاهيم الدولة والمعرفة والإله. تبعتها الفلسفة الرواقية، التي دفعت الناس إلى الإيمان بالحتمية الطبيعية والتسليم المطلق بالقضاء والقدر، مشيرة إلى وجود قوة عظمى هي الله.
بهذا، مهدت الفلسفات القديمة لظهور الأديان، أو عملت كرفيق لها، مكملةً مهامها الروحية والفكرية. يمكن القول إن الفلسفة كانت الدين الأول للبشرية، إذ زودت الإنسان بأدوات التفكير التي قادته لاحقًا إلى تقبل الأديان.
الإشكالية المعاصرة: التشدد ضد الفلسفة
مع مرور الزمن، خصوصًا في العصور الحديثة، أصبح التشدد الديني عائقًا أمام الفلسفة والتفكير النقدي. بعض المتشددين، الذين يفتقرون إلى المعرفة العميقة، اعتبروا الفلسفة تهديدًا للإيمان. هؤلاء “المتزيفون” أو “القشريون”، كما يمكن تسميتهم، منعوا طلبة العلم والباحثين من التعمق في الفلسفة بحجة أنها تهز العقيدة وتقود إلى الإلحاد.
خطأ الفهم القاصر
هذا الموقف يعكس جهلًا بطبيعة الفلسفة والدين معاً:
الفلسفة لا تهدم الدين، بل تعمقه: فهي تمنح العقل أدوات لفهم العقيدة بوضوح أكبر.
الإلحاد ليس نتاج الفلسفة: بل غالبًا ما يكون نتيجة تجارب شخصية أو مواقف اجتماعية، وليس التفكير الفلسفي بحد ذاته.
الدين والفلسفة وجهان لعملة واحدة، يسعيان معًا إلى البحث عن الحقيقة وإرشاد الإنسان في رحلة حياته. ومع ذلك، بسبب سوء الفهم والتشدد، تُتهم الفلسفة ظلمًا بأنها تهدم العقيدة، رغم أنها كانت وستظل منارة للتفكير الحر.
قصة أحمد: نموذج من الواقع
في اليمن، ظهرت حالات عديدة تعكس تأثير البيئة المتشددة على حرية الفكر والنقاش الثقافي. أحمد، شاب يمني، كان طالبًا في أحد المعاهد حين حضر نقاشًا بين زميله وأحد المعلمين حول موضوع فلسفي. كان النقاش علميًا ومنفتحًا، إلا أن أحد الطلاب، الذي نشأ في بيئة إسلامية محافظة ترفض الحوار الثقافي والانفتاح الفكري، استنكر النقاش.
لم يتوقف الأمر عند ذلك؛ بل قام الطالب المتشدد بنقل الموضوع إلى جهات دينية متشددة، مدعيًا أن النقاش يشير إلى تعاون مع جهات أجنبية تعمل على محاربة الإسلام. نتيجة لهذه الاتهامات، تم استدعاء أحمد وزميله من قبل الأمن السياسي، حيث تعرضا للإهانة والاحتجاز.
داخل السجن، عانى أحمد من التنكيل النفسي والجسدي بسبب هذه الاتهامات الملفقة التي اعتبرت النقاش الفلسفي “جناية دينية” و”تهديدًا للأمن العام”. وبعد الإفراج عنه، خرج أحمد بعلامة واضحة على قسوة مجتمع لا يتسامح مع الاختلاف الفكري، ويستخدم القوانين كأداة لقمع الحريا
الخاتمة
قصة أحمد، كغيرها من القصص المشابهة، تعكس مأساة بيئة تغيب فيها حرية الفكر والنقاش، حيث يُنظر إلى الفلسفة أو الحوار الثقافي كتهديد بدلًا من اعتباره وسيلة لتعزيز الوعي والتسامح. الحاجة ملحة لتغيير هذه النظرة الضيقة وإعادة فتح الأبواب أمام الفلسفة، لتصبح منارةً تُرشد العقول، وتعزز قيم الحرية والاختلاف.