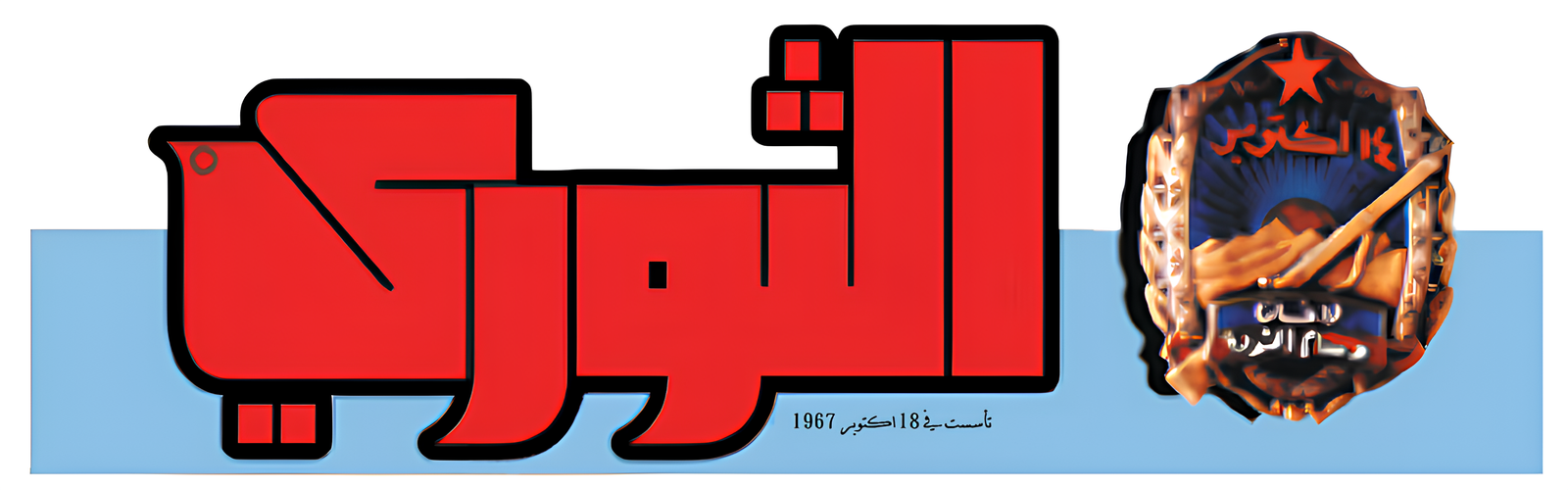صحيفة الثوري- جريدة المدى:
فخري كريم
غالباً ما يبدي البعض شيئاً من الدهشة حين نتغنى بـ “الزمن الجميل”، ونتحدث عنه كما لو كان وعداً لم يتحقق أو حلماً انقضى. يندهشون من حنيننا إليه، ومن خيبتنا مما آل إليه حالنا اليوم، وكأنّ الحنين جريمة، أو كأنّ الوفاء لذاكرة النقاء عارٌ في زمن العدم.
لكن الغرابة الحقيقية لا تكمن في الحنين، بل في أن يتساءل المرء عن جمال زمنٍ مضى، فيما تحيط به الآن ظلمات تتكلم باسم الدين والمذهب، ويهيمن على الفضاء العام خليط من التفاهة والانحطاط الأخلاقي والتدهور الثقافي. صرنا نعيش في زمنٍ صار فيه التزوير فضيلة وطنية، يناقش علناً في البرلمان دون حياء، ويعترف به في الوثائق الرسمية كأنه “نعمة ربانية”.
لقد تحوّلت “الدويلة الخربة” إلى مرآة للفساد الشامل الذي رعته الطبقة الحاكمة وعرّابتها خلف الحدود، فصار اللص يتباهى بلصوصيته، والمزوّر يمنح منصباً، وصاحب «الدكة العشائرية» يكافأ بوزارة أو بجامعة.
لقد عاد السؤال المرير عن “الزمن الجميل” يطرح من جديد، لكن بصيغةٍ أشدّ وجعاً، أقرب إلى الغربة منه إلى التأمل. الغربة لا عن المكان فقط، بل عن القيم التي كانت تصنع هوية العراق الأخلاقية. والسبب تلك القوائم التي نشرت مؤخراً — قوائم أعدّتها المخابرات الأميركية آنذاك، تضم مئات الأسماء من العراقيين الوطنيين والمتعاطفين مع الحزب الشيوعي وحركة السلم. قوائم لصفوة المجتمع العراقي: من أطباء وأدباء ومعلمين ومربين ورجال دين وشيوخ ومثقفين، شكّلوا آنذاك الوجه المشرق لبلدٍ كان حياً بعقله وضميره. وقد أشار إليهم المؤرخ الكبير حنا بطاطو بوصفهم أيقونات العراق الحديث.
غير أن تلك القوائم لم تكن سوى مقدمةٍ للكارثة. فقد سلّمت عشية انقلاب الثامن من شباط عام 1963 إلى قيادة حزب البعث، لتستخدم في المجازر التي عرفت لاحقاً: قصر النهاية، أقبيته، سجونه ومسالخه البشرية. تحوّلت مقار الدولة والنقابات والنوادي إلى مراكز تعذيب، وسالت الدماء في كل مدينة وقرية. وحين قال علي صالح السعدي: “جئنا إلى السلطة بقطارٍ أميركي”، كان يختصر مأساة وطنٍ كلّفه طهارته الأولى غالياً.
تلك القوائم لم تكن مجرّد وثائق استخبارية، بل مرآة لما كان عليه العراق من قيم إنسانية عظيمة. حين يقرأها الجيل الجديد اليوم، الذي لم يعرف غير صدام حسين وزمن الرعب والحروب، يصاب بالذهول وهو يرى أسماء أطباء وأدباء واقتصاديين ومثقفين كانوا يعيشون للنزاهة لا للمنصب، وللواجب لا للغنيمة. يسألون بدهشة: هل كانت نخبتنا بهذا العدد، بهذا السمو؟ فأجيبهم: هؤلاء لا يشكّلون اكثر من واحد المئة من نخبة بغداد فقط، دون احتساب المئات الذين أخفاهم العمل السري والحزب والاعتقال، منذ لحظة انحسار المدّ السياسي وانقلاب عبد الكريم قاسم على نفسه وعلى ثورته، يوم ألقى خطابه الشهير في كنيسة مار يوسف.
كان الطبيب آنذاك يستقبل مرضاه الفقراء في عيادته، بالكاد يغطي نفقات العلاج، لكنه يجد في مهنته رسالة. وكان المعلّم والمربي أكثر علماً وضميراً مما نراه اليوم في صفوف الجامعات. أما المثقفون، فكانوا نخَباً حقيقية، أنتجت روايةً وشعراً ومسرحاً ونقداً وتشكيلاً، ووضعت العراق في طليعة النهضة الفكرية العربية. لم يكن بين هؤلاء من يعرف بفسادٍ أو خيانةٍ أو انحطاطٍ أخلاقي. كان الفساد استثناءً نادراً، لا ثقافةً اجتماعية كما صار الآن، ولا وسيلة للترقي كما هو اليوم.
أتذكّر -وأنا أمرّ على الأسماء- كيف كانت مضابط الشرطة الرسمية تخلو في عيد العمال من أي جريمة سرقة أو فعل مخلّ بالشرف. ذلك كان وجه العراق الحقيقي: بلدٌ يحتفل بالعمل لا بالغنيمة، وبالكرامة لا بالولاء.
أشهد أنني عشت سعادة ذاك الزمن. كنت بين من ساهموا في الحملة الجماهيرية للدفاع عن الحريات والسلم والتضامن الأممي، وجمعت أكثر من سبعين مثقفاً على وثيقةٍ نشرتها وأنا محرّر في جريدة البلاد الغرّاء، مع الصديق الراحل فائق بطي، ومع الأثير “أبو گاطع” شمران الياسري، ومع منير رزوق وصالح سلمان وكوكبة من الأسماء التي غيّبها الموت أو النسيان.
وبعد أسابيع من نشر تلك الوثائق, وجدت نفسي رهن الإعتقال ثم في سجن الكوت، أحمل معي أسماء بعض رفاق الحملة «من أجل الديمقراطية في العراق والسلم في كردستان»، حيث شاءت الصدفة او «الحظ»، أن لا ينتبه رجال الأمن إلى الوثيقة التي تحمل الأسماء!
كان ذلك الزمن جميلاً، لا لأنه بلا عيوب، بل لأنه كان يملك رجالا ًيعرفون العيب.