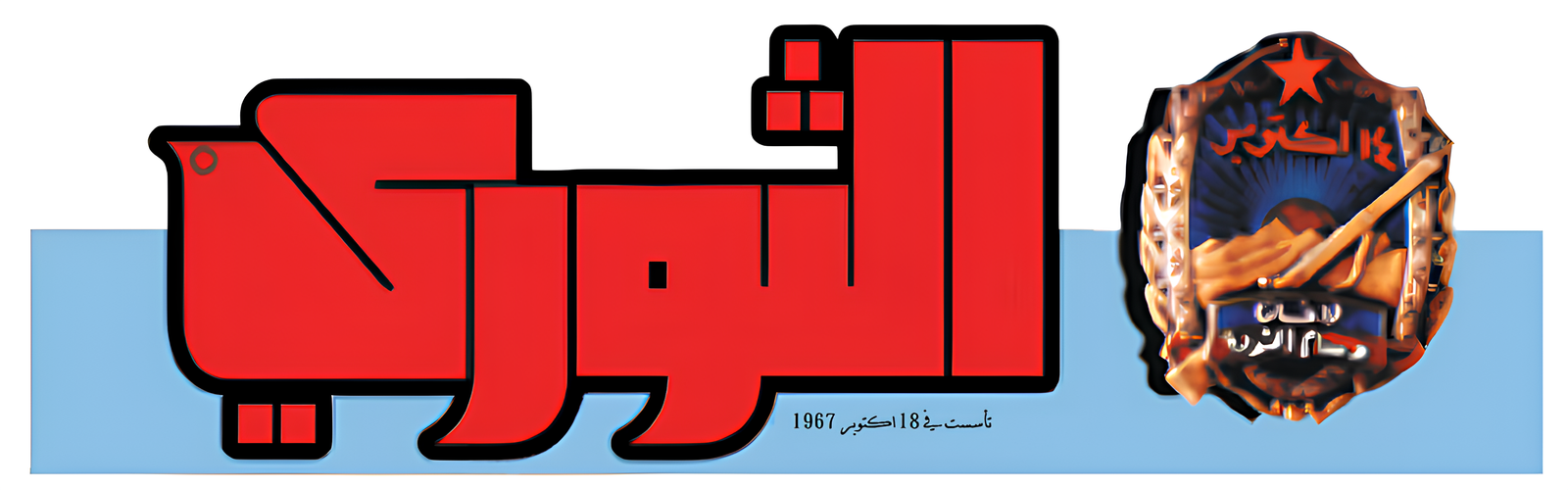صحيفة الثوري- كتابات:
قادري أحمد حيدر
الإهداء:
إلى رؤساء دولة الاستقلال: الفدائيين في قلب الكفاح السياسي والوطني للتحرير، بالسلاح، وبالكلمة.. رموز الفداء والتضحية، والدولة الوطنية.
الرؤساء: قحطان محمد الشعبي، سالم ربيع علي، عبدالفتاح إسماعيل، علي ناصر محمد، علي سالم البيض.
دخلوا إلى الرئاسة عبر الكفاح السياسي، والنضال المسلح، وخرجوا منها فقراء كما دخلوها إلا من طهارة الروح ونظافة اليد.
إليهم جميعًا مع خالص المحبة والتقدير.
كتب الأستاذ أحمد علي جحاف مقالة بتاريخ 8/10/2025م، تحت عنوان “ثورة 14 أكتوبر 1963م، الإيجابيات والسلبيات”، ولم أطلع عليها إلا يوم الرابع عشر من أكتوبر حين عدت لقراءة وتصفح بعض ما كُتب عن هذه الثورة السياسية والوطنية التحررية المجيدة.
هذه الملاحظات السريعة ليست دفاعًا عن الاشتراكية، والتجربة الاشتراكية العالمية، كما أنها لا صلة مباشرة لها بالدفاع عن الجبهة القومية، والحزب الاشتراكي بعد ذلك.. تجربة وحزب ليسا بحاجة إلى من يدافع عنهما، فاسميهما وتاريخهما ودورهما في قلب الحركة السياسية الوطنية اليمنية، هما من يحكيان عنهما ويدلان عليهما ويشيران إلى مواقعهما التحررية والوطنية والتاريخية، والقليل القليل من تاريخهما المجيد يكفي لدحض جميع التقولات.
يمكن أن يكون الحزب الاشتراكي اليمني سليل الحركة الوطنية اليمنية وامتدادها في الجنوب والشمال، هو الحزب اليمني الوحيد الذي تجرأ في أكثر من مناسبة ومرحلة لتقديم وثيقة نقدية حول ذاته السياسية، وتجربته التاريخية، وإن لم تكن كافية، وهو لم يكف عن مواصلة ذلك الطريق والنهج القويم في العلاقة النقدية مع الذات، هذا في البداية.
شخصيًا، لست متابعًا دقيقًا لما يُكتب في الصحافة السيارة لأسباب عديدة، منها كثرة الغث الذي يُرهق العقل، ويتعب الروح، ومنها تعب النظر، على أنه وقع في يدي أقل القليل مما يكتبه الأستاذ أحمد جحاف، وهو ما يتصل بالشأن السياسي اليمني.
ولا أُخفي إعجابي وتقديري لبعض ما وصلني من الكتابة السياسية العامة مع تقديري لشخصه الكريم، دون معرفة سابقة.
وستنحصر ملاحظاتي السريعة على بعض المفاهيم والأقاويل والمعلومات السياسية العامة التي وردت في مقالة الأستاذ أحمد جحاف، لأن الرد على ما كتبه لا يتسع له كتاب كامل، وهي قضايا وأفكار ومفاهيم بعضها سبق أن قُدمت حولها قراءة فكرية بحثية في بعض كتبي المنشورة، وكذلك الرد على بعض الطروحات السياسية العامة المفصولة عن المعرفة، وعن الفكر النقدي التاريخي في صورة تعبيرات وأحاديث ليست في أفضل التقديرات أكثر من تداعيات ذاتية سياسية مشحونة بالأيديولوجية العصبوية، ولا تسندها رؤى نظرية، وخلفية معرفية/فكرية، تدل على أن ما يُقدَّم من سرد سياسي لا صلة له بالقراءة المعرفية الفكرية التاريخية، تُقدَّم وكأنها القول الفصل والحق المطلق، في صورة نقد سياسي عام طافح بالكلام السياسي المجرد العمومي في صورة خطاب سياسي هجومي على هذه الفكرة أو تلك القضية.
وفي مقامنا هذا، الإسراف والإفراط في القذع والذم على الفكرة الاشتراكية وعلى التجربة الاشتراكية العالمية، وبكلمات وتعبيرات لا تدل على معرفة بما يُودّ نقده، فقط تكرار لكلام سياسي أجوف فارغ من المعنى، ويفتقر لأدنى شروط الكتابة والبحث الموضوعيين، وبدون منهج في الكتابة وفي أدب نقد الآخر.
وكأن النقد المعرفي والفكري والسياسي عند البعض يقف عند حدود سقف الذم والقدح وتسفيه الرؤى والأفكار والتجارب السياسية المغايرة لأهوائنا الأيديولوجية والسياسية، فكل ما لا يتفق مع رؤانا يكفي شطبه ومحوه من الفكر ومن السياسة ومن التاريخ، بجرة قلم.. بجملة سياسية فارغة من المعنى، يراها البعض هي الحقيقة المطلقة كما تتراءى للأيديولوجية العصبوية التي رأيتها تنضح في مقالة الأستاذ أحمد جحاف.
وهنا أجد نفسي في سياق هذه الملاحظات الاعتراضية مضطرًا لإيراد فقرات مختلفة مقتبسة مما أورده جحاف حتى يكون القارئ على بيّنة مما أكتب، وحول ماذا أكتب وأناقش معقبًا.
ولذلك ستجدوني أقدّم وأعرض الأمثلة كتابةً غير منقوصة أمامكم وبين أيديكم لمن ليس لديه الوقت للعودة لمادة الأستاذ جحاف، وهي التي وردت في صورة بعض الأطروحات الكلامية السياسية، ضعيفة الصلة بالمعرفة التاريخية وبالمفاهيم والأفكار، وهو ما يحد من مساحة القراءة العقلانية النقدية في تناول الموضوع المطلوب تشريحه نقديًا، أيًّا كان هذا الموضوع ثورة 14 أكتوبر 1963م أو غير ذلك.
لأن مثل هكذا سردية سياسية تقول كما ترى وتتصور كل شيء، وهي في الحقيقة والواقع لا تقول شيئًا له معنى في واقع النقد المعرفي والفكري والسياسي.
أولاً: عقلية “المركز” الأيديولوجية العصبوية:
وهنا أجدني أُفرّق بين “المركز” وبين “المركزية”، حيث المركزية بدلالاتها المعرفية والسياسية المؤسسية هي رؤية وفكرة أيديولوجية/سياسية ومؤسسية معاصرة تشير إلى الدولة السياسية القانونية المركزية الحديثة، التي لم يعرفها تاريخ اليمن القديم، ولا تاريخ الإمامة السياسي، إلا باعتبارها غلبة وتغلبًا ووحدة بالقوة باسم “الحق الإلهي” أو على طريقة التوحيدات القبلية العسكرية التاريخية، حيث يقف على رأس “المركز” الإمام الفرد بعصبيته المذهبية الطائفية الخاصة، أو الملك والسلطان بعصبيته السياسية، أي بدون نص ديني يكرّس فكرة “الحق الإلهي” بنص خفي أو معلن.
حيث الدولة، بل وحتى النظام السياسي، مختزلان في المركز/الإمام الفرد بعصبيته، في صورة الإمام أو الملك كليّ القدرة والجبروت.. الإمام المحمول بعصبية معينة تحميه وتسنده.. الإمام واجب الطاعة، حيث السلطة والدولة واحدة من تمظهراتهما السياسية والمادية والاجتماعية على الأرض.
ولذلك وقفت ضد دخولنا إلى مشروع الدولة المركزية والمؤسسية الحديثة “الجمهورية” جميع رموز وقوى الدولة العميقة التاريخية، التي ما تزال حاضرة وقائمة ومتحكمة بحاضرنا تحت وخلف شعارات جمهورية، من خلال حالة “ورثة الإمامة” الجدد “الأرستقراطية المشيخية القبلية”، التي تاجر قسم كبير منهم بالحرب ضد الجمهورية ومع الملكية والسعودية، وهي واحدة من معوقات انتقالنا لمرحلة بناء الدولة الحديثة حتى اليوم.
لأننا حقيقة لم نغادر الماضي حتى اللحظة، وصدق شاعر اليمن الكبير عبدالله البردوني الذي قال شعراً:
“لماذا الذي كان ما زال يأتي/ لأن الذي سوف يأتي ذهب”
حيث هو – الماضي – دائمًا من يقتحم راهننا، من يعود إلينا في أثواب أيديولوجية وسياسية جديدة في الشكل قديمة في المضمون، تحركه وتتحكم به المنظومة الأيديولوجية القديمة بكل تلاوينها في السياسة والثقافة، وفي الاجتماع، وفي نظام الحكم.
حيث منظومة ثقافة “السيد” و”الرعوي” هي التي ما تزال قائمة، غابت أو توارت وتراجعت الإمامة للخلف قليلًا لنجد أنفسنا في مواجهة عنيفة وحادة مع “ورثة الإمامة الجدد”، الشيخ القبلي/ رئيس الشيخ، وشيخ الرئيس حسب تعبير أحد المشائخ الكبار.
ألم يقل الشيخ حسين الأحمر الابن في مقابلة تلفزيونية مع “قناة الجزيرة”: نحن من يصنع الرؤساء اليوم؟ كما كانوا في الفترة الإمامية عونًا لهذا الإمام ضد الآخر، وهي ما أسميها “ثنائية الإمامة والمشيخة القبلية” في التاريخ السياسي اليمني.
ومن هنا استمرار حضور حالة أو ظاهرة “المركز” و”الفردية” و”العصبية” حتى في النسق الجمهوري الجديد، الذي لم يقطع حبل السُّرّة بمنظومة الإمامة التاريخية، بل وبكل تاريخ ثقافة الاستبداد كرؤية وثقافة.
هي حقًا معركة أيديولوجية سياسية عميقة وتاريخية ستأخذ مداها في الزمن التاريخي.
فلا يعني قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م أننا دخلنا دفعة واحدة إلى فضاء المعرفة والفكرة الجمهورية، فما تزال منظومة الإمامة الأيديولوجية والسياسية التاريخية بتحويراتها الجمهورية الجديدة “الجملكية” هي الفاعلة والقائمة، وإلا كيف نفهم ونفسر بروز وصعود الظاهرة الحوثية “أنصار الله” في تاريخنا المعاصر؟
فما تزال – مع الأسف – ثقافة السيد والرعوي هي المهيمنة والغالبة، ولو من وراء أحجية وأستار كثيفة مختلفة، على المنظومة الفكرية والسياسية السائدة، تحت اسم وشعار الجمهورية، وتحت توصيفات وتسميات “دولة القبلية” و”الجمهورية القبلية” بعد أن صعدت المشيخة القبلية إلى قمة السلطة السياسية “القبيلة السياسية”.
وهي واحدة من معوقات التحول اليوم للجمهورية في شمال البلاد بدرجة أساسية.
ألم تكن فكرة “توريث الجمهورية” في زمن علي عبدالله صالح “الجمهورية الوراثية” واحدة من العلامات على ذلك التعويق للدخول إلى العصر الجمهوري الحقيقي؟
لأن الجمهورية ليست مجرد كلمة أو شعار يُردد في النشيد الوطني – على أهمية ذلك – بل رؤية ومنظومة معرفية وفلسفية وفكرية وسياسية وثقافية، ونظام حياة.
حين كان علي عبدالله صالح يفكر بالوحدة، كان يفكر فيها ضمن عقلية ومنظومة التوحيدات العسكرية القبلية والطائفية والعصبوية “توحيد المتوكل على الله إسماعيل”، التوحيد والوحدة بالتغلب، التي يقف على رأسها زعيم “المركز” الجمهوري أو الإمام الذي يقف بالحق الإلهي على سدة “المركز”، وليس رئيسًا معاصرًا لدولة مركزية حديثة تفهم معنى السياسة وتمارسها بشكلها ومضمونها الحديث.
ومن هنا قول المرشح الرئاسي الجنوبي لرئاسة الجمهورية عن اللقاء المشترك فيصل بن شملان:
“نريد رئيسًا لليمن، وليس يمناً للرئيس.”
وهنا يكمن الفارق النوعي بين فيصل بن شملان الرئيس المدني الديمقراطي الحديث الذي يحلم بالمواطنة للجميع، وبين الفرد العصبوي الذي يجمع في داخله روحية ونفسية العسكري البليد “العكفي”، والقبيلي.
الرئيس الذي يوظف القبيلة ضد الدولة التي يقف على رأسها ما دام ذلك يخدم بقاءه واستمراره، ويستخدم الطائفية ضد وحدة المجتمع الثقافية والوطنية.
ونموذج ذلك البارز في تاريخنا السياسي المعاصر هو علي عبدالله صالح على وجه الخصوص، الرئيس الذي ذهب لإنتاج “حرب أهلية” كاملة الأوصاف لأول مرة في تاريخنا المعاصر، كي يستمر في الحكم.
قبل خمس عشرة سنة دوّنت في كتابي: “الحضور التاريخي وخصوصيته في اليمن…” التالي:
“هناك من لا يزال حتى اليوم يجترّ ثقافة الإمامة في نظرتها للحوار، وفي نظرتها لمعنى الشعب، والوحدة، والدولة (…) حيث نرى البعض ما يزال مقيماً في الماضي، ومغلقًا أفق الحوار عند اللحظة الإمامية التاريخية، أو في أحسن الأحوال عند لحظة الجمهورية القبلية، ولم يدرك أننا أمام مرحلة سياسية نوعية تاريخية جديدة – مرحلة ثورة مستمرة – على كل مصاعبها وتحدياتها – تتطلب تعاطيًا إبداعيًا نقديًا، على قاعدة وطنية ديمقراطية جديدة، تساهم في تفكيك بنية وبيئة الاستبداد الثلاثية التاريخية: الفردية، والعصبية، والمركزية المتخلفة (المشيخة القبلية والعسكرية)، التي ما تزال تفرض حضورها التاريخي الكئيب على الواقع وعلى المستقبل في محاولة لإعادة إنتاج شروط الاستبداد التاريخية.” (1)
إن الاستبداد في السياسة، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السلطة، وفي مفهوم البعض للوحدة اليمنية ما يزال محكومًا بعقلية وأيديولوجية “المركز” و”العصبية” كما هي في فكر وتفكير الأستاذ أحمد جحاف.
فهو على سبيل المثال يكتب بوعي أيديولوجي سياسي تاريخي تحكمه عقلية “الضم والإلحاق” التالي:
“ثورة 14 أكتوبر 1963م، الفتية، الابنة الجميلة الفاتنة لثورة 26 سبتمبر المجيدة، بقيادة البطل راجح بن غالب لبوزة (…). مستطردًا القول: وطبيعي، وحسب رأيي، تكون تلك الدولة تجسيدًا لمبادئ الثورة الأم 26 سبتمبر.”
الاعتراض الفكري والسياسي النقدي التاريخي على النص الذي أوردناه، وعلى غيره مما سيأتي في سياق الاقتباس من مقالة الأستاذ جحاف، هو أننا أمام غزل سياسي غير وطني وغير وحدوي، وغير واقعي ومتناقض لحقائق السياسة والاجتماع والتاريخ، هو مدح على طريقة الذم، لأنها دعوة سياسية واضحة “للضم والإلحاق”.
في البداية علينا الاعتراف والإقرار أن جهات اليمن: شمال، وجنوب، وشرق، وغرب، جميعها جهات جغرافية معًا، هي من تشكل صورة ولوحة معنى اليمن كجغرافيا، وديموغرافيا، وتاريخ، وليس هناك من فضل أو تقدم لجهة على أخرى.
ولا صحة واقعية ولا تاريخية في حديث البعض عن الثورة “الأم” والثورة “البنت”، أو “الأخ الأصغر”، لأن ذلك ينطوي على حديث أيديولوجي/سياسي استبدادي “بطريركي”. هذا في أحسن الأحوال خطاب يستدعي في داخله ضمنيًا الدعوة لفرض الوحدة بالدم وبالحرب للوصول إلى حالة “الضم والإلحاق”، وهي واحدة من تداعيات تلك الفكرة الاستبدادية التاريخية في واقع الممارسة، الذي جعل البعض يتحدث خطأ عن أن شمال الإمامة التاريخي هو اليمن، أو هو “الأصل”، والجنوب تحت الهيمنة الاستعمارية هو “الفرع” الذي يجب أن يعود إلى “الأصل التاريخي” أو إلى “الأم”، وهي سردية سياسية عجيبة لا صلة لها بالفكر ولا بالواقع ولا بالتاريخ.
هناك في تاريخنا السياسي المعاصر ثورتان يمنيتان: ثورة 26 سبتمبر 1962م ضد الإمامة الثيوقراطية “القروسطية” التي لم تدخل إلى العصر، وكانت ما تزال تعيش حسب أمين الريحاني في القرن الثالث الهجري. ثورة 26 سبتمبر 1962م لها شروطها السياسية والاجتماعية والتاريخية، لها طبيعتها الخاصة السياسية والوطنية، ولها قواها المحركة السياسية والاجتماعية والطبقية، هي ثورة ضد الاستبداد الإمامي التاريخي.
وفي المقابل هناك ثورة 14 أكتوبر 1963م ضد الاستعمار البريطاني، لها ظروفها وشروطها السياسية والتاريخية، ولها برنامجها السياسي والكفاحي والوطني الخاص بها، ولكل ثورة أهدافها السياسية والوطنية والاجتماعية الخاصة بها، لاختلاف المهام والبرامج والشروط الذاتية والموضوعية لكل منهما عن الأخرى، وهذا لا ينفي الوحدة والعلاقة السياسية والوطنية الجدلية فيما بينهما في مجرى الصراع السياسي من أجل إسقاط الإمامة الثيوقراطية “الطائفية/السلالية”، وإقامة نظام مواطنة جمهوري جديد.
في الجنوب، المهمة المركزية هي النضال ضد الاستعمار البريطاني، ونيل الاستقلال الوطني الكامل والناجز، وتأسيس الدولة الوطنية اليمنية الجنوبية الواحدة، وهو ما أنجزته الجبهة القومية لأول مرة في تاريخ اليمن الجنوبي بعد إنجازها تحقيق الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م.
ومن هنا صعوبة فهم الحديث الذي ذهب إليه الأستاذ جحاف وغيره في قوله: “أن ثورة 14 أكتوبر 1963م تجسيد حي لمبادئ الثورة الأم 26 سبتمبر”.
إن مبادئ وأهداف ثورة 14 أكتوبر 1963م، كما هي واردة ومتضمنة في ميثاق الجبهة القومية 1965م، وفي مختلف الأدبيات الأيديولوجية والسياسية للجبهة، مختلفة إن لم تكن مناقضة للأهداف السياسية الكفاحية المباشرة لثورة 26 سبتمبر 1962م، حيث المهام السياسية المباشرة لكل منهما مختلفة عن الأخرى، ولكن أيديولوجية “المركز” و”العصبية” و”الفردية” المهيمنة على عقل ومنطق تفكير الأستاذ جحاف هي من صورت له ذلك الوهم السائد في تفكير وعقل البعض وقادته لكتابة ذلك القول وتكراره بصور أخرى في مواضع مختلفة من تلك المقالة.
إن حديث البعض ومنهم الأستاذ جحاف عن “الثورة الأم” إنما يعكس استمرار حضور وهيمنة العقلية والأيديولوجية الشمولية التاريخية الإمامية والقبلية في النظرة إلى الآخر الوطني اليمني، في صورة “السيد والرعوي”، حيث السيد هو “الأصل” والرعوي هو “الفرع”.
ثورة 26 سبتمبر 1962م هي “الأم”، وثورة 14 أكتوبر 1963م هي “البنت”، أو في أحسن الأحوال “الوالد العاق” أو “الضائع” الذي عليه العودة إلى حضن الأب أو الأم، وهو ما روج له بعد الثورة الخطاب السياسي العسكري والقبلي المشيخي في شمال البلاد.
وليس مطالبة البعض بالوحدة الفورية بعد استقلال الجنوب مباشرة مع نظام الشمال الذي تم فيه الانقلاب على جمهورية سبتمبر الأولى بانقلاب الخامس من نوفمبر 1967م، إنما هي محاولة مبكرة خجولة لفرض تطبيق شعار عودة “الفرع” إلى “الأصل”، أي عودة الابن الضال إلى حضن أمه، وقد وجه الأستاذ جحاف نقده للجبهة القومية لعدم ذهابها بعد الاستقلال للوحدة مع الشمال السياسي الذي انقلب على المضمون السياسي والاجتماعي والاقتصادي والوطني لثورة 26 سبتمبر 1962م.
فهو يشير تحت مبدأ السلبيات، و”محليًا”، إلى “تأخير تحقيق الوحدة اليمنية من (63م إلى 90م)”. طبعًا في العام 1963م لم تكن الجبهة القومية قد استلمت السلطة، ويمكن أنه يقصد من الفترة (67م إلى 1990م)، وهي منه دعوة للوحدة الفورية الاندماجية التي لم تنجح في وحدة العام 1990م. فكيف بنا والدعوة مجددًا لتحقيقها الفوري بعد أكثر من ربع قرن من ذلك الفشل الذريع لتحقيق الوحدة، وهي محاولة لتحميل الجبهة القومية مسؤولية عدم تحقيق الوحدة في ذلك الحين، أي بعد الاستقلال مباشرة، أي واقعياً وحدة غير ممكنة سياسيًا ولا عمليًا بين نظام انقلب على ثورة 26 سبتمبر 1962م وذهب للارتباط بالسعودية، وبين نظام في توجهه الأيديولوجي والسياسي معاد للاستعمار وللرجعية، وتحديدًا للسعودية، التي كانت وما زالت حتى ذلك الحين، بل وحتى اليوم، تناصب اليمن شعبًا ودولة الكراهية والعداء، ولا تتمنى له الخير والسلام والاستقرار والتنمية، لأنها ترى أن ذلك يتم ويتحقق على حسابها. هي عقدة سعودية تاريخية لا صلة لها بالحقيقة ولا بالواقع ولا بالمستقبل.
إنه العقل الأيديولوجي والسياسي الإمامي والمشائخي القبلي والديني السياسي، “الوهابية السياسية”، الذي لا تهمه من الوحدة على أي مستوى كان إلا الربح الذاتي الخاص، أي إلا إذا كان في تلك الوحدة مكسب سياسي خاص (صغير وعاجل)، مكسب سياسي أو مالي خاص بمن يقف/يقفون على رأس البناء الفوقي السلطوي، ولا علاقة لها بتنمية المجتمع، والبنية التحتية المادية والاقتصادية للمجتمع وللدولة.
وإلا كيف نفهم ونفسر توجه علي عبدالله صالح إلى محاولته هندسة البنية السياسية والسلطة ومؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والأمن والاستخبارات على أساس بناء “جمهورية وراثية” خاصة به وأسرته، ثم بالأتباع الذين كانوا يبررون ويشرعون تلك الإجراءات، حتى وصلت برئيس البرلمان التابع له للمطالبة العلنية بـ”قلع العداد”!!
وهذه الخلفية السياسية والواقعية هي من شجعت الحوثي “أنصار الله” للتفكير بالعودة إلى السلطة، وتحالفه الاستراتيجي معهم انتقامًا من شباب الثورة، وهو ما قاده إلى تلك النهاية المستحقة بجدارة.
كل الوحدات والتوحيدات في التاريخ السياسي العالمي القديم اعتمدت وقامت على وحدة الغلبة، والتوحيد بالحرب، وهي عمليات سياسية مفهومة تاريخيًا، وهي قطعًا لا صلة لها بالوحدة الديمقراطية والتعددية على طريق إنتاج دولة حرية وعدالة ومواطنة، ولذلك انقلب علي عبدالله صالح على الوحدة السلمية الديمقراطية “الهامش الديمقراطي”، ليعود إلى إنتاج الوحدة بالدم والحرب، الوحدة التي تشبهه، ضِدًّا على وحدة 22 مايو 1990م السلمية والمدنية والديمقراطية، وهي الوحدة التي تم التأمر عليها من قبل أن يكتمل العام الأول لمناسبة قيامها، وهو ما سبق أن حذرت منه تقارير وتحليلات استراتيجية استخبارية ألمانية.
الخطأ ليس في الوحدة كفكرة وقضية وطنية يمنية تاريخية مشروعة، بل يقع على من أخذته عواطفه الوطنية والثورية الوحدوية، وتفكيره الرومانسي الوطني والثوري بالوحدة للموافقة بل والاستعجال في الموافقة على إتمام الوحدة بتلك الصورة والطريقة العجولة المتسرعة، وهو ما ينطبق عليه القول أو المثل القائل:
“من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه”، وهي النتيجة الواقعية والمنطقية والتاريخية لمثل هذه الوحدة الفورية والاندماجية، وهي ما يطالب ناقدًا ولائمًا اليوم – الأستاذ جحاف – الجبهة القومية بأثر رجعي بعدم تحقيقها الوحدة بعد نيل الاستقلال الوطني، غير مستوعب إلى المآل المأساوي الذي قادتنا إليه الوحدة الفورية الاندماجية، والتي أوصلت قطاعًا واسعًا من سكان جنوب اليمن إلى إنكار هويتهم اليمنية التاريخية كرد فعل على ما جرى بعد وخلال حرب “الفيد والغنيمة” للجنوب في العام 1994م.
إلى الحلقة الثانية.
الهوامش:
1- قادري أحمد حيدر: الحضور التاريخي وخصوصيته في اليمن، قضايا سيويولوجية وسياسية، تاريخية، إشكالية، إصدار مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، ط(1)، 2012م، ص58.