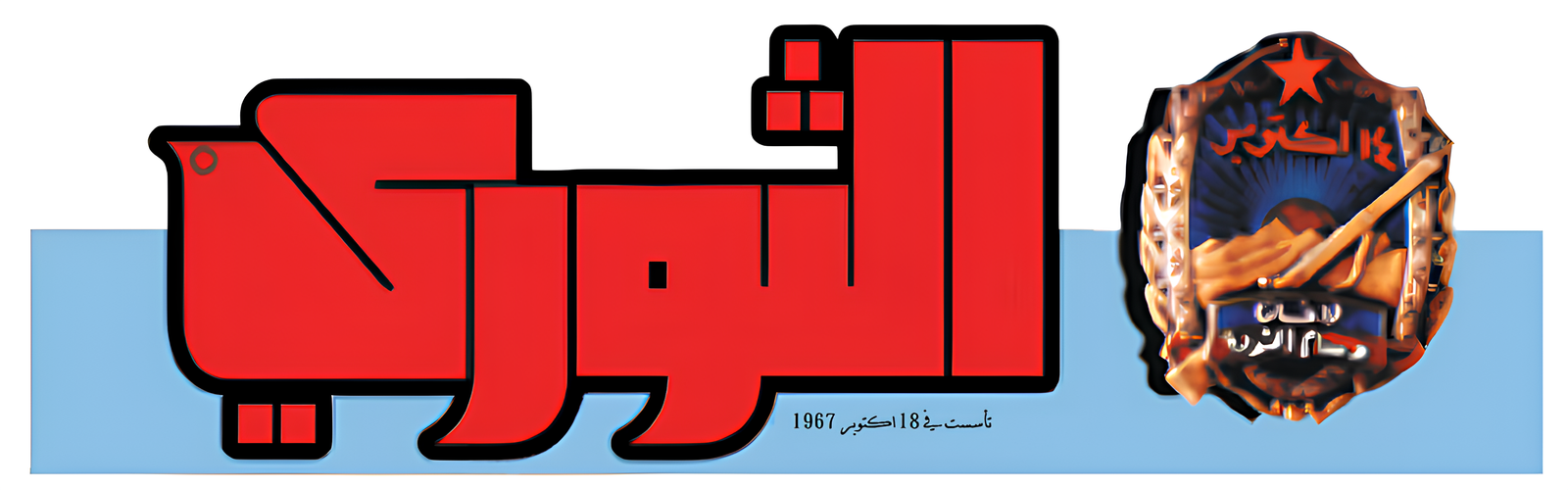“صحيفة الثوري” – ثقافة وفكر:
نور السيباني
حين تقرأ عنوانًا مثل “الحمار الحائز على وسام الجمهوريّة”، تبتسم ساخرًا، ثم تقف مشدوهًا أمام السؤال الأبسط والأكثر تعقيدًا: هل هذه حقيقة؟
لكنّ باوزير، بحسّه الساخر المجرّب، لم يكن يروي نكتة. كان يكتب تاريخًا مُقنّعًا بالأضاحيك، وينحت في وجه الزمن مرآةً لكلّ ما يمكن أن يحدث حين تُقلّد الأوسمة بغير أهلها، وحين يصير الحمار أنسب للبطولة من بعض من يدّعونها.
في هذا المقال، نغوص في سردية من أغرب ما كُتب في الأدب اليمني الساخر، نلامس فيها هشاشة الواقع، ومرارة الخديعة، وفخامة العبث حين يُسوّق كحقيقة.
إنها حكاية وسام، وبحث، وحمار.. لكنها في الحقيقة حكايتنا جميعًا.
ما الذي يجعل حكاية كهذه تتسلّل إلى قلب الأدب، وتغدو رمزًا لكل ما هو مختلّ، وكل ما هو ساخر؟
الهزل الجاد: حين يصير الضحك قناعًا للوجع
حين نقرأ قصّة “الحمار الحائز على وسام الجمهوريّة”، لا نبحث عن الضحك قدر بحثنا عن الإجابة: ما الذي يجعل العبث يبدو طبيعيًا؟
فالقصة التي كتبها عبدالله سالم باوزير زلزال ناعم في بنية الوعي. تبدأ حكايتها من مقلب شخصيّ: كاتب يتلقّى خبرًا مفرحًا بأنه حاز على وسام الدولة، بناءً على خبر منشور في صحيفة رسمية. يشدّ رحاله إلى عدن بخفة الأمل، فلا يجد شيئًا سوى الخيبة، ليكتشف لاحقًا أن «الوسام» كان فخًّا ساخرًا، وعبثًا إعلاميًا، ليس المقصود به إلا الإمعان في العبث نفسه.
من هذه الحادثة تبدأ القصّة، تتوسّع، تنفجر رمزيًّا، وتفتح الباب لطرح سؤال حرج: من يستحق الأوسمة في زمنٍ مقلوب؟
الجواب سيأتي ساخرًا: ليس المناضل، ولا الكاتب، بل الحمار.
قد يبدو الأدب الساخر في ظاهره لعبة لغوية، أو ترفًا أدبيًا للضحك على الواقع، لكنه في حقيقته — كما يتجلى عند باوزير — نوع من أكثر أنواع الكتابة جدّية وخطورة.
الهزل هنا سكين حادة تُسلّط على عنق الزيف السياسي والاجتماعي، سكين لا تقطع الرأس بل تكشفه.
فأن يُنسب النضال لحمار، وأن يُتداول الوسام كما تُتداول النكات في مجالس المقاهي، هو إدانة عميقة لنظام فقد البوصلة: لا يعرف أين يضع الشرف، ولا مَن يستحق التكريم.
القصة تهزأ من الأوسمة، لا من الحمار. تهزأ من لجان تعيد كتابة التاريخ بمزاج بيروقراطي، وتسند البطولة إلى من لم يمشِ خطوة واحدة في اتجاهها.
هذا النوع من الأدب يُعرّي السلطة من جمودها، والمؤسسة من طقوسها الفارغة، ويعيد للناس لذّة الاستخفاف بما فُرض عليهم أن يهابوه.
وفي ذلك الهزل، تكمن جدّية النقد، حين تُقال الأشياء الخطيرة بطريقة تضحك السطحيّ، وتوقظ العميق.
السخرية التي ينتهجها باوزير هنا ليست تمردًا لغويًا فحسب، هي موقف وجودي في وجه العبث، ووسيلة بليغة لكشف اللامعقول في المجتمعات، حين تتسوّد النياشين صدورًا خاوية، ويُنسى الذين حملوا أثقال الوطن على ظهورهم دون ضجيج.
المفارقة المؤلمة: حين يتقدّم الحمار الصفّ
تحكي القصة عن طالب يمنيّ في موسكو، وُصف بأنه مناضل جسور، وقيل إنه شارك في الثورة منذ نعومة أظفاره، وأنه، رغم عمره الصغير، صعد الجبال في آخر سنوات النضال يحمل الماء للمجاهدين. لكن المفارقة أن الطفل كان في السابعة، والماء الذي حمله لم يكن على ظهره، بل على ظهر الحمار.
وهكذا يبدأ السؤال المفصلي: من الذي ناضل فعلًا؟ الطفل أم الحمار؟
تنعقد لجنة رسمية في صنعاء لتبتّ بالأمر، وتقرّر أن الحمار هو الأحقّ.
تبدأ رحلة البحث عن الحمار، ليُكتشف أنه مات أثناء أداء «واجبه الثوري»، حين أصابته قذيفة وهو ينقل سلاحًا على ظهره للمقاتلين.
هل من بديل؟ يسأل أحدهم، فيجيب شيخٌ من القرية: للحمار أخ من الرضاعة!
في نهاية المطاف، يُعثر على الحمار الأخ، ويُقلّد في احتفال رسمي وسامًا كان من المفترض أن يُمنح لمناضلين حقيقيين ماتوا دون أن تُذكر أسماؤهم.
في قلب القصة التي كتبها باوزير، لا يكمن السؤال في كيفيّة نيل الحمار لوسام الجمهورية، بقدر النَّظر في لماذا تبدو هذه المفارقة ممكنة ومُقنعة إلى حدّ التهكّم.
أن يتلقّى حمار وسامًا رسميًا بينما يُستبعد مناضلون حقيقيّون، تشخيص دقيق لنظام مُختلّ المعايير، تُمنح فيه الأوسمة على أساس الارتباط، أو الظرف، أو حتى الخطأ الطباعي!
يتحول الوسام في هذه القصة من رمز للتقدير إلى بضاعة عبثية، تُقلَّد على أجساد لا تفهم معناها، أو تُستبدل حسب الحاجة بروح أقرب إلى النكتة السوداء منها إلى الجدارة.
إن الطفل الذي أُقحم في الرواية الرسمية للمقاومة، ثم استُبدلت بطولته ـ حرفيًا ـ بـ”الحمار الذي حمل الماء”، يعري تناقضًا عميقًا في تصوّر السلطة للبطولة.
ففي المجتمعات التي لا تُفرّق بين مجهود حقيقي وصدفة دعائية، يصبح الحمار أكثر استحقاقًا من الإنسان، لأن دوره ـ ببساطة ـ وُثِّق ولم يُناقَش!
الفكرة أن الحيوان هنا لم يسخر منه، بل أُعلي شأنه على سبيل الإدانة لمن أهمل الإنسان.
الحمار في هذا النص ليس بطلًا ساخرًا، بل مرآة مروّعة لما آل إليه فهمنا للقيمة، والتاريخ، والذاكرة.
حين توضع الأوسمة على ظهور من لم يعرفوا إلا الطاعة، تُصبح البطولة شكلًا من أشكال الانصياع، ويغدو التكريم مشهدًا كوميديًا يُضحكنا فقط لأن البكاء عليه قد استُنفد.
تسخيف الجدارة: الأوسمة حين تفقد معناها
تسير القصة بخفة تشبه مشية مهرّج في عرض مسرحي، لكنها – بخلاف ما يبدو – تنهش المعنى من داخله. فأن يُبحث عن “قريب من الرضاعة” لحمارٍ شهيد كي يُقلَّد الوسام، تشريح علني لما يحدث حين تُفرغ الرموز من دلالاتها، وتتحول قيم التضحية والبطولة إلى مادّة بروتوكولية تُدار بالورق والأختام.
هذه القصّة وثيقة نقد، وفنّ مُحمّل بالقهر والتأمل.
عبدالله باوزير، بقلمه الساخر، كان يعري بنيةً كاملة من الزيف السياسي، والمحسوبيات، والرمزية الخاوية.
في وطنٍ تتبدّل فيه المعايير، وتُنسى التضحيات، ويُرفَع الجهل فوق العقل، تبدو هذه القصة كصفعة أدبية ناعمة تقول للقارئ: انتبه، ربما يكون الحمار أكثر جدارة منك في وطنٍ كهذا.
سرد باوزير حكايته بلغة خفيفة لكنها مشبعة بالمرارة. لا يهاجم أحدًا مباشرة، لكنه يفضح الجميع. يزرع السخرية كأداة للمقاومة، ويجعل من الأدب مرآةً للواقع حين يعجز الواقع عن أن يكون مرآة لنفسه.
في هذا السياق، يتقمص الحمار دور “البديل”، ذلك الكائن الذي يسهل تحميله فوق ما يحتمل، لأن لا أحد سيناقش صلاحيته. وهل ثمّة من سيعترض على وسامٍ يُهدى لحمار؟!
بهذه البساطة، يُزاح الإنسان إلى الهامش، بينما يُملأ الفراغ الرمزي بما هو غير متوقع وغير لائق، في محاولة لتسكين العار بمنحه غطاءً من الطرافة والعبث.
باوزير يسرد مأساة بهيئة طرفة. طرفة تسخر من مجتمعٍ يُكرّم ظلّ البطولة وينسى أصحابها، يُزيّن الخسارة بوشاح النصر، ويقيس الكرامة بعدد المراسم لا عمق المواقف.
كل ما في القصة يدفع القارئ للسؤال:
ما معنى التقدير إذا كان يُوزَّع وفق المزاج؟
ما جدوى الوسام إذا كان يُعلّق على جدار النسيان لا على صدر المُستحق؟
عند هذا الحدّ، لا تعود القصة عن حمار، بل عن خيانة عميقة للمعنى.
خيانة تُمارس يوميًا حين تُهمل الأصوات الحقيقية، ويُصمَتُ عنها، بينما تُرفع الشعارات فوق أجساد لم تطلبها.
الخاتمة:
ولأن الأدب يقول الحقيقة كما تُوجع، جاءت القصة كمحاكاة خفية لما هو أكبر من ضحكة، وأعمق من هزّة كتف.
فيها نكتشف أن الوسام ليس في الرقبة التي تُعلَّق عليه، بل في القيمة التي يحملها.
وفيها نُسأل دون إجابة: كم من «حمار» يتقلّد اليوم أوسمة في العالم العربي، فيما الأبطال الحقيقيون يموتون دون قبر، ودون حتى اسم؟
إن السخرية، حين تُكتب بماءٍ حارقٍ كقلم باوزير، لا تكون ملهاة.. بل وسيلة لفهم عطبٍ لا نزال نحياه.