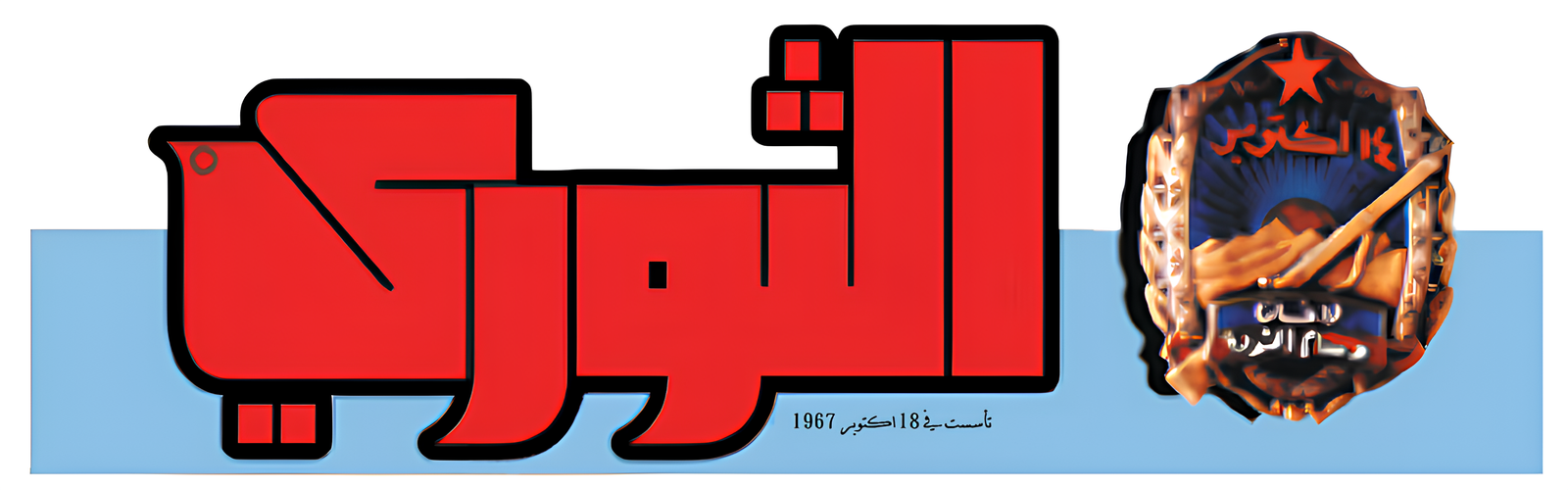“صحيفة الثوري” – ثقافة وفكر:
ريان الشيباني
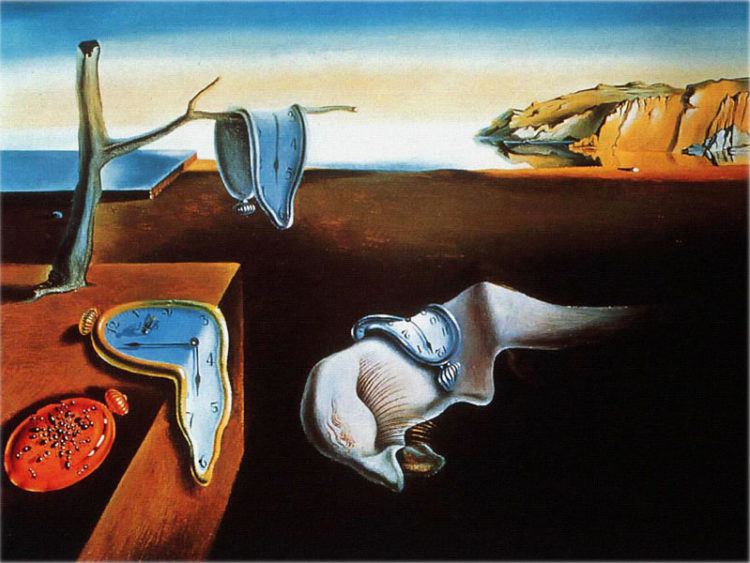
صباح الخير!
علقتُ الأسبوع الماضي في كتاب ببغاء فلوبير للمؤلف الإنجليزي غوليان بارنز. دفعني لقراءته رواية ضجيج العصر، للمؤلف نفسه، والتي تحكي قصة الموسيقار الروسي ديمتري شوستاكوفيتش مع ستالين، بعد أن تولى الأخير متخفيًا حضور حفلة موسيقية للأول، ولأنها لم تعجبه، هاجمها باسم مستعار في الصحيفة الرسمية، ما قلب حياة الموسيقار رأسًا على عقب. لكن على عكس توقعاتي، لم أعثر في كتاب (الببغاء) على شيء. فهو مثله مثل كثير من الكتب المترجمة غامض وغيرمفهوم، ما دفعني انتقامًا لرميه والشروع في كتاب لمؤلف عربي.
من فترة طويلة وأنا أشعر بالذنب تجاه الكتب العربية التي أعيش قطيعة غير مبررة معها. ولأن الكتب المترجمة، أكسبتني نقيصة عقلية، بتغيير مسارات القراءة فيه من اليسار إلى اليمين، أردت قلب نظام المسألة بقراءة أول كتاب عربي تقع مصادفتي عليه؛ فكان (ماذا علمتني الحياة؟) للمفكر الاقتصادي المصري جلال أمين العالِم، والصادر عن دار الشروق.
لا أستطيع أن ألخص فكرة الكتاب، لأنه سيرة ذاتية، ومن شأنه تناول مواضيع وتأملات عديدة في الحياة. لكن سأضيئ على جملة من الاقتباسات في عدد اليوم من الرّف، وفي هذه المقالة، سأكتفي بطرق موقف، وجدته مثير للاهتمام في الكتاب، ويعبر عن الواقع المُعاش؛ وأقصد بذلك مسألة الوقوع في منطقة الراحة.
ففي الجزء المتعلق، بسفر المؤلف إلى الكويت، لتولي وظيفة في الصندوق الكويتي للتنمية، وهو أكبر صندوق عربي سيادي في تلك الفترة، لم يبدي جلال أمين أي حماسة لتناول تلك المرحلة، أو لجأ لتناولها على إنها فترة تبلّد. في البداية اعتقدت هذا الأمر نابع من ثقافة الانغلاق والحمائية التي يبديها الخليجيون بحق العمالة الخارجية، أو ما يشاع عن انتهاكات بحقهم، لكن- وللمفاجأة- شرح جلال أمين أسبابًا أخرى لاستهجانه المرحلة الكويتية من حياته.
يقول العالِم إنه وصل على واقع جديد، رأى نفسه فيه يستلم راتبًا كبيرًا مقابل مهام ليست ثقيلة، ويسكن شقة فسيحة كل ما فيها فخم ومريح، ويستلم سيارة فاخرة لم يكن يحلم بها يومًا، وهو أمر مدعاة للطمأنينة في العادة، لكن بالنسبة لأكاديمي أتى من مجتمع ندرة، متكالب ومولّد لدوافع التنافسية والإنجاز، أصابته أجواء الراحة الزائدة بنوع من الكمون والتبلد. فتوقف عن ممارسة أنشطة هي في صميم تكوينه، مثل القراءة والكتابة، وكانت الفعالية الوحيدة في حياته متعلقة بحفل عشاء فاخر في الخارج، وعلى أوقات متقاربة.
يتذكّر، جلال العالم، موقفًا رآه يلخص ما يصير إليه الناس في مجتمعات الوفرة، إذ راعه، بعد أيام قليلة من عمله في الصندوق الكويتي، مرور زميله المصري عليه، وهو اقتصادي كبير، وكان يحتل الحجرة المجاورة له، وقال له، وهو بمنتهى الجدية، وكأنه يناقش معه مسألة على مستوى عالي من الخطورة والجدية، مشيرًا إلى إناء نحاسي كبير موضوع على الأرض بالقرب من المصعد، وفيه نبات أخضر يُسقى وينظف بعناية كل صباح:
“ألا تعتقد يا جلال أن هذا الإناء يكون من الأفضل كثيرًا لو تحرك عشرين أو ثلاثين سنتيمترًا إلى اليمين؟”. يقول جلال العالم إن مصدر رعبه نابع من حالة الفراغ الذهني الذي صار إليه صديقه وزميله، بعد قضائه لأربع سنوات في هذا المكان.
وبعد أشهر من حالة السأم هذه، حصل المؤلف على فرصة زمالة في جامعة أمريكية فقبل عرضهم مباشرة، بالرغم من فارق الدخل. أملًا في إعادة حياته إلى طبيعتها.
جذبني هذا التفصيل إلى مساحته، إذ اختبرت قبل أشهر قليلة ماضية هذه المشاعر، لكن في مجتمع شديد الندرة ومُفقَر. أنا شخص مسكون بالعمل، ولطالما كنت أهرب من أوقات الدوام الرسمي إلى استكشاف مساحات كتابة حرة. ولذا لم يكن من المستغرب أن أنجز كتابة ما أعتبره أصعب أعمالي؛ أي رواية الحقل المحترق، مع أني كنت أنفق النصف الأول منه في الدوام. ولطالما حلمت بإجازة طويلة، أستطيع خلالها، التفرغ للأشياء التي أحبها، ومن ذلك مشاريعي السردية، حتى باغتتني تلك الفرصة فجأة، ودون استئذان.
في نهاية أكتوبر 2023 قدمت استقالتي من عملي، لكن ما تلا ذلك، يمكن تعريفه على أنه سقوط في منطقة إجبارية من الراحة، سكن معها كل شيء. في الأيام الأولى أصبت بحبسة غامضة عن القراءة، أعقبتها أخرى عن الكتابة. كنت أحدق ببله في الأشخاص الذين يعبّرون عن أنفسهم أو ما يجيل بخواطرهم، حتى ولو أربعة أسطر، فأغبطهم على ذلك. وهكذا صار وقت فراغي كله منذور للتساؤل عمّا جرى لي، وقد شهدت في سنوات قليلة، كتابتي لفصل سردي من ١٠ آلاف كلمة، وفي أقل من أسبوع. هل الأمر متعلق بتغير بيولوجي، أم كيميائي عقلي، لا أدري؟!
خلال تلك الأسابيع، اختبرت أساليب متنوعة للتحفيز، منها النهوض في الرابعة فجرًا، والاغتسال بماء يقترب من التجمد، والمشي إلى مسافات تصل إلى سبعة أميال إلى أن أفلح الأمر معي. لا أقول هنا أنني واعٍ على الأسباب التي دفعتني لمغادرة الهاوية، أو مساحة راحتي، لكن لدي القدرة، لكي أشير بخجل، لبعض السلوكيات التي دفعتني إلى منطقة الراحة تلك.
في الأيام الأولى منها، أجبرت نفسي على محاكاة أساليب الكتابة، على النحو التي ترجوه بعض المنصات، لأسدد فواتيري. كنت واقع تحت ضغط الشعور بالحاجة، ما اضطرني إلى أن ألوي عنق اللغة، حتى كسرته على ما يبدو. أو أحدثت في بنيته ضررًا، أفقدته القدرة على الالتفات. معضلة أخرى قد تكون وقفت في الطريق. أقصد الانغمار الشديد في جوانب فنية لها علاقة بعمل دار النشر التي أسستها، ولا تمت للكتابة إلا بصلات لوجستية. فهل يمكن لتصميم الكتب وأغلفتها أن يبني كل تلك القطيعة بيني وبين كلماتي؟!
الشيء الآخر الذي أكن أريد الاعتراف به، هو أنني تجاهلت عروضا للكتابة، من قبل صحف إقليمية في سنوات سابقة، رغم إلحاح بعض القائمين عليها. وفي أوقات الفراغ هذه، وجدتني مضطرًا للعودة، على أن في هذي الخطوة كثير استخفاف من قبلي، يجب أن أتحمل نتائجه. قوبلت هذه العودة، بردود أفعال، اتسمت في أحسن أحوالها بالبرود، وفي أسوأها بالتجاهل. هذا فرض عليّ نقدا ذاتيًا قاسيًا، انعكس على هيئة عدم رغبة بالكتابة.
أكتب هذا من واقع أنني لم أختبر يومًا مثل هذه المشاعر، ولم أكن بوارد- حتى- العثور عليها أو التفكير بها، ولذا لم أتهيأ لها قبلًا. كثيرون منّا، يسعون إلى الأوقات الشاغرة في حياتهم، لأنهم يقطعون الوعود، لتحقيق أنفسهم من خلالها. لكن وكما لو أن الإنسان جُبل على اللحظات القسرية ليجد نفسه فيها، كما لو أننا لم ننصف بعد لحظات الإجبار هذه، على إنها هي من تصنع كينونتنا الحياتية المتسمة بالدأب والإنجاز.
نقلا عن رف الخميس
رابط الاشتراك من هنا