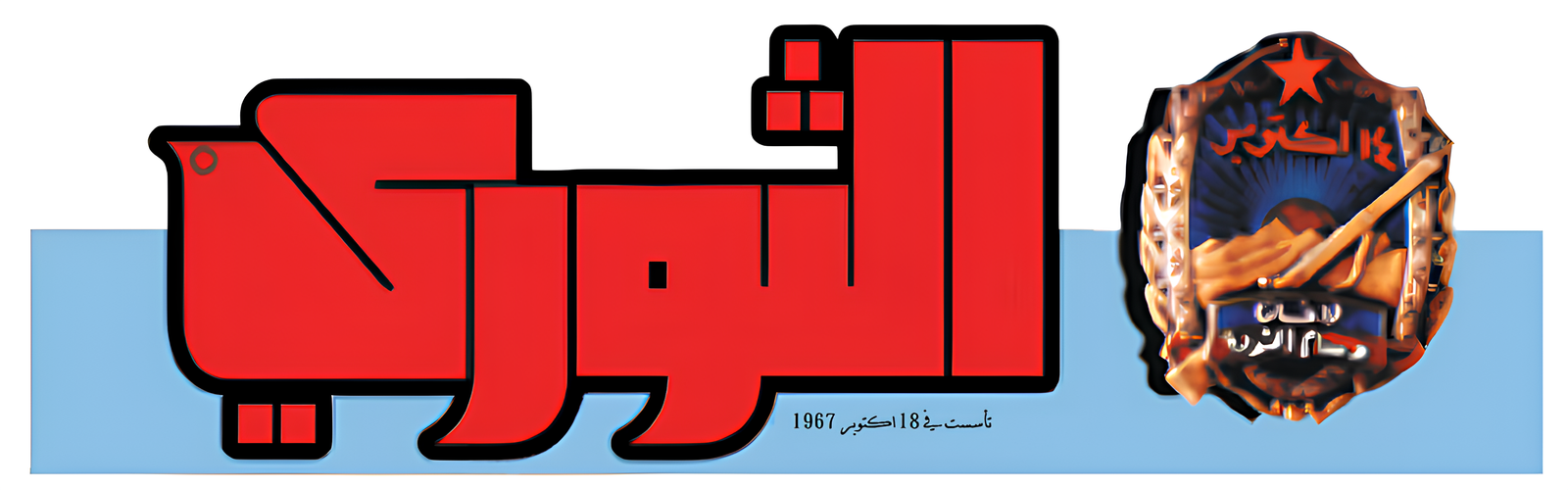صحيفة الثوري – (كتابات):
د. ياسين سعيد نعمان
الإهداء إلى نوفمبر في ذكراه الـ58:
أخذ الرد من قبل الفلاسفة والمفكرين على السؤال المتعلق بعلاقة التاريخ بفعل الإنسان ونتائجه، وما إذا كان هناك تأثير للتاريخ على فعله وسيرورته أم أنه مجرد سجل لهذا الفعل وتلك السيرورة، وقتاً طويلاً، وجهداً فكرياً عميقاً، وجدلاً فلسفياً امتد إلى قلب الإيديولوجيات المختلفة لتبيان تماسك أدلتها العلمية والمعرفية.
ولتوضيح هذه المسألة، لا بد أولاً من الإشارة إلى أن الفعل والنتيجة متلازمان ولكنهما ليسا متناسقين في كل الأحوال. فإذا كان الفعل، كما يعتقد، يجسد إرادة الإنسان، وهو اعتقاد فيه تبسيط للحقيقة التي تذهب إلى القول بأن الفعل تقف وراءه قوة خفية تشتبك مع إرادة الإنسان عند تقاطعات معينة من اتخاذ القرار، فإن النتيجة المتولدة عنه كثيراً ما يتدخل فيها “التاريخ” باعتباره، كما يقول المفكر الألماني الشهير هيجل، ليس مجرد أحداث، وإنما هناك عقل أو منطق داخلي يسميه “العقل الكلي” أو “روح العالم”، وهو الذي يحرك التاريخ خطوة بخطوة إما نحو التقدم أو باتجاه الخراب. وهو ما يسمى “مكر التاريخ” أو “دهاء التاريخ”.
أما مؤسس الفكر الاشتراكي العلمي ماركس، فإنه لم يبتعد كثيراً عن فكرة “مكر التاريخ”. وهو يرى أن التاريخ يخدع كل من يقوم بفعلٍ في الواقع ضمن شروط مادية لا يدركونها، ويلخص المسألة في أن الذي يحرك التاريخ هو الصراع المادي بين الطبقات. ويذهب بفكرته بعيداً عن مثالية هيجل الذي يتمسك بالعقل بعيداً عن تأثير الواقع المادي وتغيراته. فالبرجوازية عندما ثارت ضد الإقطاع لم تكن تعلم أنها تهيئ الظروف لثورة ضدها عن طريق طبقة العمال. لكن “مكر التاريخ”، بمفهوم مشاكس لـ”المادية التاريخية” لصراع الطبقات، لم يتوقف عند ثورة العمال على البرجوازية، فقد استطاعت البرجوازية في البلدان الصناعية الرأسمالية أن تعيد بناء علاقتها بالطبقة العاملة بقواعد ومدخلات وتطبيقات اشتراكية لنظام العمل اشتقتها من النظرية الاشتراكية، إضافة إلى بناء نظام اجتماعي متماسك بتمويل من الضرائب التصاعدية المفروضة على الدخل، وكان هذا نموذجاً آخر من “مكر التاريخ” في مواجهة الرأسمالية للاشتراكية الصاعدة آنذاك وامتصاص الكثير من ديناميتها.
ما المقصود بـ”مكر التاريخ”؟
إن “مكر التاريخ” عند هؤلاء المفكرين هو أن التاريخ يستخدم أفعال البشر، حتى أنانيتهم وأخطاءهم، لتحقيق غايات لم يكونوا يقصدونها. وعبارة “مكر التاريخ” هي من أكثر العبارات الفلسفية المعبرة عن السخرية التي يتعرض لها الإنسان من قبل التاريخ.
ففي الوقت الذي يعتقد فيه الإنسان أنه هو صانع التاريخ، إلا أنه في حقيقته بيدق على رقعة الشطرنج التي يلعبها التاريخ بتفوق. فلطالما استطاع التاريخ عبر القوانين الموضوعية، التي ينتظم في إطارها عمل “العقل الكلي”، وتفاعل المصالح البشرية في الواقع المادي، أن يغير المعادلة، ويقلب الطاولة، ويأتي بالنتائج العكسية لما كان يتوقعه الفاعلون للأحداث الكبرى والصغرى منها على السواء. أي أن للتاريخ عقل يخطط بطريقته الخاصة والمستقلة، وهو مخادع وذكي. تعتقد أنك كسبت المعركة، فإذا به يعيدك إلى مربع الهزيمة بعد فترة من الزمن.
يقول “مكر التاريخ” إن الإنسان، وهو يخوض معاركه الخاصة، لا يدرك أن ذلك يتم في نطاق معركة أكبر لا يعرف أبعادها، وأنها هي التي تقرر في نهاية المطاف النتيجة التي ستنتهي إليها معاركه.
ونستنتج من ذلك أنه إذا توافقت أهداف معاركه مع تلك الأهداف الخفية الكبرى، فإن نتائجها ستدفع الحياة في تقدم إلى الأمام، وإلا فإن النتيجة لن تكون سوى انتكاسة وخسارة، حتى لو بدا أنه انتصر في المعركة. كثيرون انتصروا في المعارك الحربية وفشلوا، بعد ذلك، في إدارة النصر.
يقول هيجل: “إن الناس الذين يعيشون الأحداث لا يعرفون أنهم يخدمون أهدافاً كبرى لا يدركونها، فالتاريخ يستخدمهم بدون ما يشعرون لتحقيق أهدافه الأعمق”.
كثير من الفلاسفة المبشرين بالفكرة يرون أن كثيراً من القادة والزعماء لم يكونوا سوى أداة بيد التاريخ لنشر قيم إنسانية لم تكن حاضرة في أذهانهم وهم يخوضون حروباً خاصة ليحققوا أحلامهم الخاصة. وآخرون على العكس من ذلك، حيث تقدم سرديات التاريخ صوراً لثورات بحثاً عن الحرية بزعامات وطنية ثورية لم تلبث أن تحولوا إلى جلادين وحراس لأنظمة أكثر قمعاً. أو أن قائداً يقرر الحرب لتقوية نفوذه، فيبدأ فور انتصاره بالانهيار بسبب أن الحرب التي قرر أن يخوضها لم تكن في منطق التاريخ الوسيلة المناسبة لتحقيق ذلك الهدف، ويقول “مكر التاريخ” إنه كان عليه أن يبحث عن وسائل أخرى ليتجنب الانهيار.
تجارب تاريخية
في التجارب التاريخية، استعان العباسيون بالفرس والأجناس الأخرى للتغلب وتثبيت دعائم حكمهم. وإلى هنا، لا يبدو أن هناك مشكلة، ذلك أن العباسيين خرجوا بحكمهم من الإطار القومي الذي كان عليه أبناء عمومتهم “الأمويون” إلى الإطار الإسلامي الأوسع دون أن يحسبوا حساب الكلفة التي كان يتوجب على الخلافة دفعها مقابل هذا التحول الكبير والهام، ومن ذلك بالطبع الشراكة في الحكم مع هذه الأقوام. ولما كانت الشراكة عملية محفوفة بالمخاطر من وجهة نظر مؤسسة الخلافة، فقد عملت هذه الأجناس بطرق أخرى لتعزيز نفوذها. وكان الصراع بين الأمين والمأمون (أبناء هارون الرشيد أعظم خليفة عباسي) أول صورة للانقسام الداخلي في مؤسسة الخلافة والاستقطابات التي تولدت عن محاولات تعزيز هذا النفوذ والصراع بين العرب والأجناس المختلفة.
ويتجلى “مكر التاريخ” هنا في التصادم العميق بين المضمون “المغلق” للخلافة من ناحية، والمفهوم البراغماتي المنفتح على بقية الشعوب والأعراق للدولة من ناحية أخرى. ففي حين أن مؤسسة الخلافة لم تستطع أن تجعل من هذا الطابع المغلق لها مصدر قوة لمواجهة تحديات التنوع العرقي للدولة، فإنها لم تستطع أن تنتقل إلى نظام يطبق أدوات الدولة على نحو تتخلى فيه عن جزء من نفوذها الوراثي المعطل لهذه الأدوات، مما خلق فجوة كبيرة بين مؤسسة الخلافة والدولة، مُلئت بالقوى الناعمة التي استسلمت لها القوة المنهكة في قصر الخلافة، الأمر الذي انتقلت فيه مراكز القوة إلى الأمصار لتنشئ دولها المستقلة التي لا يربطها بالخلافة سوى الدعوة للخليفة في منابر المساجد وشيء قليل من خراج الأرض.
ووجدت أمريكا فرصتها، التي اعتبرتها تاريخية، في مواجهة حاسمة مع الاتحاد السوفيتي السابق المتورط في أفغانستان، عبر دعم وتنظيم وتمويل وتعبئة من أسمتهم “المجاهدين”. وعلى الرغم من النتائج الكبيرة التي حققتها في المعركة، إلا أنها لم تحسب حساب “العقل الكلي” للتاريخ الذي كان يرتب جولات قادمة لصراع دام ممتد حتى اليوم مع حلفاء الأمس، تغيرت معه مفاهيم وأدوات الأمن القومي والإقليمي والعالمي بصورة جذرية تجاوزت كل التوقعات.
نموذج آخر هو أن دولة الاتحاد السوفيتي، التي شكلت على مدى 70 عاماً قطباً لنظام استقطب أكثر من ثلث العالم، انهارت بواسطة قيادة سوفييتية انقلبت على فكرتها السياسية والإيديولوجية. وهي لم تسقط بسبب هجوم خارجي، بل وقعت في فخ “مكر التاريخ” حينما كان عليها أن تعيد قراءة المتغيرات الدولية التي بدأت تشعل الاحتجاجات الشعبية في أقرب حلفائها: بولندا وألمانيا الشرقية، وقبلها بسنين المجر وتشيكوسلوفاكيا، وانتهاج الصين خطاً تصالحيًا مع الغرب لتسويق مشروعه الاقتصادي الضخم. وفيما قاد هذا الخط التصالحي للصين، الذي عده المفكرون السوفييت حينها خروجاً عن الخط الماركسي اللينيني، فإنه هو الذي حافظ على الصين كنظام اشتراكي. أما الاتحاد السوفيتي فقد أخذته “برسترويكا” غورباتشوف، التي رفعها في وجه الدولة التي كان يقودها في تحدٍ للإيديولوجيا التي اعتقدت أنها الضامن الوحيد لهذه الدولة متعددة القوميات، إلى التفكك وإلى حضن الرأسمالية التي لم تقبل به حتى اليوم. وهي لم تكن مشروعاً للإصلاح والمراجعة بقدر ما كانت دعوة للاستسلام وإعلان هزيمة الفكرة من داخلها، وتلك هي أسوأ الهزائم التي تجتث المشروع من جذوره. ومثل هذه الهزائم هي صورة من صور “مكر التاريخ”.
إن أحدث نماذج “مكر التاريخ” هو مؤشر التحاق القيادة السورية الجديدة بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. فـ”مكر التاريخ” هنا ربما كان يفصح عن أن المسار القديم الذي اختطته هذه القيادة في مواجهة طغيان نظام الأسد كان ضروريًا لإنتاج شروط التحول الجذري على الطريق الذي سيراجع فيه العالم علاقته بسوريا فيما بعد. غير أن التاريخ هنا لا يزال يراقب حركة التغيير الحاد في هذا البلد ذي التاريخ الملغوم بالخصومة والعزلة والعقوبات مع مكونات الحلف الجديد. لكن هناك وجه آخر لمكر التاريخ هنا، وهو أن أشد الأعداء يمكن أن يصبح أكثر الأصدقاء قرباً وإخلاصاً على النحو الذي يوصي بأن لا تجعل الكراهية تعميك عما يعتمره خصمك من عناصر إيجابية من شأنها أن تعيد صياغة العلاقة بينكما بقواعد براغماتية نفعية أو استراتيجية.
في التجارب اليمنية
وفي التجارب اليمنية يمكننا رؤية “مكر التاريخ” في أوضح صوره. فبعد أكثر من 60 عاماً من نضالات اليمنيين وتضحياتهم من أجل الاستقلال والتحرر من طغيان الاستبداد الإمامي الكهنوتي وتحقيق الوحدة، وفيما بدا أنه المسار الطبيعي الذي طوى تاريخاً من الاستبداد والتمزق وصولاً إلى تطور واستقرار وازدهار هذا البلد، إذا بتطورات الأحداث تثير أكثر من علامة تعجب حول كيف أن هذا المنجز الكبير انهار وتفكك إلى عناصره الثلاثة: فالاستقلال، رغم أنه أقام الدولة الوطنية التي غيرت وجه الحياة المثقلة بالقهر والاستبداد والتخلف في كل الجنوب، انتهى إلى الحنين، فيما يشبه الهزل، إلى زمن الاستعمار. وأن التحرر من الطغيان الإمامي الكهنوتي وإقامة الجمهورية التي أعادت الكرامة لليمنيين قد خلص إلى تسليمها لورثة ذلك الطغيان الإمامي رغم أنها كانت قادرة على مقاومة السقوط. وأن الوحدة قد انقلبت إلى دعوة إلى الفرقة والخصومة والشتات رغم ما ولدته من فرص لنقل اليمن إلى فضاءات الإخاء والتقدم.
وبتساوق مع كل ذلك، يمكن إيراد بعض الأمثلة لما تعرضت له بعض القوى الفاعلة في المجرى العام لهذه التجربة. فالحزب الاشتراكي اليمني يعد من أكثر القوى التي تعرضت لمكر التاريخ في أهم مفاصل نضالها السياسي. لقد تأسس الحزب وفقًا لمنهج وطني، كانت الوحدة تشكل فيه عنصرًا أساسيًا في هيكليته السياسية والفكرية، عمل من أجل تحقيقها كأولوية ارتبطت بنشاط الدولة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على نحو ظلت فيه حاضرة بكل نجاحاته وعثراته، واعتبر تحقيقه منجزاً وطنياً تاريخياً. لكنه لم يكن يدرك أن “الوحدة” ستصبح رافعة بيد خصومه لتكسيره، وإخراجه من مركز المعادلة السياسية إلى الهامش مثقلاً بتهمة “الانفصال”، وبمسؤوليته عن مئات الآلاف ممن قادهم إلى الوحدة وتعرضوا للتسريح من أعمالهم والمطاردات والضغوط النفسية والجسدية بتغيير الاختيارات لمواجهة مصاعب الحياة، أو رفضاً للمسار الذي تحركت فيه الحياة بعد الحرب.
وعلى الرغم مما تعرض له الحزب بعد ذلك من ضغوط وانقسامات ومراجعات سياسية وفكرية، فقد واصل القسم الأكبر من الحزب، في ظروف صعبة، تمسكه بخيار أن المشروع الوطني لا بد أن يؤسس، لكي ينجح، بقواعد الدولة الوطنية، وأن الخيارات السياسية لم تعد تصنعها النخب بمعزل عن المجتمع الذي يحق له وحده أن يقرر خياره السياسي.
كان لا بد من قراءة الأحداث باعتبارها أحد تجليات “مكر التاريخ” بأسبابها التي تعود إلى أن ذلك الهدف الوطني الكبير الذي تحقق بشروط ظلت تفتقر إلى الحاضن الوطني الأشمل (الدولة الوطنية)، أي بكلمات قليلة تلخص المشكلة: غياب التوافق بين الفعل الوطني من جانب، وإدارته بأدوات ما دون الوطني من جانب آخر. من هذه الفجوة تسلل “مكر التاريخ” ليشعل الحرب باسم “الدفاع عن الوحدة” وليضعها خارج مسارها وأهدافها الفعلية التي تحققت من أجله، ويصنع من ثم مساراً موصلاً إلى نهاية متناقضة موضوعياً مع هذا الهدف الوطني الكبير.
لقد سجّل التحالف المنتصر فيها، وما لحقه من إخفاقات في الدفاع عن الوحدة التي بشر بها كبديل للوحدة السلمية، مثالاً أكثر وضوحاً لـ”مكر التاريخ”. فلم تمض سوى فترة قصيرة حتى فُضّ ذلك التحالف، وأخذت الأسباب ذاتها التي أنشأت الأزمة والحرب تبرز في تجليات لا غبار عليها لتؤكد من جديد أن المشروع الوطني لا يمكن أن يدار إلا بدولة وطنية، وبالأصح أنه يجب أن ينتهي إلى دولة وطنية.
ثم توالت الأزمات والحروب ودعوات التغيير والحوار، وتعكير سير الحوار بالاغتيالات والتفجيرات، وتخريب المظهر الوطني للبنية الاجتماعية في صعدة من قبل الحوثيين والاستعداد للحرب، ورفض البعض على نحو مطلق للحوار دون تقديم بديل سوى الاستمرار في الصراع بدون أفق واضح للحل، والتشكيك من قبل البعض في قدرة الحوار على خلق معادلة وطنية وعقد اجتماعي جديد، ورفض البعض لكثير من قواعد البناء الجديد مثل العدالة الانتقالية، والتردد في خلق البيئة السياسية والقانونية والتشريعية الملبية لعملية التغيير. وأعقب ذلك استعراض القوة والمراوغة في صور عدة من عملية إعادة بناء النظام وآليات السلطة… كل هذا والتاريخ يتحرك بقوانينه الموضوعية وعقله الكلي الذي يدير المشهد بفضاءات أوسع وأكثر تعقيداً وتداخلاً، ناهيك عن تصادم المصالح المادية في الواقع الاجتماعي بسبب مواصلة إدارة الدولة بقيم الغلبة عوضاً عن القانون، ويكشف عن الفجوة الهائلة التي أخذت تتسع بين قيم الجمهورية والثورة وأهدافها العامة من ناحية، وقيم وسلوك وحسابات وأهداف النظام السياسي والاجتماعي وقادته ونخبه من ناحية أخرى.
أما الحوثي، الذي التقط اللحظة التي نتجت عن اتساع هذه الفجوة وانقلب على الجمهورية وعلى محاولات إصلاح المسارات الهادفة لاستعادة قيم الجمهورية بمنطق ثوري جديد يعتمد الحوار والتفاهم وتعميق المشتركات الوطنية، فقد وقع في فخ “مكر التاريخ” مرتين.
الأولى: أنه في الوقت الذي أراد بانقلابه أن يعيد الإمامة السلالية الكهنوتية لحكم اليمن، فقد أحيا، من حيث لا يشعر، قيم الثورة والجمهورية والحرية بين الناس والأجيال وفي الوعي المجتمعي على نطاق واسع. تجسد هذا في الاصطفاف الشعبي الكبير دفاعاً عن الجمهورية ورفضاً للانقلاب ومشروعه الإمامي. لقد استخدم التاريخ الحوثي كوسيلة لاستعادة روح الجمهورية وقيمها في وعي الناس، وبما أن آليات “مكر التاريخ” لطالما عملت بصورة منتظمة على جعل الأفعال الرجعية تولّد وعياً ثورياً، فإنه تماثلاً مع ذلك قد ولّد الانقلاب الرجعي الحوثي وعيًا بقيمة الثورة والجمهورية في حياة اليمنيين، مدركين بحس ثوري الأخطاء التي أبقت النوافذ مفتوحة أمام مراوغات ذلك الفعل الرجعي.
والثانية: أنه يعيد إنتاج حكم الإمامة الكهنوتية على أرض اليمن بصيغ لا تمنحها إلا المزيد من التلوث والكثير من الكسور، إنما يكرر التاريخ بصورة هزلية بفعل لا يملك شروط البقاء، وهو ما يجسد صورة أخرى من صور “مكر التاريخ”.
ولكي يستكمل التاريخ مكره هنا، فإنه لا بد من قوة تلتقط اللحظة، وتكون بمستوى أن تستوعب الأفق الواسع الذي تجري فيه المعركة، والفضاء الأوسع الذي يتحرك فيه التاريخ.