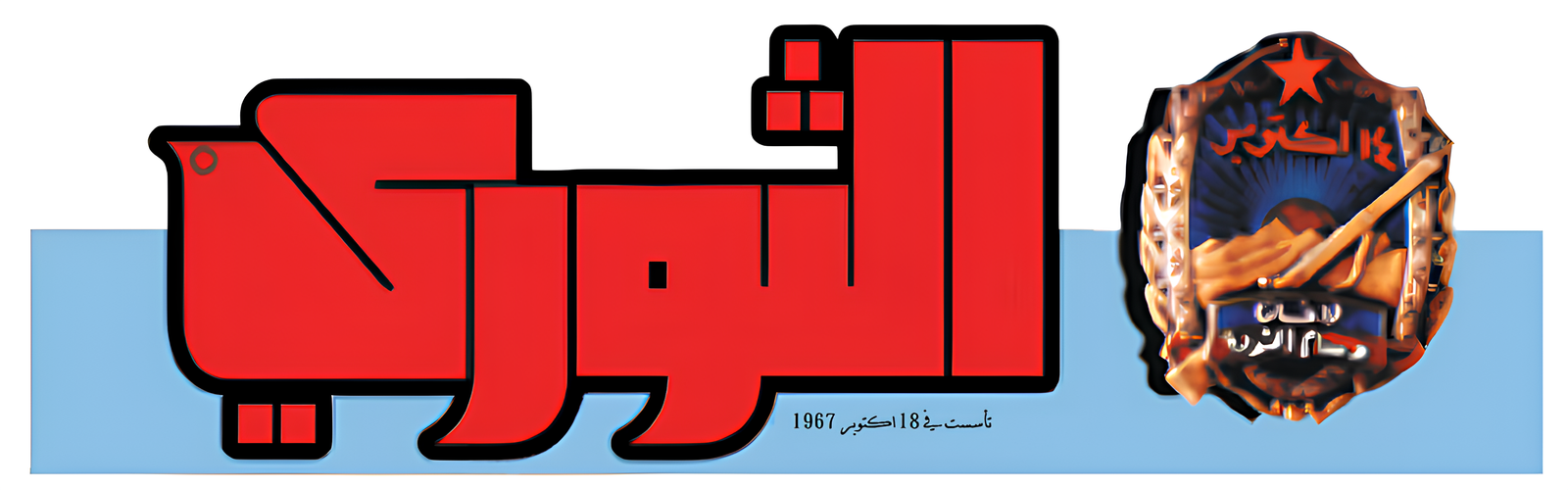“صحيفة الثوري” – كتابات:
آزال الصباري
أنا امرأة وُلدت في إحدى قرى جبال العود، في وادي السهيل تحديداً، في الوادي الذي أصبح مؤخراً جزءٌ منه جنوبياً وبقي الآخر شمالياً، وبقيت أنا نصفين في جسد، لا شمالية بحتة ولا جنوبية خالصة، وكأن الأقدار كانت تمهّد لأن أكون أنا هذه المنتمية لكل اليمن… لنقل إن قلبي فُطر على ذلك، ثم حدث ما حدث.
آزال هذه التي أصبحتها، المرأة المتمرّدة نوعاً ما… للعلم، لستُ كذلك وحدي، كلنا خُلقنا متمرّدين، لكننا نُقمع ونُقمع ثم نستسلم. أشعر أني أصبحتُ مستسلمة بقدرٍ كبير، وربما من يعرفني عن قرب يدرك ذلك.
آزال من العود، المنطقة العظيمة بناسها وأهلها، بقبائلها وأعرافها، ببساطتها التي ذهب منها الكثير. يزيدني قدراً كبيراً أن أنتمي إلى منطقتي بكل قبائلها وناسها، وأعتز بهذا الانتماء أيّما اعتزاز. لا تحديد عندي ولا تفضيل لديّ، لا قرابة، لا أُطر، لا ألقاب ولا نسب. كلهم مني وأنا منهم.
لكنّي –برغم هذا الاعتزاز الكبير– أحمد الله أن أبي خرج منها ذات يوم طفلاً، ليلتحق بمسيرة جار الله عمر، ويسكن بندر عدن.
انغمس أبي –الشاب الذي كانه– برمل شواطئ المدينة الساحرة إنساناً متمدّناً، لا يحمل من القبيلة سوى شيمة الكرم ومبدأ التضحية وحبّه لمسقط رأسه. فمنحني ما وهبته المدنية صفاءً، وما لقّنته الاشتراكية من مفاهيم. حظيتُ بحرية كبيرة، ليست الحرية التي قد يفهمها البعض بحسب هواجسه، إنها حرية أن تُحلّق المرأة بعقلها لا بجسدها.
سيقول قائل: ماذا حققتِ يا مجنونة؟!
إهدائي، هذا القائل لا يعلم أني –وحين كنت في عمر الرابعة عشرة– كانت منطقتي لا تسمح للفتاة بدراسة الإعدادية، وإن أختي التي تصغرني كانت أول طفلة تلتحق بالصف السابع. وأني حين ذهبتُ أول يوم لأدرس في الصف الأول الثانوي، جرّدت كل القبيلة سيوفها في وجه أبي، ووصفه الوادي بالمنفتح والماركسي الفاسد المفسد للأخلاق. كان تعليم الفتاة فسقاً، فسقاً كبيراً…
أضف إلى ذلك يا عزيزي أني استسلمتُ وعدتُ إلى البيت لأهتمّ بإخوتي، ونسيتُ أمر المدرسة وأمر الشهادة. ولولا إصرار ذلك الرجل الاشتراكي لبقيت دون تعليم، لبقيتُ المرأة التي لو ظهر اسمها علناً لألحقت بالقبيلة العار، ولسقطت جبال العود منهارةً مما تسمع.
تبّاً لي! لقد قدّمتُ حديثاً لم أشأ تقديمه، ونسيت أني كنت أتحدث عن حبي لجبال العود.
حسناً… أنا –على غير إخوتي الثلاثة– كنت مثل أبي، سقط رأسي بين جبال العود، وربما لذلك السبب بقي حبي لذلك الانتماء وحنيني لتلك الجبال أبدياً. رغم أني نجوت من منحدراتها الخطرة بمشقة كبيرة وفرحة عارمة… نجوت بفضل هذا الرجل الاشتراكي العظيم. نعم، لقد نجوت بآزال هذه… نجوت من امرأة لم أكن أريد أن أكونها.
لكني على يقينٍ تام أن الإنسان حين ينضج يمكنه أن يتناسى، أن يغفر، أن يحب… وأن الإنسان حين ينجو يعود ليحب وطنه الذي فرَّ منه مذعوراً، هارباً لينجو من الهلاك. في لحظات كثيرة يصبح الإنسان أمّاً لوطنه، يحنّ، يسامح، يتغاضى، يتجاهل، ويعود ليحتضن وطنه كأن شيئاً لم يكن.
دائماً كونوا على يقينٍ أنه يمكن للحب –حين يكبر بصدق– أن يحوّل الماضي المؤلم بأبطاله القساة، وغدره، وخياناته، إلى مجرد ذكرياتٍ على جدار الزمن… ذكريات وحسب. لا شيء يستحق أن نكره أو نعادي.
لكن ماذا لو شاءت الأقدار عدم مغادرة أبي لمسقط رأسه في عمر مبكر إلى عدن؟ ماذا كان سيحدث؟
بدون فرضيات أخرى، كان سيتزوج بأمي ويمكث بين قيعان وادي السهيل، سيكون رجلاً له مكانته بين أهله وبين بقية قبائل الوادي، لا شيء سينقصه كرجل… لكن ماذا عني أنا؟
كنتُ –وبدون أي مجال لفرضية أخرى– سأدرس في المدرسة الابتدائية حينها، سيكون ذلك إذا سمح أبي القبلي، وسينتهي بي المطاف كفتاة درست إلى الصف السادس، ومع تقادم الزمن ستُرمى تلك الشهادة في مكب نفايات القرية بين بقايا الحيوانات، كأي ورقةٍ عليها طرطشات حبر. انتهى.
… والبقية تفاصيل حياة تمرّ بها أي فتاة حتى تصبح امرأة، لكن هناك شيئاً أهم من ذلك كله، لولا أبي الاشتراكي لكان أبي القبلي يحاصرني بالعيب والعار، وعبارة: «المَرَة من بيت أبوها لبيت زوجها لقبرها».
ولو لم تكن ثورة أكتوبر ونهج الاشتراكي… لما………..
لم يكتمل بعد.
البقية في الطريق.