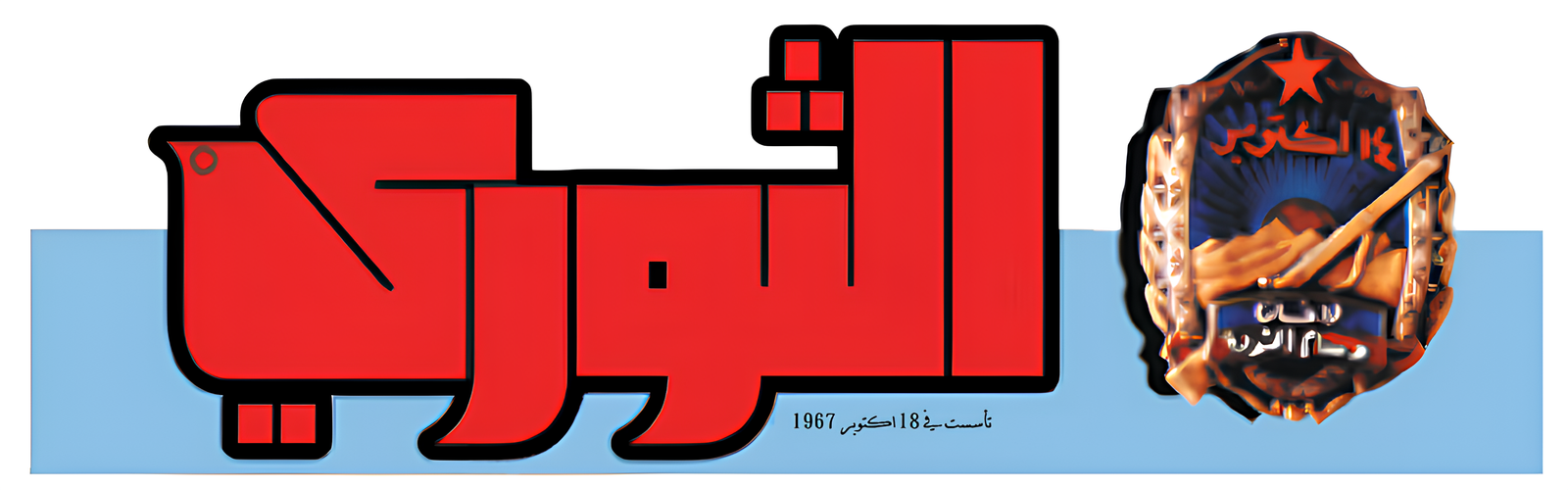“صحيفة الثوري” – ثقافة:
د. بشير أحمد أبو أصبع
“لقد تعبتُ، ولم أعد أرغب بمزيد من الحياة أو الصحة أو الحرية. أنا نبتة طرية في سماء الكون، تتبخر متى تشاء وتعود كما تشاء. أنا نقطة ظل. أنا لا أحد.”
كان هذا الهمس يلف وجدي الأهدل كدخان رؤيا، بينما تتشكل أمامه كل التفاصيل كحلم يقظة لا سبيل للفكاك منه. لم يكن هذا الهمس مجرد كلمات عابرة، بل كان صوت روحه المنهكة، يتردد صداه في الفراغ الذي يحيط به على جبل التعكر، يتداخل مع أصوات الحمم وصرير القوارب الجبلية. كانت عيناه تتوهجان ببطء، تعكسان وهج الكبريت القادم من الأسفل، وكأنه يرى في كل وميض جزءًا من ذاته يتلاشى ويتبعثر في هذا الفضاء الشاسع.
في تلك السماء المعكرة، حيث الحقيقة مجرد سراب، كنت أبحث عن “قوارب جبلية” متشبثً بأعلى حواف “جبل التعكر”، حيث لم اكن ابتعد عن حافة السماء سوى بضعة أصابع.
ومن هناك كنت الحظ، رواية “اليهودي الحالي” وهي بين كفي علي المقري، جالساً كأنه المتوكل على الله اسماعيل ، شاردً ذهنه ، وكأن كلمات الرواية تتجسد أمامه في الفضاء المحيط.
بجواره تماماً، كان الغربي عمران متقرفصاً ، يداعب بيديه صفحات من كتاب تتوهج كجمر خفي في ضوء الجبل البركاني.كأنه “مصحف أحمر”، لعلى ذلك كانت احد رواياته .
كان علي المقري يميل إليه، تتشابك كلماتهما في هواء الجبل الرقيق حول رواية “مصحف أحمر” وعن معنى اله “المقى” ، الذي هو الاسم القديم للإلهة اليمنية التي ترابط أرواح الأدباء،و مايزال هي الروح الكامنة لهذا الجبل البركاني الذي يشع ابداعاً، ومن خلال أصوات الحمم المتوهجة وارتعاشات الأرض، تهمس بالأفكار، وتُشعل جذوة الصراع الفكري بين المبدعين.
كل هزة ارتدادية، وكل نفث من الكبريت، كان يُترجم كتدخل مباشر من الإلهة “المقى” في مصائرهم الأدبية، تارةً لتُلهب الإبداع وتارةً لتدفعهم نحو مواجهة قاسية حول من يحكم السرد، وكأنهُ يقيم محكمتهُ الإلهية في هذا الفضاء المتلاطم بالكلمات.
وجدي الأهدل كان صامتاً، كا الرياح قبل هديرها، و شخصيات رواياته تستعد للانطلاق كاومضات نارية كانها نيازك تصيب قلب الحقيقة ، رأسه كان يشتعل ببطء، كجمرة سيجارة “كمران” تشع ابداعاً ، دخانها يتصاعد ليلتصق بزخات الكبريت المتوهج القادم من الأسفل، لم يكن صمته سكونًا، بل كان صراعًا داخليًا لا يُرى، عواصف من الأفكار تتلاطم في جمجمته، بينما يراقب المشهد السوريالي حوله بعينين غائمتين، محاولًا أن يجد مرسىً واحدًا لقاربه الجبلي في هذا العدم المتجلي.
ورغم أنه على سطح أحد “قواربه” العائمة في العدم، إلا أنه كان عاجزاً عن استخدام المجاديف.
يا له من مضحك! كيف يكتب رواية عن القوارب وهو لا يجيد التجديف حتى في هذا الفراغ ؟!
في تلك الأثناء، اخترق صوت جهوري كالصدى الغريب الضباب المتلبد من أسفل الجبل البركاني، ، ينادي: “يا عزيزة عبدالله: “القيامة الان”…. ! القيامة الان ، انت لم توجدِ؛ وكأنك عدم!”.
كان صوته يطمس وجود عزيزة ، وكأنه يمحوها من صفحات الاله “المقه”.
هذا النداء لم يكن مجرد صوت، بل كان ضربة قوية في صميم كيان عزيزة الصلب، محاولًا دفعها نحو فوهة الجبل المتهيأة للانفجار.
كانت عزيزة تتلوى، لا بسبب الألم الجسدي، بل بسبب الصراع الوجودي الذي يمزقها، وكأن الكلمات تتحول إلى حمم حارقة تستهدف كيانها، محاولتاً التشبث بآخر خيط من الواقع قبل أن يتلاشى جسدها إلى حبر سائل على صفحات النص المتمردة.
فكري قاسم، الصحفي اللامع الذي طالما حلق في سماء الإبداع بكلماته الحادة، تحول في هذا المشهد إلى وحيد قرن خيالي، ينخر بقرنه القرمزي كل ما يعترض طريقه.
كان يحاول أن يدفع وجدي الأهدل من فوهة الجبل المتهيأة للانفجار، يلقمه الكبريت المتوهج، لكن وجدي كان يتلوى، يحاول التحرر من هذا الهجوم السردي العنيف، وكأن جسده تحول إلى حبر يتلاشى على الورق.
في الجهة المقابلة، كان مروان غفوري، الجراح البارع والروائي المحنك، يترنح بفعل هزات ارتدادية قادمة من الجانب الآخر للجبل، وكأنه يحدق في نشرة أخبار سوريالية من عالم موازٍ. لم يكن يحب تسلق هذه الجبال القاسية؛ لأن يديه الناعمتين، التي اعتادت على المشرط ، لم تكن تتآلف مع الصخر المتفتت. فجأة، وبصوتٍ يائسٍ يكاد يمزقه هدير البركان، صرخ مروان غفوري بأعلى صوته نحو العدم المحيط به: “يا منصور الأعرج! ادعُ لي الباهوت! حتى يأتي لينقذني من هذا القاع المظلم الذي أنا فيه!”.
كانت صرخته تختلط بدخان الكبريت، كاستغاثة أخيرة من قاع الجحيم الأدبي الذي وجد نفسه فيه. مروان الغفوري، الواقف في أسفل الجبل، حاول أن يصف الصراع الدائر بين فكري قاسم ووجدي الأهدل، وكأنه محلل أدبي يراقب نصاً يتشكل.
لكنه وجد نفسه أضعف من أن يفض هذا النزاع السردي؛ لأن قوة فكري قاسم، المستعارة من وحيد القرن القرمزي، كانت طاغية، لا يمكن أن يقهرها سوى كيان آخر أكثر جبروتاً، مثل
“الجوهرة” التي يمتلكها الكاتب همدان دماج، ففيها يكمن مفتاح السرد كله.
همدان دماج، بقدراته الخارقة التي تذكر بـ “غريندايزر”، يمتلك قوة تغيير مجرى الأحداث. يقف في رأس جبل “التعكر” الشاهق. و”الجوهرة”، التي ترمز لسلطان الكلمات بين يديه، تصدر أشعة ليزرية قوية تخطف الأبصار، حتى أنها أحرقت رواية “اليهودي الحالي” التي كانت في يد علي المقري،
فما كان من علي المقري إلا أن التفت إلى همدان، وكأنه يرى مصيره الأدبي يتلاشى، وقال بذهول: “أهلاً يا دكتور همدان!”
في تلك الأثناء، من أحد كهوف جزيرة سقطرى الغارقة في عبير أشجار دم الأخوين، كان عبد الكريم الرازحي يراقب كل هذه الأحداث السوريالية من وراء شاشة لابتوبه الساحرة، وكأنه كاتب يحاول التحكم بشخوصه الروائية. كان يحاول التدخل في صناعة الأحداث، بتغيير سطر هنا أو كلمة هناك؛ لكنه كلما نظر إلى الشاشة، ظهرت له عبارة: “أنا قبيلي يبحث عن حزب”، وكأن واقعاً آخر يفرض نفسه على محاولاته السردية.
لكن عبد الكريم الرازحي لم يتوقف عن محاولاته لإضفاء لمساته على العوالم التي يراها عبر شاشة الكمبيوتر.
كان دائماً ما يواجه قرن فكري قاسم القرمزي، الذي يحاول هو الآخر اختراق الشاشة والتدخل في عالمه الخاص في سقطرى، وكأن الشخصية الخيالية تتمرد على خالقها وتدفع نحو واقع مغاير.
أما محمود ياسين فكان يخزّن القات بشراهة في ديوان نقابة الصحفيين اليمنيين، بعيداً عن هذا الجحيم السردي. كان “يتبادل الهزء مع ماضيه” ونفسه، كمنفصل عن الواقع، بينما يدندن بأغنية: “يا باه سعيد يا باه… كل القبل جابه”، غير عابئٍ بأي ترابط أو تقابل مع رفاقه المعذبين جوار بركان التعكر، وكأن صمته يمثل رفضاً لواقعهم الأدبي المؤلم.
نادية الكوكباني كانت منهمكة في كتابة روايتها الجديدة. يدها ترتعش مع كل هبّة ساخنة من البركان، وهي تقول: “هذه ليست قصة حقيقية، هذه ليست قصة سعيد المغلس، لكنها قصة سعيد المبكر”. كانت تلهث من شدة حرارة البركان التي تخترقها، بينما كانت ميسون الإرياني تنظر إليها من خلال نظاراتها الكبيرة ذات الطابع الطبي التي تسمى “قعر الزجاجة”، وكأنها ترى الواقع الأدبي مشوهاً ومضخماً. كانت ميسون الإرياني تنظر إليهم من خلف عدساتها السميكة وتقول بصوتٍ حاد، فيه مسحة من الدعابة: “اتركوا لي شيئاً من الغنيمة الفنية، اتركوا لي ولو سطراً أو كلمة أو قصة قصيرة! إنني أفضل منكم جميعاً أيها المبدعون!”. كانت مُحقة في نظرتها الثاقبة، فهي امرأة ذكية حقاً، ترى أبعاداً لا يراها غيرها؛ لكن مشكلتها أنها كانت تتبخر داخل نار البركان دون أن تشعر، وكأن ذكاءها الحاد لم ينقذها من مصيرها السردي المحتوم!
في خضم ذلك، حاولت نادية لفت انتباه ميسون إلى أنها داخل البركان، فنادتها بصوت عالٍ، صراعاً ضد هدير الحمم المتوهجة، لكن ميسون لم تسمع، إذ كانت قد بدأت تتلاشى بالفعل، عندها، فكرت نادية الكوكباني أن تزغرد زغرودة مدوية، كتلك التي تُطلق للعرسان الجدد، لعلها تصل إلى ميسون كإشارة أخيرة.
وفوراً تنبهت ميسون قبل تلاشيها وصاحت: “يا إلهي! إنني أحترق بنار هذه الزغاريد!”، وكأن الزغرودة نفسها كانت شرارة بدايتها السردية. انطفأت زغرودة نادية الكوكباني الأخيرة في جوف البركان، تاركةً ميسون الإرياني تتألق كاومضة تمر حين الظهيرة، لا صوت لها سوى همس الفحم المتطاير الذي كان يهمس في أذن عبد الكريم الرازحي عبر شاشته. حاولت نادية أن تتلمس أثرها؛ لكن كل ما وجدت هو حرارة حارقة وصدى كلمات: “هذه ليست قصة حقيقية” يتردد في أرجاء الجحيم السردي.
كانت أصابع عبد الكريم الرازحي ترتعش فوق لوحة المفاتيح في كهفه بسقطرى. وانبثق قرن فكري قاسم من شاشة الكمبيوتر. وهو يصرخ باعلى صوته يارازحي “أوطناً هذا ام مطب” لم تكن تلك مجرد صورة رقمية، بل جسداً مضطرباً يتنفس هواء الكهف المالح، متسللاً إلى واقعه. حاول عبد الكريم أن يصدّه، أن يمحوه؛ لكن الشاشة تحولت إلى بوابة، وبدأ جسد فكري قاسم يتسلل، ببطء مؤلم، نحو عالمه، وكأن النص يتمرد على كاتبه في تحدٍ صريح.
في تلك اللحظة، شعر محمود ياسين، في مقيله، بارتعاشة غريبة في إبريق الشاي أمامه، وكأن حرارة البركان قد امتدت لتصل إلى هدرجة القات في يديه، فتعمق أكثر في هزئِه بماضيه، مستسلماً لإيقاع “يا أبا سعيد يا أبا”، وكأنها نشيد جنائزي لواقع روائي بدأ ينهار حوله.
أما أسطورة والنقد محمد عبدالسلام منصور، الذي كان يقف بعيداً يراقب هذه العوالم، فكان يقول لهم بنبرة رزينة، تحمل ثقل فكر لا يتقيد بحدود: “أنا لا أرى في النقد الأدبي سبيلاً لتقييم الأعمال، ولا يمكنني أن أقرأ رواية أحدكم بمنظور تقليدي.
أنا إنسان لا ينتقد ، أنا فقط أفكر وأرى الأبعاد الخفية في هذه العوالم.”
كأن فكره العميق هو ملاذه الوحيد في هذا الجحيم الأدبي المتشابك.
وفي تلك اللحظة الحاسمة، حين اختنقت آخر الزغاريد وتلاشى آخر ظل، لم يعد محمد عبدالسلام منصور مجرد مراقب، بل تحول كيانه إلى شفق يتمدد فوق الجبل، يمتص كل الضوء المتبقي من هذا العالم السوريالي.
لم يتكلم، بل صارت عيناه نافذتين تُطلان على العدم، ينعكس فيهما صدى الكلمات المحترقة، وصمت وجدي الأهدل الأبدي، وصرخة مروان غفوري اليائسة، كان وجوده يتحول إلى ذاكرة كونية، حيث لا تُقاس الأعمال بالنقد، بل بالرنين الذي تُحدثه في الفراغ الأبدي.
وفي كل حرف يتبخر، وفي كل نفس ينقطع، كان محمد عبدالسلام منصور يرى، ليس نهاية، بل بداية جديدة لقصص لا تُكتب، تبقى محفورة في روح القارئ، كفكرة تتردد صداها بلا نهاية، كإلهام أبدي يتجاوز الكلمات والزمن .