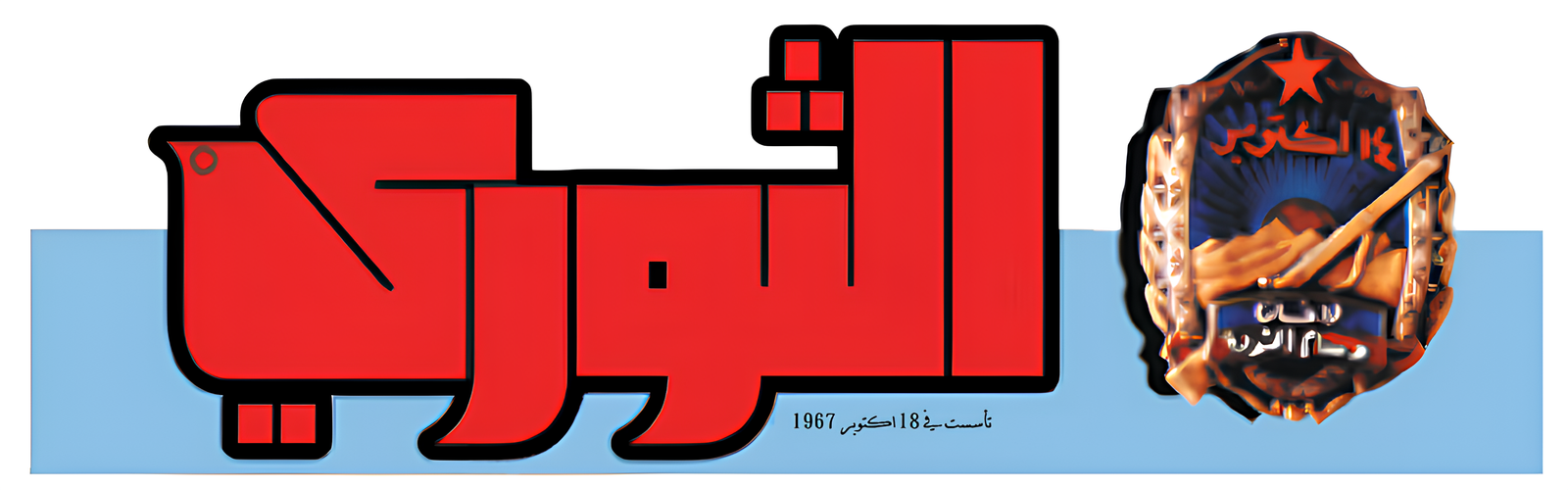“صحيفة الثوري” – كتابات:
د. رياض الصفواني
مع حلول ذكرى الحادي عشر من فبراير من كل عام، يكثر الجدل وتتباين الآراء ويحتد الخلاف حول الحدث الذي ملأ داخل البلاد وخارجها صخباً، وشكّل علامة فارقة في تاريخها المعاصر، بصرف النظر عن جدلية مسمياته وتصنيفاته وتوصيفاته، إذ لانكاد نجد التقييم له إلا محصوراً بين مدافع مبالغ في مدحه أو مهاجم مسرف في ذمه! وفي هذا السياق يضيق الأفق ويُفتقر إلى الرشد الذي لابد منه لمقاربة الحدث في ضوء بواعثه وأهدافه وشروطه ومناخه العام، بمعنى آخر إعمال العقل المنهجي في كل شأن يتصل به من القريب والبعيد، وبدون ذلك ستكون المقاربة قاصرة والحكم عليه مبتسراً ومشوّهاً، إذ يقتضي منطق أي تجربة بشرية، سواء ثورة أو انتفاضة أو حركة أو تمرد أو تظاهرة شعبية دراسة أسبابها وظروفها وخلفياتها وأدواتها وربطها منهجياً ربط العلة بالمعلول، والمقدمات بالنتائج، لتحديد مستوى نجاح التجربة أو فشلها.
ومن هذا المنطلق، فإن تجربة الحادي عشر من فبراير ٢٠١١م، تعد نواة تغيير على صعيديْ النوع والكم، كان يراد لها أن تمضي بثقة، وتنجز أهدافها باقتدار، كترجمة للمطالب الحقوقية الطبيعية التي رفعها الشباب في الساحات، وماحدث بعد ذلك لم يكن مسؤوليتها كمصفوفة أهداف مشروعة بقدر ماهي مسؤولية العقلية (البرجماتية) النفعية والانتهازية التي جيّرتها لمصالحها، وتلك التي أساءت إدارة دفتها، أو تهربت من مواجهة استحقاقاتها، لكنها مع ذلك بقيت واقعاً تشكّل على الأرض وارتسمت صورته في الذهنيات العامة على هيئات متباينة، عكست تبايُن النظرة إلى الحدث والموقف منه.
وإذا كان ثمة ضرورة اليوم لتقييم تجربة ١١ فبراير ٢٠١١م من الناحية التاريخية، كتقييم مبدئي غير مكتمل، بالنظر إلى راهنيتها، وحداثة عهدها، وعدم اكتمال عناصرها، وبقاء العديد ممن شاركوا في إدارتها على قيد الحياة وعوامل أخرى، فليكن التقييم بعيداً عن سعار المعارك الكلامية، ولهيب الاحكام الجاهزة. مع الوضع بالحسبان أن التاريخ غداً سيقول فيها كلمته، كما قال في غيرها. فقد ذكر عن الثورات الأوروبية أنها خاضت صراعات مريرة، ووقفت في وجهها عراقيل جمة، وفي مقدمتها الثورات المضادة، حتى تحقق لها الإنجاز المنشود، وظلت الشعوب الأوروبية تجني ثمار عملياتها الثورية التي دشنتها الثورة الفرنسية عام 1789م إلى اليوم، واستمر مخاضها حتى عام 1848م، وهو العام الذي وصلت فيه رياح التغيير إلى مختلف دول أوروبا، فحققت ألمانيا المجزأة وحدتها عام 1871م، وقبلها أنجزت إيطاليا وحدتها بين عامي 1866م ــ 1870م، ووصلت شرارة الثورة إلى روسيا والنمسا والمجر وغيرها من دول وسط وشرق أوروبا، وظل المد الثوري كاسحاً متحدياً كل المعوقات، وصولاً إلى تشكيل واقع مابعد الحرب العالمية الثانية 1945م، وحتى تحقيق الوحدة الألمانية عام 1989م.
في ضوء ماسبق، فإنه من المبكر أن نحكم على تجربة ١١ فبراير ٢٠١١م بالسلب أو الإيجاب من منطلقات عاطفية، تمثل عند هذا الطرف الشر المطلق، وعند ذاك الخير المطلق، في الوقت الذي نعلم جيداً أنه لم تكتمل عناصر التجربة على النحو الذي كان مرسوماً لها، مع قصر مدتها، ووقوف حوادث جسيمة لها بالمرصاد!.
وإذا كان هذا هو الموقف من تجربة ١١ فبراير ٢٠١١م، فكيف سنحكم على الثورات الأخرى التي لم تحقق كامل أهدافها وتوقفت عند محطة تغيير شكل النظام الحاكم – وإن كان هذا بحد ذاته هدف مركزي – وبقيت كثير من مخلفات ورواسب الشكل القديم أو ما بات يطلق عليه البعض “الدولة العميقة” دون مساس، أو اكتفت بتغيير القائمين على مؤسسة الحكم وإحلال آخرين محلهم، وهم في الغالب من أركان الأنظمة القديمة، بديمقراطية شكلية أكثر منها حقيقية، بوصفها واحدة من الشعارات (المثالية) المعلنة قبل الثورة وفي سياقها قبل أن يجري الالتفاف عليها، كما هو الحاصل في بقية دول الربيع العربي الذي استحال خريفاً؟!