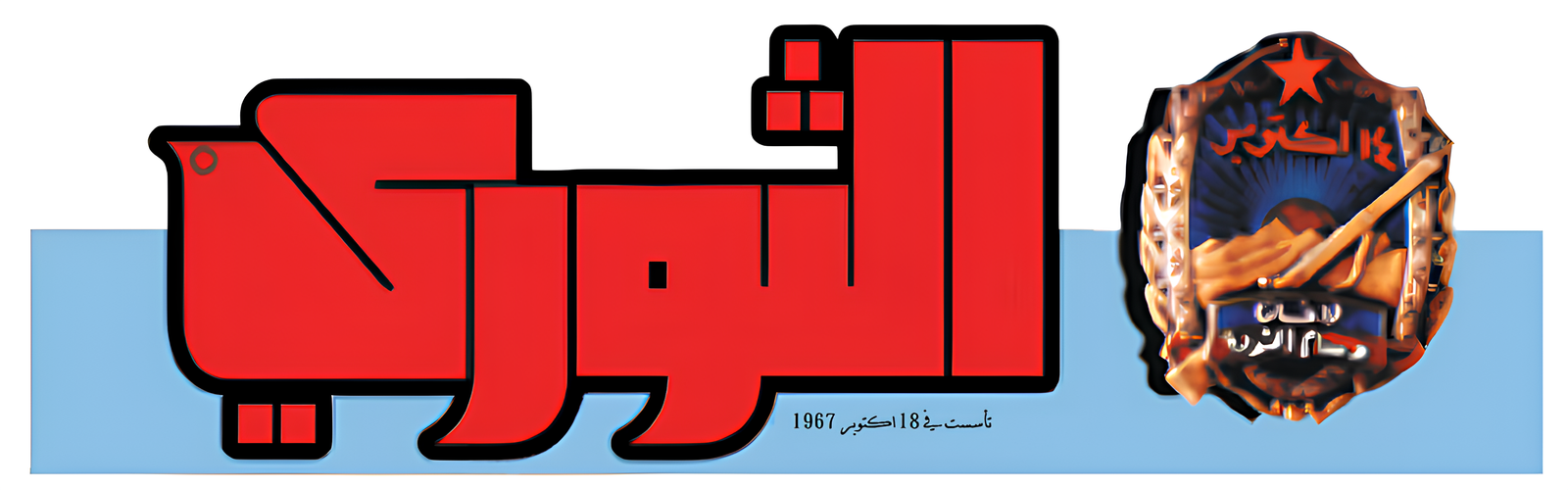“صحيفة الثوري”- ثقافة وفكر:
ريان الشيباني

تعوّدت في السنوات الأخيرة على مشاركة أغلفة كتب مستعملة، في حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي. هذه الكتب أقتنيها من البسطات في أرصفة العاصمة صنعاء. وفي نهاية صيف العام 2023 وصلتني، على إثر ذلك، رسالة من صديق نازح، هل تريد كتبًا؟ لديّ مكتبة فيها كثير من الكتب التي ستعجبك. ولأن مضمون الرسالة لايبتعد عمّا أنا فيه من الشغف، طلبت منه عنوانًا لأصل إلى هذه الهدية الثمينة.
مرّ يومان، فأصابني التردد من الذهاب لأخذ الكتب. كان الظرف المحيط بي مُحبِطًا للغاية، فوضعي المهني غير مستقر، ومشوب بحالة من عدم اليقين، تلا ذلك بأيام قليلة تفجُّر مشكلة كبيرة بيني وبين مديري في العمل، حتّمت عليّ وضع غلالة من التشاؤم على كل خطوة أخطوها باتجاه امتلاك أي شيء.
هذا؛ مضافًا إليه وضعًا عامًا قهريًا، ومعرفة شبه يقينية بالظرف الذي حدا بصديقنا المتبرع التخلي عن مكتبته هذه، وتخزينها لدى أحد معارفه، عوضًا عن هامش من المجازفة قد أقع فيه، فيما إذا كانت الكتب التي سأذهب إليها خارج اهتماماتي الثقافية. لكن ما كان بالنسبة لي ترددًا انقلب إلى شكل من أشكال التطيُّر، حتى خشيت أن يكون خوفي من الكتب في هذه المرحلة، هو نذير شؤوم بتدهور وضعي العام، ليبدو حيازتها- رغمًا عن كل ذلك- تحديًا لكل حالات التداعي المتربصة بي.
كانت ظهيرة معتدلة، استغليت معها الانسحاب من بيئة العمل المتوترة، لكي أذهب إلى هديتي. لم أعد أتذكر هل هي أربعة أم خمسة صناديق/ كراتين من الكتب المتنوعة، ثلثها في التسويق والإدارة المالية، وبقيتها في الفكر والثقافة، إلى جانب بعض الدوريات التي لا تخلو منها مكتبة شخصية عربية كمجلة العربي ونزوى وما شاكل. نثرت كل ذلك في الصالة، في المدخل، بجانب الباب الرئيس للشقة التي أسكُنها، ثم- كعادتي- تكاسلت عن تنظيمها، وظلت مكومةً هناك لما يقارب من خمسة أيام، ثم هجمت على جسدي نوبة موسمية من الكورونا.
عانيت لما يقارب الأسبوع من أعراضٍ متوسطة من الحمى أحالت كل ممارساتي إلى شكل من الهذيان. ووسط حالة الشعور بالهزال التقطت من أعلى كومة الكتب الجديدة مجلدًا بنيًا، بدا لي أنيقًا من حيث التصميم والقطع، ويحمل عنوانًا غريبًا ومقتضبًا على نحوٍ مخل: السِّر. بدأت بقراءته، من باب تزجية الوقت الذي تطيله الحمى، وخاصة ليلًا. من الصفحة الأولى أطلّ عليّ مزاج التفاؤل الشاعري لكتب التنمية البشرية الرائجة في عصرنا بكثرة، لكن متطلبات التغيير- هنا- لا تستند على الحركة أو العلاقات وإنما التوكل والثقة بالأشياء التي لا تحتاج إلا شكل من أشكال المناجاة الداخلية لتأتي إليك.
في أول أسبوع من العودة إلى الدوام، حملت الكتاب في حقيبة حاسوبي، وعندما رآه زميلي باغتته موجة من الضحك. قال لي إنني قديم على هذه الأمور. فالكتاب كان قد وجد طريقه في الرواج منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة على ما يبدو، وأنه مثّل دستورًا للجماعات الإسلامية المعتدلة، التي رأت فيه محاكاة لأفكارها، من حيث كونه يعتمد بعدًا ما ورائيًا في جلب السعادة وربما الثراء إلى العالم، إلى درجة حدت بهذه الجماعات لتحوير سردية التطوير هذه لتتسق مع الموجّهات الإسلامية المتعلقة بالمناجاة والتوكل.
***
كثيرًا ما أقدم نفسي مناهضًا لأدبيات التطوير الذاتي الغربية، التي تقدم نفسها- هي الأخرى- الأكثر مبيعًا في أسواق كبريات الدوريات والصحف العالمية. يتأتّى هذا الاستهجان من قراءاتي لبعض المفكرين الماركسيين، الذين دائمًا ما يعطون لمسألة التفاوت الطبقي بعدًا اقتصاديًا متعلقًا بالتوزيع غير العادل للموارد، ويُرجعون الأزمة إلى خلل في التنظيم، وليس في الفردية، لكن لم أنجو من الوقوع في فخ العناوين البرّاقة، ما مكّنني في سنوات الأزمة الأخيرة من قراءة كم لا بأس به من هذه الأدبيات.
قادتني هذه القراءات للعثور على معضلات جديدة، متعلقة بالتطوير الذاتي في مرحلة الأزمة غير تلك التي تبدو دوافعها أيديولوجية، ومن ذلك خلط هذه الكتب بين الفلسفة والتنمية البشرية وعلم النفس، أو ربما في كثير من الأحيان، افتقارها لهذا الخلط. ففي مجتمعات الاحتراب ومن ثم الندرة، تتفاقم الأوضاع النفسية للناس إلى مستويات قياسية تتجاوز أحلام نيرفانا التطوير الذاتي إلى شكل عميق من التروما.
مطلع العام 2019، أخبرني صديق عامل في المجال الإنساني أنه وقع في فخ البحث عن مأزقه النفسي في كتب (دار جرير). قال لي إن وضعه كان في حالة من التداعي، بينما كان يحاول التعافي بالوقوف أمام المرآة كل يوم، ومخاطبة وجهه بجملة من تأكيدات التنمية البشرية على أنه شخص قوي وواثق بنفسه، وربما غاية في الجمال!
تطوّر وضع هذا الصديق إلى درجة لم يعد يعرف معها ما الذي يجري، هل مرضه عضوي أم نفسي؟ وذات صباح زار طبيبًا عضويًا بعد إصابته بشرخ في أعلى الذراع وهو يحاول فتح أنبوبة غاز لزوجته. يقول: شرحتُ له بعضًا من أعراض ما أنا فيه. نظر الطبيب إليه شزرًا ونبّهه: انتبه، يبدو أنك تعاني من اكتئاب حاد. عليك مراجعة طبيب نفسي متخصص فورًا. الآن، يقترب الصديق من سنته الخامسة مع العقاقير.
***
أكملت هذا الأسبوع قراءة كتاب (في السعادة) لفريدريك لونوار، وهو رحلة فلسفية تطْرُق نشدان السعادة من خلال مراجعة المدارس القديمة وأخرى حديثة. يبدو هذا الكتاب أكثر عمقًا، وقد استهجن مؤلفه في المقدمة ما اسماها الوصفات الجاهزة للسعادة، محاولًا التنقل بين التأملات البوذية والطاوية وربطها بجذور الفلسفات الأوربية من أبيقور حتى نتشه، ومن مونتين حتى سبينوزا.
لم يذهب المؤلف بعيدًا في التأكيد الرأسمالي على الموقف الداخلي للفرد لتحقيق سعادته، لكن بين الفصول المتنوعة للكتاب، بدا لي الفصل الـ17 والمعنون بـ”هل يمكن أن يجعلنا البحث عن السعادة تُعساء؟” لافتًا للنظر، ربما لأنه الأكثر مناسبةً لواقع الحال. يُصدّر المؤلف الفصل بمقولة لدنيس ديدرو، يفضح كيف تقوم فلسفات السعادة المعاصرة على اعتساف الموقف النفسي للفرد وجعله إلزاميًا: “ليس هناك سوى واجب واحد: أن نجعل أنفسنا سعداء”.
وكان الروائي الفرنسي المعاصر باسكال بروكنر، والذي يقع على النقيض من ديدرو، قد حاول فضح (إلزامية السعادة) في ضغطها على مجتمعاتنا الحالية، ففي بعض من مؤلفاته الفكرية أظهر كيف تحوّل البحث عن السعادة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية- بشكل مُطّرد- إلى ما يسمى بمسألة (إلزام السعادة). يقول باسكال: “من المحتمل أننا نشكل المجتمعات الأولى في التاريخ التي تجعل الناس أشقياء لأنهم ليسوا سعداء. فالتهويل المسيحيّ حول خلاص النفس وهلاكها، تحوّل إلى تهويل علماني حول النجاح والإخفاق”.
وبالعودة إلى لونوار، فإن تحوّل وسواس السعادة إلى عقبة أمام الإنسان الحديث، هو لارتباطها بالمجتمع التجاري، وجعلنا ننساق وراء العديد من الوعود المزيّفة وقد ارتبطت (أي السعادة) باستهلاك الأشياء، وبالمعايير الرأسمالية للنجاح الاجتماعي وللجمال الإنساني. لذا فإن سيامية هذه السعادة بالمذهب المعاصر للمتعة ثمنها مكلفًا إلى حد الحرمان، على عكس مفهوم السعادة قديمًا والذي كان يعني فيما يعنيه: النجاة.
تشير دراسات أمريكية إلى أن التعاسة تنتج غالبًا من تحديدنا لغايات بعيدة المنال ومن المستحيل بلوغها. تؤكّد هذه الدراسات أعمال الباحث الفرنسيّ آلان أيرنبيرغ حول «التعب من تحمُّل الإنسان لوجوده». بمقاطعته بين الطب النفسيّ وعلم اجتماع أنماط الحياة، يظهر أيرنبيرغ أن مرض الكآبة المتعدِّدة التي تصيب اليوم الإنسان الغربيّ (تعب مُزمن، قلة نوم، اضطراب، قلق، تردّد…) تُبيّن الثمن الذي يجب دفعه للإلزام المزدوج أي: الاستقلال الذاتيّ وتحقيق الذات. بوصفها فعليًا «مرض المسؤولية»، فإن الكآبة هي عَرَضٌ يُصيب الفرد المُتحرّر من الوصاية الدينية والاجتماعية التي تسعى، على أي حال، كي تحقِّق الإلزام الحديث الذي يقضي بتحقيق الفرد لنفسه بنفسه.
المصدر: نشرة رفّ الخميس التي يعدها الكاتب، رابط المقالة هنا